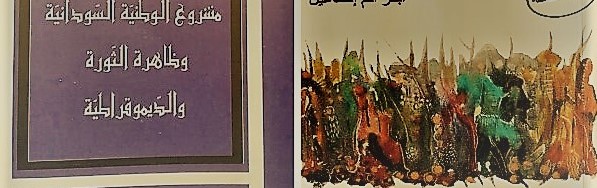(مشاركة موجزة، ضمن نقاش جرى على صفحات فيسبوك، في منتصف 2018)
الدراسات والخلاصات الفكرية حول فهم العنصرية، في عصرنا الحديث، صارت عموما متوافقة على قضايا عامة، يمكن تلخيصها في الآتي:
أولا: العنصرية مطية سلطوية، أي أنها تعبّر عن نفسها بالأصالة عن طريق السلطة ومؤسسات السلطة، وأحيانا بالحوالة فقط عن طريق العلاقات الاجتماعية القحة. بطبيعة الحال هنالك حالات من تنافر بعض الفئات وفق خلفياتهم الإثنية، أو الزعل التاريخي، لكن هذه لا ترقى لمرحلة العنصرية إلا حين تكون هنالك ممارسة واضحة للتسلط والقهر من فئات على فئات أخرى. في الواقع الاجتماعي ليست هنالك عنصرية “ساي كده” بدون محتوى ومقاصد (إنما قد تكون هنالك كراهية أحيانا)، فالعنصرية نعرفها بأغراضها في الواقع الاجتماعي وأغراضها الاستئثار بمزايا تكديس السلطة والثروة عن طريق استبعاد فئات أخرى من المجتمع منها. لذلك فإن العبارات من شاكلة “عنصرية من الطرفين” أو “عنصرية مضادة” عبارات غير علمية، وعادة تُستّخدم لذر الرماد في العيون، فحين يصرح ضحايا العنصرية في غضب يقال لهم انتو كده برضكم عنصريين. الخلاصة في هذا الأمر هي أن من لا يملك سلطة على الآخرين لا يملك أن يكون عنصريا، والبقية تفاصيل.
ثانيا: العرق مفهوم غير علمي، أي لا وجود مثبت له في تصانيف البيولوجيا. البشر ليست بينهم “أعراق” مثلما عند الحيوانات الثدية الأخرى القريبة لهم، بل البشر كلهم نوع واحد وعرق واحد وفصيلة واحدة، في التصنيف البيولوجي، وما نراه من الاختلافات المظهرية بينهم لا ترقى للتمايز العرقي بالمعنى العلمي كما أنها ليست ثابتة في توارثها الجيني. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هنالك ما يسمى “العرقنة” (racialization) وهو صناعة الأعراق، وهذه ظاهرة اجتماعية وليست بيولوجية، وهي حقيقية لأن نتائجها في واقع الناس حقيقي، فضحايا الاضطهاد العرقي حقيقيون على الرغم من أن مفهوم العرق نفسه غير حقيقي. وعموما فإن التمايزات الحقيقية، الأنثروبولوجية بين البشر اليوم، تتمثل في “الإثنيات” وهي ليست أعراق، إنما تركيب من الثقافة واللسان وتاريخ السلالة. أي أن الدالة الموضوعية في تمايز مجموعات البشر هي الدالة الثقافية والدالة اللسانية، وهذا مما يعمل به علم الأنثروبولوجيا الحديث. لذلك يمكن أن نقول إن هنالك إثنيات معيّنة تتعرض لـ”عرقنة” اجتماعية، ويمارس الاضطهاد عليها وفق ذلك. وهذه ظاهرة عالمية تتجلى بصور مختلفة بين بلد وبلد آخر.
ثالثا: القوى العنصرية دوما تصنع لنفسها أيدولوجيا، تميّز بها نفسها وتعيد بها إنتاج نفسها. هذه الأيدولوجيا تستلف مظهرها من عناصر ثقافية وتاريخية موجودة مسبقا في النسيج الاجتماعي، وتلك العناصر في ذاتها بريئة من العنصرية، لكن القوى العنصرية تتخذها مركبا لأيدولوجيتها. مثلا، العنصرية البيضاء (القوقازية الأوروبية) تجاه بقية الشعوب التي استعمرتها واستعبدتها في العصر الحديث، اتخذت لنفسها أيدولوجيا تقوم على امتياز الهوية الإثنية الأوروبية وامتياز الدين المسيحي. الاستعمار والاستعباد كله قام تبريره على هذه الأيدولوجيا “المسيحو-أوروبية” (والتي سمّيت بالحضارة الغربية)، وعلى أساس هذه الهوية المصنوعة تم تمييز الناس، وترتيبهم هرميا في حصص الامتيازات وحصص الظلم والقهر والاستعلاء، وفق قربهم أو بعدهم من “نقاء” أو مركز تلك الهوية المصنوعة “المسيحو-أوروبية”. هذا مع أن المسيحية ذات نفسها بريئة من قهر الناس واستعمارهم (وهي أصلا حين ظهرت كانت ديانة قوم مقهورين ومهمّشين) وكذلك فالإثنية الأوروبية ذات نفسها ليست عنصرية أو استعلائية، بل هي مكوّن من مكوّنات التراث البشري، ومثل عموم تلك المكوّنات نجد في منجزاتها الجوانب الإيجابية كما الجوانب السلبية، وهي عموما ظاهرة ديناميكية، مؤثرة ومتأثرة بما حولها، كما كل الهويات الإثنية.
رابعا: حين يقول المناهضون للعنصرية اليوم إنهم يقفون ضد أيدولوجيا “الحضارة الغربية” العنصرية، القاهرة لمجموعات أخرى كثيرة من البشر، وحين يتناولون بعض تفاصيل المسيحية والإثنية الأوروبية من أجل نقد تلك الأيدولوجيا، فذلك بطبيعة الحال موقف مفهوم، ولا يعني بأي حال من الأحوال أن المناهضين للعنصرية هؤلاء يقفون ضد المسيحية وضد الثقافة الأوروبية في ذاتهما، بل كثير من هؤلاء المناهضين إما مسيحيين، أو أوروبيين، أو مسيحيين وأوروبيين معا، لكنهم ضد الأيدولوجيا “المسيحو-أوروبية”/”الحضارة الغربية” التي قامت القوى العنصرية بصناعتها من أجل مصلحة تمييز نفسها وإعادة إنتاج نفسها. والمؤكد كذلك أن هنالك عملاء لهذه الأيدولوجيا، ليسوا بمسيحيين حقا ولا حتى أوروبيين حقا، لكنهم وفق خدمتهم لتلك القوى، وتماهيهم مع مقاصدها السلطوية، يحوزون على رضا تلك القوى وبالتالي يُمنَحون شيئا من الامتيازات. القصة إذن كلها قائمة على أسباب الاستئثار بالسلطة والثروة والاستمتاع بامتيازاتهما على حساب الآخرين في المجتمع.
خامسا: الهدف من محاربة العنصرية وممثليها هو طبعا تجاوز العنصرية تماما. الذي يعنيه هذا الأمر أن هنالك مجتمعات وبلدان ستكون فيها أغلبية السلطة في يد أغلبية الشعب (بدون أن يعني ذلك تجريد الأقليات من أي حقوق أو سلطة)، بحكم المنطق. مثلا ستكون أغلبية السلطة في اسكندنافيا بيد الأوروبيين لأنهم أغلبية هناك في موطنهم، لكن ليس من المنطق أن تكون أغلبية السلطة في يد البيض في جنوب افريقيا لانهم ليسوا الأغلبية هنالك. وهذا لا يتناقض مع كفالة حقوق الجميع في الممارسة الديمقراطية والتعبير عن الانتماء، ومنها الانتماء إلى الأقليات الإثنية. إذن هنالك توفيق واضح ومتسق بين ضمان الحقوق الأساسية لجميع الأفراد – ومنها حق الانتماء – مع الإصرار على حقيقة أن تتلوّن المجتمعات بألوان أغلبية أهلها وفق دليل الواقع الاجتماعي ودليل التاريخ. هذا التصور العام يصبو لأن ينتج عالما فيه تنوّع ووحدة معا؛ ليس فيه استبعاد (تهميش) لأي مجموعة ولكن فيه تعابير واقعية تظهر فيها مسحة الأغلبية في كل منطقة من مناطق الأرض.
الخلاصات أعلاه تبلورت عن طريق مساهمات كثيرة، فكرية وحركية، جاءت من جهات كثيرة حول العالم، وتمثلت في مدارس ما بعد الاستعمار، وحركات الحقوق المدنية وحركات تصفية الاستعمار، وأطر مناهضة كافة أشكال التمييز. هذه المساهمات تقاربت رويدا رويدا حتى وصلت لخلاصات متشابهة نبعت من تجارب وفهوم متعددة.
طيب… في السودان، ومنذ نهايات الثمانينات وبدايات التسعينات من القرن العشرين، ظهرت أطروحة “جدلية الهامش والمركز” (أو صراع الهامش والمركز)، ومعها كذلك منهج التحليل الثقافي. هذه الأطروحة النظرية، وهذا المنهج، شكلوا تيارا، اجتهد في تبيان نفسه للشعب السوداني بالطريقة الحضارية الصحيحة، وهي الكتابة والخطابة والدفع بالحجة الموثقة. خلاصات هذا التيار عموما قريبة من الخلاصات المذكورة أعلاه، وبسبب وضع السودان وتاريخه تم استبدال وصف “الأيدولوجيا المسيحو-أوروبية” مثلا بوصف “الأيدولوجيا الإسلاموعروبية”، وهو استبدال منطقي ومفهوم وفق الخلاصات التي ذكرناها عاليه (وبالتالي من الواضح أن الإسلام في ذات نفسه، والإثنية العربية في ذات نفسها، ليسا مرجعية تلك الأيدولوجيا تحديدا، كما يوضّح ذلك التيار، لكنهما يجب تناولهما في إطار نقد تلك الأيدولوجيا الإسلاموعروبية). فما الذي جرى؟ بعض الناس الذين ينصتون لأصحاب الرأي ثم يقيّمونه فعلوا كذلك، فاتفقوا مع هذا التيار أو اختلفوا معه، لكن بفهم، والبعض الآخر استبدل القراءة المنصفة بخيالات لا مكان لها، بل قام بنسج ادعاءات كاملة لا علاقة لها بهذا التيار وألزقها به، ثم ظهرت التهم المجانية من شاكلة “هؤلاء عنصريون أيضا” و”هذه نازية جديدة” وما إلى ذلك من القول العالي الشحنة فارغ المحتوى.
وهذه الجموع المناوئة لأطروحة الهامش والمركز، ومنهج التحليل الثقافي، تنقسم لقسمين، القسم الأول رصيد معروف للأوضاع القائمة في السودان عموما، أي أنهم ذوو مصلحة في استمرار الأوضاع القائمة، وبالتالي فمهاجمتهم الإعلامية والتضليلية للتيار الجديد مفهومة. أما القسم الثاني فأمره عجيب، فهذا يشغله تقدّميون، يساريون وليبراليون، يحتفون بالكتابات المناهضة للعنصرية وتحليلها المادي الموضوعي حين تأتي من خارج السودان وحين لا تتعلق بالأوضاع المزرية والعنصرية الواضحة في السودان، ولكن لا يريدون أن يقرأوا، قراءة معقولة ومنصفة، لكتابات مماثلة حين تأتي من سودانيين عن السودان، ويملأون فراغ جهلهم بها بالسخط والاتهامات الجزافية، مثل اتهامات العنصرية والتسفيه من مساهمات أصحاب هذا التيّار ونعتهم بصفات الضعف الفكري والأخلاقي–كل ذلك مع رفض إنصاف أهل ذلك التيار على الأقل بأن يقرأوا لهم قراءة منصفة ويخرجوا منها بنقد يعتمد على تلك القراءة، لا مجرد تناقل الموجزات المشوّهة وكأنها معرفة كافية.
والحديث ذو شجون
(الصورة المصاحبة للمقال مأخوذة من كتابين: “جدلية المركز والهامش: قراءة جديدة في دفاتر الصراع في السودان” لأبّكر آدم اسماعيل، و”منهج التحليل الثقافي: مشروع الوطنية السودانية وظاهرة الثورة والديمقراطية” لمحمد جلال هاشم. الصورة فقط مزج ارتجالي لمقطعين من غلافي الكتابين، قام به كاتب المقال، لا أكثر.)