الدولة والسياسة ليستا نفس الشيء.
ولذلك فعبارة “فصل الدين عن الدولة” ليست هي نفسها “فصل الدين عن السياسة”.
الدولة هيكل ومؤسسات؛ اقصد الدولة العصرية. أما الأديان، باعتبارها نُظما إيمانية بمرجعيات غيبية وسلوكيات طوعية (وهذا تعريف ناقص) فليست نماذج دولة عصرية، بطبيعة الحال، لكن بطبيعة الحال أيضا هنالك تداخلات في المجالات بينهما ويعزى ذلك عموما لاشتراكهما في دائرة أخرى مهمة جدا وواسعة جدا: المجتمع. لكن لاختلاف الطبيعة ودائرة الفعل – رغم التداخلات – فعمليا يمكن فصل الأديان من هيكل الدولة ومؤسساتها، أي التمييز بينهما بحيث تعمل الدولة وفق ضوابط وسياسات وإجراءات ومهام وتشاريع ذات طبيعة تختلف عن الضوابط والسياسات والإجراءات والمهام والتشاريع التي تصدر عن سلطات دينية أو عن مراجع دينية معيّنة.
والدولة العصرية كائن جديد على السيرورة التاريخية في الكوكب، لكنه كبير الأثر ومتمدد في الكوكب كله بصورة غير مسبوقة (وذلك يعود لملابسات تاريخية تحدثنا عنها في كتابات سابقة، في المراجع أدناه)؛ فهو مختلف هيكليا وإداريا، وتكنولوجيا وعسكريا، وجغرافيا ودبلوماسيا، عن أشكال الممالك والمشيخات والامبراطوريات والخلافات في السابق (ليست ذات المرجعية الدينية فحسب وإنما جميعها). لذلك فإن أي نظم إدارة وحوكمة، وترتيبات سلطة، كانت مجرّبة وواردة في تلك الأشكال السابقة لا يمكن سحبها على حاضر الدولة العصرية. كما قلنا في مقال سابق فالأمر سيكون أشبه بتركيب محرك بخاري من القرن الماضي في طائرة حديثة بدل المحرك التوربيني الحديث، وتوقّع أن تشتغل الطائرة على أي حال.
من الناحية الدينية، وإذا نظرنا لديننا الإسلامي مثلا، فإن مجمل التشريع الإسلامي المدوّن لدينا، والمتراكم من التراث العريض، كان مستوفيا لمناحي الحياة المتنوعة في الماضي لكنه لا يغطي حتى أقل تفاصيل تعقيدات الحياة في الدولة العصرية – الهيكل والمؤسسات – بله أن يصير هو المرجعية الكبرى. لذلك فإن معظم من يتحدثون عن “دولة دينية” في هذا العصر إنما يقصدون استلاف تشاريع دينية (من المذهب أو المذاهب المختارة عندهم) ليغطوا بها جزءا بسيطا جدا من كامل البناء التشريعي والإجرائي للدولة العصرية، لأن ذلك قصارى ما يمكن فعله. وحاليا يمكن النظر حولنا لنجد أن أي دولة تزعم الحكم بمرجعية دينية معيّنة إنما تقصد فقط التركيز على التأثير على مجالات تشريعية محدودة – مثل بعض الاستعارات في الأحوال الشخصية والميراث وبعض القضايا الجنائية وبعض المعاملات – من كامل البناء التشريعي للدولة العصرية التي يسودونها؛ فليست هنالك مثلا تشاريع إسلامية أو مسيحية أو يهودية للطيران المدني، أو الخدمة المدنية والخدمات العامة والأشغال العامة (مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي وبقايا البنية التحتية) أو النظام الصحي أو النقل والمواصلات، أو القطاع الصناعي والزراعي والتعديني، أو تنظيم قضايا العمل والتأهيل الفني والإداري لتسيير كل هذه النظم المتعلقة بالدولة الحديثة، أو التخطيط المدني والريفي، أو الإحصاء والأرصاد ومراقبة جودة السلع (مثل السلع الغذائية والاستهلاكية) أو التجارة الدولية والعلاقات الدولية (أي التي تقتضي التعامل مع بقية العالم بنظمه الحديثة)، أو الإدارة البيئية، أو النظم العسكرية الحديثة (والتي بدونها لن تكون للدولة سلطة تنفيذية)، أو فض النزاعات بين الجماعات المسلحة، أو اتفاقيات مشاركة موارد المياه، والأجواء والمعابر، والاتفاقيات الإقليمية والدولية السياسية، والبروتوكولات الدبلوماسية، أو التبادل المعرفي والبحثي مع بقية الدول من أجل التطور التكنولوجي والاقتصادي المستمر، وقضايا التنقّل الدولي (السفر) والعمل والزيارات، إلخ.
وبما أن الدولة العصرية، في بنيتها، تقوم مرجعيتها على الجغرافيا والمواطنة، فهي لا تستطيع مثلا تغيير بنيتها تلك لتوائم نظم حكم سابقة. (على سبيل المثال، مرجعية الممالك السابقة كانت أحيانا فكرة الحق المقدس في الحكم لفئة معيّنة ثم تتمدد رقعة حكمها حسب ما تبسطه قواتها وحسب تمدد “رعاياها” – لا “مواطنيها” – في البقاع). بما أن الدولة العصرية كذلك، فإن المجموعات التي تتشارك الحق في تلك الرقعة الجغرافية يُفهّم أنهم جميعا مواطنين، وبصفتهم مواطنين فهم جميعا أصحاب حق متساوي في الدولة العصرية. وبما أنهم أصحاب حق متساوي في الدولة فإن منطق العدل يقول إن هيكل الدولة ومؤسساتها (وما يلحق بها من قوانين وإجراءات وسياسات) إما تتعامل معهم بالمساواة وإما لن تكون عادلة؛ خاصة وأن ذلك الهيكل والمؤسسات أيضا ملك لهم جميعا، بحكم مشاركتهم في القُطر. الحق المتساوي في الرقعة الجغرافية يقتضي الحق المتساوي في المعاملة، وبالتالي فإن أي قوانين دينية تتعامل مع “الرعايا” باعتبار التمييز حسب الولاء الديني وحسب القرب أو البعد من شروط السلطة الدينية، لن تكون عادلة في الدولة العصرية لأنها لا تعتمد مرجعية المواطنة والحق في الرقعة الجغرافية (القُطر) وإنما تعتمد مرجعية أخرى تريد تركيبها تركيبا على هيكل ومؤسسات ليست مصممة لها (كما قلنا: محرك بخاري وطائرة حديثة). وكلما كان القطر يشترك فيه مواطنون متعددو الخلفيات الثقافية والدينية واللغوية، إلخ، كلما كان هذا الأمر أكثر وضوحا.
البعض يسمي هذا المبدأ البسيط في إدارة شؤون الدولة العصرية “علمانية الدولة”؛ وفي هذا المقام، لن تهمّنا التسميات. من أراد أن يسمّيها أي شيء آخر فليفعل. على العموم هي دولة “عصرية” ودولة “قُطرية” (territorial)، أي أن هذه هي طبيعتها، وهذه هي صفاتها وخصائصها (التي ذكرناها أعلاه باختصار شديد، وسنورد مراجع أدناه تتحدث عنها بإسهاب أكثر). فقط ما نريد التركيز عليه الآن هو هذه الظروف والشروط التاريخية الواضحة، والتي لا تتباين مجمل دول العالم اليوم فيها وإنما تتباين في تفاصيلها الداخلية فحسب. والدول التي تحاول سلطاتها الالتفاف على هذا المبدأ البسيط تدخل نفسها في تعقيدات أكبر بكثير من تحقيق نصيب مما تزعم أنها تهدف له، سواء كان الهدف دينيا أم ثقافيا أم لغويّا، أو غير ذلك أو كل ذلك. على سبيل المثال، كثيرا ما نجد أن زعم “الدولة الدينية” في سياق الدولة العصرية يضفي قداسة على نظام الحكم وقرارات الفئة الحاكمة بحيث يمنع المواطنين من تطويرها ومساءلة حكامهم ومسئوليهم فيها، وهو زعم يفتح باب الفساد والإفساد في أجهزة الدولة وفي المجتمع.
ثم هنالك السياسة (politics)، وهي كما ذكرنا ليست الدولة (state)، وهذا الأمر البديهي يفوت البعض أحيانا. فالسياسة في هذا العصر هي مجموع الحراك والنشاط العام للمواطنين وفق مصالحهم وتطلعاتهم، وفي ذلك تجدهم يتعاونون أحيانا ويتنافسون أحيانا، وتتباين أجندتهم وموجّهاتهم أحيانا، وتتنوّع خلفياتهم الثقافية والتاريخية والإثنية واللسانية ضمن نفس القُطر. السياسة إذن، في أي دولة وفي أي مجتمع معاصر، هي مجال تعاضد وتنازع، شد وجذب، أخذ ورد، أي مجال مفاوضة.. وتخرج عنها صيغ ومسارات متنوعة بتنوع الفئات النشطة فيها وموازنات القوى فيها. لذلك فالمناخ السياسي في أي دولة عصرية، أو إقليم معاصر، يختلف عن المناخ السياسي في أي دولة أخرى. المناخ السياسي المحلي تصنعه القوى المحلية (في الغالب)، ومن ثم تتأثر به الكثير من السياسات (policies) والتشاريع والإجراءات التي تنطبع بطابع أهل تلك الدولة.
وفي السياسة، لا يمكن القول بفصل الدين عن السياسة إلا نظريا ربما، أما من الناحية العملية فليست هنالك أي دولة في الحاضر تم فصل الدين فيها عن السياسة بنجاح–حتى الدول الإلحادية الصارمة تجاه الدين، مثل الصين أو الاتحاد السوفيتي سابقا، إنما تتبنى موقفا دينيا-سياسيا بهذا المعنى، أي أنها تشتغل بصورة نشطة لتضمن فصلا جراحيا غير مستدام بين الدين والسياسة، وهي رغم ذلك تفشل منطقيا في ذلك الفصل لأنها فعليا تقوم بفرض موقف ديني-سياسي على حياة المواطنين كافة (والإلحاد موقف ديني، أي موقف يخص الدين). وحاليا، في معظم الدول العصرية، إذا كانت تتبنى نظما ديمقراطية فليست هنالك مقدرة لديها لكي تتحكم في الأسباب التي تجعل الناخبين ينتخبون هذا الحزب أو ذلك، أو ذلك الشخص أو ذاك، أو يؤيدوا أو يعارضوا ذلك البرنامج السياسي أو الاقتراح التشريعي–أي أن نظام الدولة كلما كان ديمقراطيا كلما كان غير قادر عمليا على أن يلغي تأثير الموجّهات الدينية على الخيارات السياسية للمواطنين والجماعات.
لكن، في نفس الوقت، إذا قلنا إن تأثير الدين على السياسة لا ينبغي أن يحدّه حد فإننا سنقع لا محالة في تناقض واصطدامات مع المبدأ البسيط الذي ذكرناه آنفا، وهو مرجعية المواطنة القُطرية في الدولة العصرية؛ وتلك الاصطدامات كفيلة بأن تحدث انفجارات مكلّفة جدا، قصيرة وطويلة الأمد.
لذلك يقول بعض خبراء القانون والحكم الدستوري، في الدولة العصرية، إنه بينما من الممكن عمليا فصل الدين/الأديان عن هيكل الدولة ومؤسساتها، من الممكن فقط مفاوضة علاقة الدين بالسياسة، وهي مفاوضة لا تأخذ صيغة واحدة في جميع البلدان، بل تتنوّع صيغتها بتنوّع البلدان ومواطنيها. الفصل الأول (بين الأديان وهيكل الدولة) ممكن عمليا وأضمن للاستدامة، والوصل الثاني (أي المفاوضة بين الأديان والسياسة) ممكن وفق شروط عامة تضمن عدم اكتساح الدين للسياسة لدرجة تقويض أسس الدولة العصرية/القطرية. هذه “الوزنة” المهمة في مجتمعاتنا المعاصرة يسميها عبدالله النعيم، الأستاذ والباحث القانوني، “جدلية الفصل والوصل”.
وتلك المفاوضة، بين السياسة وأديان المواطنين، يمكن ترتيبها عبر وسائل ومحرّكات تسمح لها بالاستدامة السلمية. إحدى تلك الوسائل ما يسمى بالمنطق المدني، والذي طوّره عبدالله النعيم عن “المنطق العام” الذي ابتدره جون راولز، أحد الفلاسفة والمفكرين القانونيين المهمين في حقبة الدولة العصرية. يعني المنطق المدني، اختصارا، أن الطروحات المستندة على أهداف دينية لا تُقَدّم للرأي العام أو كمقترحات سياسات وتشاريع على أساس ديني، وإنما على أساس “منطق مدني” يملك جميع المواطنين أن ينظروا فيه وفي وجاهة طرحه بغض النظر عن مشاربهم الدينية. وتوضيح ذلك أنه من المعروف أن المجتمعات الحديثة عموما كثيرا ما تستند على قوانين وتشاريع قديمة في تاريخها، وتطوّرها، وتوائمها أحيانا، إذا كانت ما زالت قابلة للتواؤم مع الشروط المعاصرة. أي أن التراكم التشريعي من الماضي ممكن، في بعض المسائل غير المستحدثة، لكن بما يستوفي شروط المرحلة الجديدة. على سبيل المثال، إذا رأت مجموعة من الناس – منظمة سياسيا أو في المجتمع المدني – أن النظام البنكي للدولة ينبغي أن يبتعد عن نظم الفائدة ما أمكن، فليست هنالك سلطة ينبغي لها أن تمحّص ما إذا كان ذلك الموقف مبني على تشاريع دينية أو على أفكار اقتصادية حديثة (أو على مزيج بينهما)، إنما ما ينبغي ضمانه هو “المنطق المدني” في الدفع بهذه الأطروحة للرأي العام وللسلطات التشريعية: أي أن تقوم تلك المجموعة بالمرافعة عن موقفها ذلك بصورة يمكن لكل المواطنين، مهما كانت خلفياتهم الدينية، أن يناقشوها (تأييدا او تفنيدا) بدون استدعاء مساءلات عقيدية أو غير عقيدية؛ أي مثلا، هنالك فرق بين أن تكون مرافعتهم المعلنة هي أن “نظم الفائدة نظم ربوية ينهى عنها ديننا ومن لا يوافق عليها فهو متهم في دينه ويصادم عقيدتنا”، وبين أن تكون مرافعتهم هي أن “هنالك أسباب وجيهة، لمصلحة المجتمع والأفراد واقتصاد الدولة، نعرضها ونؤكد عليها”، ثم يشرحوا تلك الأسباب ويروّجوا لموقفهم من خلال ذلك الخطاب. المرافعة الأولى عقائدية تصنع استقطابات بين المواطنين وفق معسكرات عقيدية غير مستعدة للنقاش، أما المرافعة الثانية فتعتمد المنطق المدني. وتتمدد الأمثلة للمنطق المدني لتشمل قضايا متعددة، مثل بعض مسائل الأحوال الشخصية، وبعض المواد الجنائية، وبعض قواعد السلوك العام، إلخ. وكل ذلك يتم في مناخ “تفاوضي”، أي مستمر الشد والجذب، أي ربما تتحقق فيه انتصارات أو هزائم ولكن ذلك لا يعني أن الجهة المنتصرة أو المهزومة قد انتصرت للأبد أو هُزِمت للأبد.
يضاف لذلك فهنالك ممارسات وشعائر عامة وخاصة – أي في الحياة العامة وفي الحيوات الخاصة – لا تحتاج لفرض سياسات دولة معيّنة كيما يتمكن مجتمع مؤمن أن يمارسها وفق تعاليمه الدينية، ومثل هذه الممارسات على الدولة أن تكفل حق ممارستها للجماعات المؤمنة المتنوّعة، ما دامت لا تتعارض مع حقوق ومكتسبات جماعات أخرى في الدولة ولا تتصادم مع واجبات المواطنين تجاه القانون والدولة.
في هذه المقالة حاولنا بذل مفاهيم معيّنة – الدولة، والسياسة، وجدلية الفصل والوصل، والمنطق المدني – نرى أنها مهمة جدا في نقاش القضايا المعنية بالعلاقة الثلاثية بين الدين والدولة والسياسة. وهذه المقالة تُقرأ ضمن مجموعة من المقالات الأخرى، التي نشرت سابقا (مثل “الحوكمة وصنع السياسات“، و”حول العلاقة الثلاثية“، و”مشكلة الأغلبية في الديمقراطية“، وغيرها)، بالإضافة للمراجع المذكورة في آخر المقالة. والهدف من كل هؤلاء هو جعل النقاش حول هذه المسائل نقاشا مُخبَرا (informed discussion) يمكن التداول فيه وفق معلومات ووفق مستوى معقول من فهم المفاهيم المرتبطة بالمسألة والتاريخ والواقع.
مراجع:
عبدالله النعيم، 2010، الإسلام وعلمانية الدولة. القاهرة: دار ميريت.
قصي همرور. 2016. “هل كان الاستعمار سيئا حقا؟”. مجلة الحداثة السودانية، العدد الثالث (ديسمبر)، الصفحات 6-8
Graeme Gill. 2003. The Nature and Development of the Modern State.New York: Palgrave Macmillan.
Jonathan Quong, “Public Reason”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.).

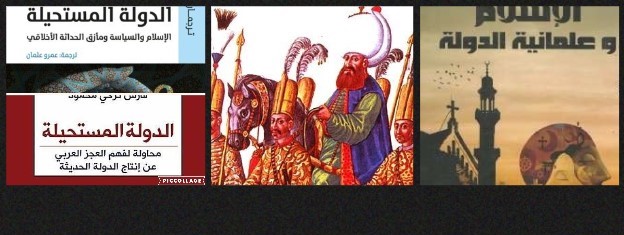
من الواضح اننا أمام أزمة إدراك للحدود المفاهيم
وهو سبب الارباك والفراغ المعرفى وبل والاستبداد الفكرى.
هذا الخط لتصحيح مساره الوعى والتنوير هو الترياق الان رغم تدهور الأوضاع
كلام جميل ومفهوم من حيث حق جميع السودانين في الوطن لكن تظل هناك تشاريع دينية قد لاتكون مفهومة وفق المنطق المدني ولم يستطع المنطق تفسيرها الى اليوم لكن هي من أصل الدين وعلى كل مسلم يؤمن بالغيب التسليم بها بس مثلا في جانب المؤسسات العدليه والقانونيه في مايتعلق بأحكام الميراث أو حد السرقة أو الزنا المحصن وفق المنطق المدني كلها حاجات نسبية لكن كمسلم مؤمن بالغيب أنا مامخير في القبول أو الرفض طالما النص واضح وصريح .. لكن كلام جميل محتاج مناقشات على هذه الشاكلة قد يقدم حلول العالم أجمع لم يتوصل لها تحياتي