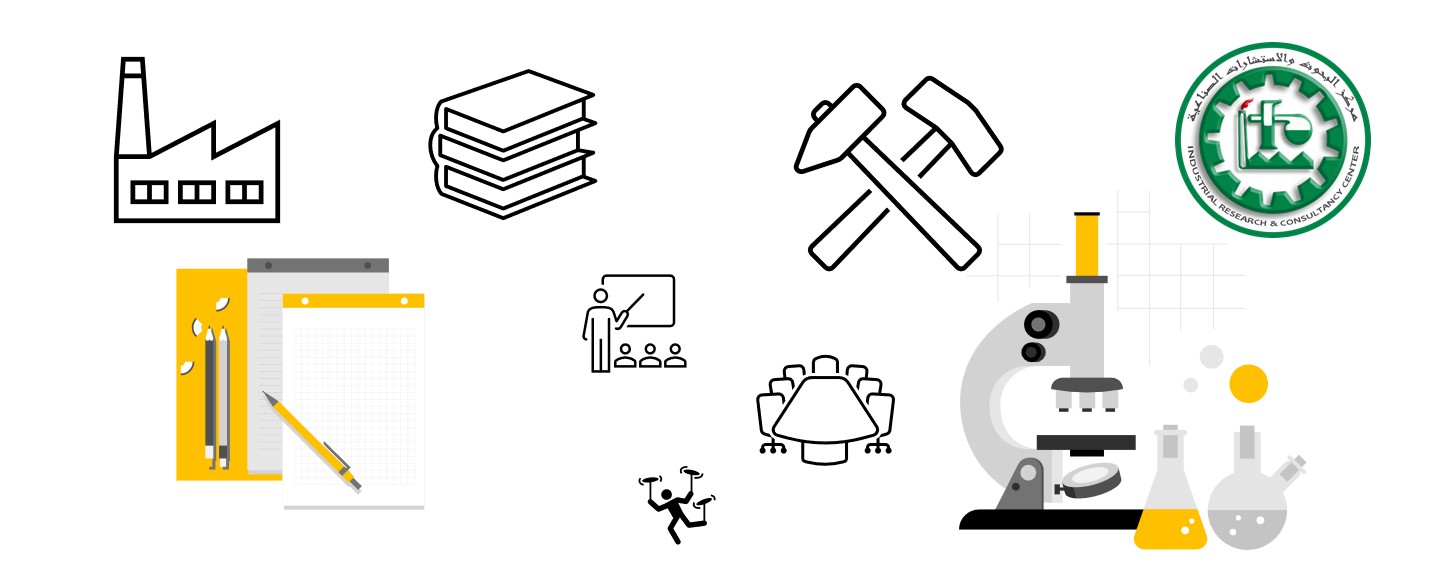[نتعامل مع هذه الصفحة بوصفها صفحة حيّة، أي يجري تحديثها بالمزيد من المعلومات والوثائق بصورة دورية مستقبلا، حسب الحاجة وحسب التفاعل، والغرض منها تمليك معلومات وافية للرأي العام وللتاريخ. كاتب الصفحة مسؤول عن أي تصريح ومعلومة توفّرها هذه الصفحة، وليست لجهة غيره مسؤولية ما لم ترد الإشارة إليها كمصدر للمعلومة بصورة موثقة.]
في 19 نوفمبر 2021، قمتُ بإخطار الزملاء في إدارة مركز البحوث والاستشارات الصناعية (السودان)، ومديري الوحدات، وعبرهم إلى منسوبي المركز كافة، بإنهاء مهامي في المركز (حيث عملت كمدير). الرسالة كانت موجهة داخليا وذلك لبداية الإجراءات الرسمية لإخلاء الوظيفة، حتى لا تتأثر مصالح العاملين بالمركز (والتي تتطلب أحيانا توقيعات وخطابات من الإدارة). بذلك كانت قرابة النهاية لأكثر الفترات كثافة في العمل في حياتي حتى هذا الوقت، في ظروف عجيبة ووفق شروط غير معتادة، لكنها عموما بعثت فيّ طاقة عمل وتعلّم لم أكن أظنها عندي؛ وكذلك تكون بداية مرحلة جديدة من المساهمة في رفد قضايا التنمية والتحرر – في السودان والمنطقة – من مواقع وجبهات أخرى كثيرة.
لم أقدّم استقالتي في نفس التاريخ، لأني قد قدّمتها بصورة رسمية منذ نهايات شهر مايو 2021، وفي خطاب الاستقالة وضّحت المسببات التي جعلتني أتقدم بها رغم تأكيدي أني من الذين “لا تعبنا ولا زهجنا” من العمل في سبيل رفد التنمية الصناعية في السودان. منذ ذلك الوقت قدّمت فترة إخطار لمجلس الوزراء (ولوزير الصناعة) حتى يكون هنالك وقت كاف لإيجاد البديل ولعملية التسليم والتسلم. ومنذ ذلك التاريخ حصلت اجتماعات معهم موضوعها محتوى الخطاب ونقاطه، أسفرت عن تلخيص مطالب وتوصيات، جميعها تتعلق بتحسين أوضاع المركز ومنسوبيه، وتوكيد استقلاليته الهيكلية والمالية عن الحكومة (وليس الدولة)، كما تتعلّق بأهمية مراجعة أوضاع منظومة البحوث والابتكار في السودان إجمالا، وإشراك هيئات البحوث المعنيّة المتنوّعة فيها بصورة قوية. وفق التزامهم بأخذ المطالب بصورة جادة وبدء العمل ناحية استيعابها حصل تمديد في فترة الإخطار بدون سحب الاستقالة (وقد حرصت على التوضيح كتابةً أني لم أسحب استقالتي ولن أسحبها قبل لمس تغييرات معقولة وكافية)، والحق يقال إن مجلس الوزراء، بعد الخطاب والاجتماعات المذكورة آنفا، أتبع التزامه بخطوات عملية كانت لها نتائج ملموسة، وإن وزير الصناعة كذلك لم يتجاهل الموضوع. وعلى العموم فمعظم العبء الثقيل في العمل كان على عاتق المركز ومنسوبيه وإدارته، بينما كانت المطالب والتوصيات المقدّمة تهدف إلى أن لا تكون قوانين ولوائح الدولة وإجراءاتها عقبة أمام تحركات المركز المشروعة وإنما مسهّلة لها (أو على أقل تقدير لا تشكّل عبئا غير مبرر على المركز). في هذا المضمار استندنا بصورة واضحة وموثقة على التجارب والممارسات العالمية (وفي الدول النامية الناجحة صناعيا بالذات) لمنظومات البحوث (العلوم والتكنولوجيا) والابتكار، كما استندنا على إرث الممارسات الجيدة السابقة في تاريخ السودان نفسه.
بعد 25 أكتوبر 2021، حصلت تغييرات كبيرة في هيكل النظام الحاكم للدولة بوضع اليد وفرض السلاح، يعرفها الجميع، وهذه التغييرات لا بد وأن كانت لها انعكاسات على أوضاع المركز، رغم أن المركز ما زال، في نظرنا، مستقلا نسبيا عن هيكل الحكومة، ورغم حرص إدارة المركز طيلة الفترة الماضية على التمييز الصعب بين معايير العمل المهني في القطاع العام وفي ساعات العمل (وفق الموجّهات العامة للتغيير الهيكلي الشامل للفترة الانتقالية التي أتت نتيجة حراك ثوري مستمر) وبين تشابكات العمل السياسي الذي تشوبه الكثير من الممارسات المشوّشة في الواقع السوداني (ووفق ذلك ظللنا نذكّر أن من أجندة التغيير الثوري نفسها استعادة مهنية مؤسسات القطاع العام ومهنية التعامل مع منسوبيها بغض النظر عن الاختلاف السياسي، وأن مواقفنا المتعلقة بالخيارات الصحيحة للتنمية الصناعية هي مواقف مهنية ما دامت مستندة على خبرة موضوعية حتى لو حملت انحيازات سياسية ما، لكننا نحرّك مواقفنا تلك وفق الإجراءات المرتبطة بمهام ودور المؤسسة التي نعمل بها وعبرها؛ وقد أوضحنا ذلك في خطاب الاستقالة). من الانعكاسات المهمة والمباشرة لتلك التغييرات السياسية – ما دامت مستمرة – أن فترة عمل مدير المركز الذي استلم المهام رسميا منذ يوليو 2020 انتهت فعليّا، وبقيت فقط بعض الإجراءات المطلوبة لإخلاء الوظيفة رسميا.
كذلك، ومما يسهّل إجراءات إخلاء الوظيفة خلو المرء من عهدات في حوزته مملوكة للمركز، وأنه لم يستلم أي أجر أو مخصصات مادية أخرى تتبع للوظيفة منذ بداية فترة مهامه وحتى نهايتها (وذلك لملابسات واختيارات معيّنة وغير نادرة في تلك المرحلة التي مرت بها الدولة السودانية).
من الناحية الشخصية، أشكر منسوبي المركز كافة على فترة العمل التي قضيتها معهم وأعتقد أننا خلالها استطعنا تحقيق أعمال مهمة، رغم ما أحاط بنا من القيود والمحدوديات والصعوبات. وأشكر بصورة خاصة زملائي في المركز الذين اشتغلنا معا بصورة مباشرة ومستمرة وبمجهود مقدّر منهم جميعا طيلة تلك الفترة. أشكر أيضا أولئك الذين تقاطعت دروبنا معهم واشتغلنا معا لبعض الوقت في هيئات البحوث الأخرى في السودان والجهات الأخرى ذات العلاقة بالصناعة والتنمية والتعاون. هذا ونرجو لمركز البحوث والاستشارات الصناعية أن يزدهر ويستمر في التطوّر وأن يقوم بدوره المرتقب له في التنمية الصناعية بالسودان. سعيت ما بوسعي لأن تتم الأمور بصورة أفضل وأكمل، وأكثر حفظا لمكانة المركز كمؤسسة صاحبة دور لا يقوم به غيرها، وحالت ظروف أقوى من محاولاتي دون ذلك. ما زلت أنوي الاستمرار في خدمة المركز من أي مكان حالي أو مستقبلي.
حرصت على توثيق التجربة كلها، توثيقا عاما (فنيّا وتاريخيا) وتوثيقا خاصا، وعموم ذلك التوثيق من الواجب تمليكه للذاكرة السودانية العامة، المفتوحة والمتاحة للجميع. بعض ذلك التوثيق متاح للذاكرة العامة فعلا عن طريق الموقع الالكتروني الجديد للمركز، وعن طريق كتابات متعددة منشورة في الفترة الماضية، وبعضها ينبغي ترتيبه وجعله متاحا، وهذه الصفحة محاولة في ذلك. وكما ذكرت من قبل، لا أشك في الحقيقة البسيطة: أن زمن الحرث والزرع يأتي قبل زمن الحصاد؛ فما قمنا به من عمل إيجابي سيأتي يوم حصاد ثمره، وما قمنا به من محاولات فاشلة (غير ساذجة) غذّى خبرتنا وخيالنا ووثّقناه بحيث لا نتورط في تكراره مستقبلا. رغم كل التحديات ومناطق القصور، لم تغب قدرات المركز الكامنة (potentials) من خيالي، وهو ما جعلني في لحظات إنهاء المهام أكاد أنسى كل مشكلة وكل إحباط وانزعاج، وانتظار لا معنى له وجري في الفاضي، وأتذكّر بقوة أوقات العمل المتكاتف والجاد والمثمر، وأوقات ظللنا يذكّر بعضنا بعضا بأننا من ناحيتنا سنفعل كل ما يمكن فعله ووفق ما هو متاح من موارد وزمن حتى لو لم تتوقف المؤثرات الخارجية عن خذلاننا.
أخيرا وليس آخرا: من الجيّد أننا من الذين وطنّوا أنفسهم على أن لا نتوقّع تغييرا إيجابيا كبيرا وسريعا، وعلى أن نتوقّع مراحل صعبة ومتداخلة – وبعضها محبط ومكلّف جدا – قبل أن تبدأ الثمار الطيبة بالظهور. هذا التوطين اعتبره كثيرون تشاؤما منّا لا ينبغي أن يُعدي من حولنا وأن المتفائلين هم أهل الساعة، لكن المتشائمين حقا لا يعملون ولا يجتهدون ولا يستثمرون في المشوار الطويل وعينهم على المحطات الكبرى البعيدة، في المدى، لا المحطات الصغيرة القريبة.
——–
بجانب الاستطرادات أدناه، مرفقة الملفات الآتية (بالضغط عليها) وهي التوثيق الأهم والأشمل للتجربة:
- تصريح عام حول التعيين بمركز البحوث والاستشارات الصناعية (20-23 مارس 2020)
- خطاب الاستقالة (24 مارس 2021)
- خطابات ملحقة بعد خطاب الاستقالة وقبل إنهاء المهام في 19 نوفمبر 2021 (تحديد المطالب لمجلس الوزراء، وتمديد فترة الإخطار بدون سحب الاستقالة)
- تقرير موجز لأنشطة ومنجزات المركز في الفترة ما بين يونيو 2020 وأكتوبر 2021
للتاريخ (1)
منذ يناير 2019، صدر منشور عام، باسم “التزام البناء والخدمة”. صدر المنشور عن طريق تجمع المهنيين، وفحواه كانت دعوة لجميع السودانيين، بشتى مؤهلاتهم وخبراتهم، للالتزام بالمساهمة الجادة في بناء السودان وخدمة شعبه عبر مؤهلاتهم وخبراتهم، وقدر استطاعتهم، عند زوال النظام الباطش. وكان المنشور يخاطب الكفاءات السودانية داخل البلاد وخارجها، مع تركيز واضح على بالخارج، التي شتّتها النظام البائد حول العالم، فصار بذلك السودان حالة قصوى من حالات “هجرة العقول” التي تشكّل إحدى العقبات التنموية الكبيرة للبلدان النامية اليوم. وقّع على الالتزم أناسٌ كثيرون، وكان الحماس حوله بائنا. كنتُ ضمن الفريق الذي قام بترتيب وصياغة الالتزام وعملية تسجيل وترتيب قائمة بالذين تواصلوا مع الفريق لأجل ذلك؛ وبطبيعة الحال، كنت ضمن من سجّل اسمه في التزام البناء والخدمة.
في سبتمبر 2019، وبعد أن تمت الإطاحة بالنظام البائد، لكن لم تمض الثورة كعشم الثوار ودخلنا فترة انتقالية غريبة وصعبة، كجزء من استمرار الثورة رغم المعوّقات التي ما زالت في طريق استمرارها. في تلك الأوقات نشرت هنا أيضا منشور فيه الآتي:
“في مسألة انا كنت فاكرها واضحة، لكن في نقاش الليلة مع أحد المعارف المهتمين اتضّح لي ان البعض ربما فهموا خلافها من كتاباتي. طيب… برغم كل شيء، أنا بفتكر أي ناس مؤهلين وبيقدروا يشتغلوا حاليا في مؤسسات الدولة السودانية – ما عدا المناصب السيادية في السلطات الثلاث [أي التنفيذية والتشريعية والقضائية] – واتوفرت ليهم الفرصة، حسب تأهيلهم، مفروض يشتغلوا. بنفس القدر أي ناس عاوزين يستغلوا هامش الانفتاح الحاصل الان عشان يتحركوا في مشاريع مدنية كويسة (ذات إضافة اقتصادية منتجة، أو إضافة اجتماعية أو تنظيمية أو معرفية أو ثقافية)، برضو كويس أنهم يتحركوا، ويستحقوا التشجيع والدعم. ده موش ضياع زمن، لأنه مؤسسات الدولة دي أصلا ملك الشعب بالأصالة، وإن اتسعت الآن لأفراد الشعب المؤهلين هذه الفرص فهذا حقهم المنتزَع من خلال الحراك الثوري المستمر، والذي يمر حاليا بمرحلة من مراحله. الثورة لم تنتصر بعد لكن حققت مكتسبات وفرص عمل وتحرك ما كانت متاحة سابقا، فالشعب أولى باستغلالها جميعا (قدر الإمكان، ما دامت لسّع موجودة). وبرضو لأنه الشغل في مؤسسات الدولة وفي المجال العام الديناميكي وفق هامش انفتاح حا يدّي المؤهلين والناشطين الجادين ديل فرصة يكتسبوا خبرة عملية في مهارات ومعارف إدارة دولاب الدولة، ودي كلها مكاسب مشروعة ومستحقة للثورة. أما مناصب الوزارات الكبيرة، فمهما كان مستوى حسن ظنّنا في بعض من استلموها مؤخرا، إلا أنها تبقى مناصب إدارية وواجهة سياسية أكثر من أي شيء آخر، بينما معظم الشغل الهيكلي والفني في الوزارات ومؤسسات الدولة بيقوموا بيه قيادات الصف الثاني في هرمية المؤسسات (مثل: وكلاء الوزارة ومدراء الأقسام والاستشاريين الفنيين، إلخ) أكثر من الوزراء أنفسهم، زي ما قلنا زمان، وده هو المهم خصوصا في محاولات إعادة هيكلة مؤسسات الدولة والخدمة المدنية لتصبح جديرة بالاسم وتتخلص تدريجيا من السوس الذي نخر فيها طيلة 30 عاما.”
ثم في مارس 2020، وعبر المكوّن المدني في الحكومة الانتقالية، تم التواصل معي، بدون مبادرة مني أو توقّع، كما تم التواصل مع آخرين من الكفاءات السودانية العاملة بالداخل والخارج، للمشاركة وفق ما حظينا به من فرص التعليم وتراكم عندنا من خبرة في مجالات التنمية الصناعية، لنساهم مع غيرنا في عملية صعبة وشائكة ومليئة بالمحاذير، هي عملية إعادة بناء مؤسسات الدولة السودانية، وهي إعادة من تحت الصفر؛ وليس من مواقع سلطة في الحكومة، إنما من مواقع قطاع عام في الدولة. تم تجميع سيرنا المهنية ومراجعتها، ثم الاتصال بنا بخصوص المهام التي دعينا للمساهمة فيها.
طلبت وقتا لمراجعة الأمر، وبعد مراجعة داخلية ومشاورة لمن أستأنس برأيهم وأعرف فيهم النصح الذي لا يتخلله تملّق أو مجاملة، قبلت بمهام التعيين. خلاصتي – والتي عبّرت عنها في الكتابات العامة المذكورة آنفا – هي أني كنت سأجد صعوبة في الشعور بالاتساق الأخلاقي لو رفضت حتى خوض التجربة على أقل تقدير، ثم أقرر هل أواصل أم لا. ذلك لأن إدراكي لحجم التعقيد والتحديات، والمشاكل والمحاذير، لا يبرّر لي أن أعتذر عن هذه الدعوة باختصار. إذن اتخذت قرارا استغرقني تفكيرا ومشورة ومراجعات غير بسيطة، ولم أتعامل مع الموضوع باستبساط أبدا، وما زلت. بعد ذلك عليّ أن أكون مسؤولا عن خياراتي، وعن تحمّل نتائجها، الآن وسابقا ومستقبلا. وهذه التدوينة – وغيرها في نفس الموضوع – هي بعض شهادتي على ما عاصرته، وعلى نفسي، أتركها هنا لمن يهمّهم الأمر ولمن أزعم أني أفعل ما أفعل لأني أشاركهم المصير، وأدين لهم بالكثير، شئت أم أبيت.
مساء 19 مارس، تم الإعلان عن خبر تعيين شخصي في مركز البحوث والاستشارات الصناعية، بواسطة رئيس الوزراء الانتقالي وبتزكية وزير الصناعة (ووفق قانون المركز 1981). التكليف تم بعد مراجعة سير ذاتية مقترحة للوظيفة وبعد فترة من الأخذ والرد مع وزارة الصناعة وهي تبحث عن كفاءات سودانية متعددة لتغطية عدد من المهام في الوزارة وفي المؤسسات المتعلقة بها. كنت أحد الذين وافقوا على المساهمة بما يمكن، بعد تواصل الوزير وطاقمه الإداري معي، ومع الفهم والاعتبار أن الأوضاع الراهنة في السودان أوضاع استثنائية وبالتالي فالمهام لن تكون سلسة أو في بيئة اعتيادية. بتاريخ 20 مارس، قمت بكتابة توضيح عام، ونشرته في صفحتي في الوسائط الالكترونية، حول التكليف ومقتضياته وطبيعته. فعلت ذلك لاعتبار الأوضاع والملابسات الاستثنائية نفسها التي يمر بها السودان، والتي تجعل مثل هذه المسائل بحاجة لأن تكون ذات علنية وشفافية كبيرة.
كتبت بصورة عامة في توضيح ما أعرفه عن عملية التعيين، وأنها تمّت وفق مراجعة لسيرتي الذاتية التي وفّرتها للوزارة، والتي تم طلبها أيضا وفق معرفة سابقة للوزير وبعض من يستشيرهم بخبرتي المهنية والبحثية. هذا التكليف وهذا القبول حصلا رغم أن خطي النقدي المعارض للأوضاع التي آلت إليها ترتيبات الفترة الانتقالية كان واضحا ولم يتغيّر. يضاف لذلك أن الوظيفة نفسها فنية و”أكاديمية” بصورة كبيرة، أي ليست متعلقة بدهاليز السلطات السياسية في الحكومة والدولة، فشروطها ومهامها بحثية وتدريبية واستشارية – غير قرارية – في قضايا فنية واستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد. وقد ذكرت في توضيحي ذلك أن قبول هذا التكليف ليس بالضرورة قرارا صائبا – فقد قلت إني ربما أكتشف لاحقا أنه لم يكن صائبا – لكنه قرار مبني على حيثيات مهنية وأخلاقية.
أيضا تناولت في التوضيح مسألة ذكرتها منذ فترة طويلة – قبل أي إرهاصات للتعيين وقبل أي مخاطبة بذلك الخصوص بين الوزارة وشخصي – أن وظائف القطاع العام ليست مناصب حكومية، وموظف القطاع العام ليس كعضو الحكومة،
public-sector employee vs. government member
وأن القطاع العام السوداني مكان يعمل فيه الشرفاء بمؤهلاتهم وخبراتهم الفنية لرفع أداء القطاع العام، قدر الاستطاعة، في ظروف صعبة جدا، وأن المساهمة معهم أقرب للتكليف لا التشريف، وهي ليست مضمارا جيدا للتوزيع السياسي/المذهبي. وأن قواعد التعيين في القطاع العام في الدول الديمقراطية وذات الشفافية – وفي حالات الاستقرار دع عنك الأوضاع الانتقالية – فيها تعيينات دورية ومعروفة عبر ترشيحات داخلية في المؤسسات أو عبر السلطات، ثم ذكرنا نماذج لذلك من بعض الدول المستقرة سياسيا وذات نظم ديمقراطية. ذكرت أن هذه هي الحيثيات التي أفهمها وأجد نفسي متسقا معها أخلاقيا ومهنيا، وقابلا لخوض التجربة وفقها (ولا أعرف إن كنت سأنجح أم أفشل، لكني أتسلّح بالصدق والجهد ما استطعت)، أما إن كانت هنالك حسابات أخرى غير هذه فلا علم لي بها ولم أبن قراري عليها.
ومن ناحيتي، أشهد بأني خلال تعاملي مع وزارة الصناعة والتجارة وقتها، ومع الوزير الانتقالي وقتها، وجدت منهم المستوى المقبول من التعامل والنقاش الذي جعلني أثق عموما بخيار خوض التجربة والاجتهاد فيها قدر الإمكان.
حين أتى التعيين، كنت خارج السودان، وقد دخل العالم مرحلة الإغلاقات العامة لحدود البلدان وإلغاء السفريات بينها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). بذلك تم التعيين ولكني لم أستلم مهامي بعده مباشرة، بل كانت هنالك فترة طويلة – أكثر من شهرين – لم أستطع فيها الوصول للسودان كما لم أستطع فيها القيام بإجراءات وترتيبات مهمة حتى أتمكن من القدوم للسودان لاستلام المهام (مثل تغيير أوضاعي مع جهة عملي ما قبل التعيين، وبعض الترتيبات الشخصية والأسرية التي كنت بحاجة للقيام بها قبل الوصول للسودان، وقد أخطرت الوزارة بكل ذلك، كما أخطرت الإدارة المكلفة لمركز البحوث بعموم المسألة). وعليه بدأت التواصل الجزئي مع الإدارة المكلفة لمركز البحوث، ومع الوزارة، بصورة مستمرة، وبدأت أستلم المعلومات الأساسية حول المركز والمهام، والتحديات والطموحات، وما يتصل بالوزارة وتوقعاتها، والمشاريع المرتقبة، وبعض المسائل الاستشارية المرتبطة بالوظيفة، إلخ. كان تواصلا جيدا في مجمله، ومع أناس متعاونين ومحترمين.
وشرعت مع استقبال المعلومات والتواصلات بالدرس والتخطيط لبعض ما عليّ القيام به والاهتمام به حين استلامي للمهام. شرعت في تدوين الملاحظات والتحديات الأساسية المنتظرة، وبعض المقاربات الممكنة لها، حسب خبرتي مع مؤسسات مماثلة، خارج السودان. قسّمت الملاحظات والمقاربات إلى قضايا إصلاح هيكلي (داخلي) وقضايا موضعة استراتيجية (مخرجات)، وإلى تعيين أصحاب المصلحة والخبرة الذين عليّ التواصل معهم والتفاهم معهم (بداية بعاملي المركز أنفسهم، من الباحثين والفنيين والإداريين، ومرورا بوزارة الصناعة والمؤسسات، والقطاعات الصناعية في البلد، ومراكز البحوث الزميلة ومؤسسات المجتمع والدولة المرتبطة بأنشطة المركز ونتائجه، إلخ). وقد توافقت مع الوزارة ومع الإدارة المكلفة بالمركز على أن تكون الشهور الأولى من عملي بغير مرتّب، لاعتبار أن الفترة الأولى هي فترة تجريبية (probationary period) معتادة في مثل هذه المؤسسات، حيث يقوم الموظف والجهة التي وظفته بتجريب بعضهما فيها والتأكد من كلا الطرفين قابل بمستوى أداء الطرف الآخر أو قادر على التأقلم معه بحيث تكون المخرجات جيدة أو معقولة [وما جرى لاحقا أني لم أستلم أي حقوق أو مخصصات مادية طيلة فترة مهامي، وهذا كان خيارا خاصا لأني اشترطت حصول تغييرات أساسية في ظروف المركز قبل قبول استقبال مرتّبي، وتلك الشروط لم تتم حتى نهاية المهام. ومن المهم هنا تذكّر أن حالتي هذه ليست نادرة وسط عدد مقدّر من الذين قبلوا مهام مماثلة في تلك الفترة الانتقالية]. باختصار، شرعت في العمل والاستعداد، قدر الإمكان، لأن أكون مفيدا، ومساهما مع المساهمين الجادين في رفد التنمية الصناعية في السودان بما تستحق. والحق أني أزعم أني شرعت في هذا العمل منذ سنوات، وسأبقى أعمل فيه مع العاملين ما بقيت عندي قدرة على ذلك في مقبل الأيام.
(للتوثيق أيضا: كان لي شرط آخر لقبول الوظيفة – وقد أوفاه لي وزير الصناعة وقتها – وهي أني وفق مهام الوظيفة لست بحاجة لمقابلة أي شخص من المكوّن العسكري في السلطة الانتقالية، ولست بحاجة للتعامل معهم في أي أمر يخص العمل. أذكر أنه طيلة تلك الفترة حرصت وتمكّنت أن لا أتعامل مباشرة مع أي شخص أو جهة من الذين يقعون تحت السلطة الرسمية للمكوّن العسكري في السلطة الانتقالية.)
——–
للتاريخ (2)
يوم 21 يوليو، في فيسبوك، كتبت الآتي:
“قريبا: كتاب عن حوكمة التنمية
development governance
باللغة العربية.
يعرض قضاياها الأساسية، ويستكشف أطروحات ومقترحات بشأنها.
تعوّدت ألّا أعلن عن كتاب، إعلانا واضحا، إلا والمخطوطة في المطبعة. لكن هذا استثناء؛ لعدة أسباب، تتعلق بسياقنا الحالي ووتيرة الأحداث. المخطوطة جاهزة، وبقيت بعض المراجعات…. وحسبُ الكتابة الجادة، المستقصية، شأوا أن تضيء جوانب في موضوعها وتغري باستكشافها أكثر، وتعرضها على الكتاب الأوسع: كتاب الحياة.”
وكذلك كتبت في نفس اليوم:
“على المستوى العام، المسائل واضحة نوعا ما: ما ينبغي فعله وما يجب تركه.
على المستوى الخاص، كل فرد أمامه وأمامها مهمة عسيرة ومعقدة: أن يكتشف دوره المناسب في المشهد، ويلزمه.”
بعد ذلك بساعات، خرجت من حسابي في منصة فيسبوك (مع تركه فاعلا)، وهي أكثر منصة إسفيرية نشطتُ فيها في السنوات الماضية في التفاعل حول قضايا السودان ومتابعة أخباره، إذ قدّرت أن الفترة القادمة ستكون على أقل تقدير مليئة بالعمل المتواصل ومواكبة ظروف مختلفة (اجتماعيا وبيئيا). فانكربنا، واتصل عمل النهار بالليل، وبجانب الشغل الرسمي في المركز وظّفت من الوقت للأشغال المكمّلة والمرتبطة بالشغل الرسمي، ومنها تشطيب الكتاب المذكور آنفا – ثمرة عامين من الإعداد – ودفعه للطبع والنشر، بجانب دفع إجراءات أخيه الآخر (كتاب السلطة الخامسة)، ومشاريع أخرى. في الأشهر البضع الأولى من وصولي للخرطوم، للوظيفة، لم ألتق من الِأشخاص الكثُر الذين أعرفهم في هذه الديار سوى ما لا يتجاوز عدد الأصابع، ومرات متفرقة (ما عدا زملاء العمل الذين لم أعرفهم من قبل، وبعض الخُلَصاء، وبعض الناس الذين لقيتهم في ندوات عامة تمكنت من حضورها أو المشاركة فيها). لست غريبا على أسلوب الحياة هذا، لكني لم أتوقّع أن أجرّبه في مسقط رأسي. بيد أنها كانت تجربة مفيدة جدا، على عدة مستويات، مهنية وشخصية، ومنتجة بمستوى مناسب خاصة في ظروف محلية وعالمية استثنائية ومعقدة.
عدت للمنصة بعد بضعة أشهُر، مرّت سريعا في حساباتي، بعد أن شعرت أن بالإمكان العودة (مع الاستعداد لتركها مرة أخرى متى ما استدعى الأمر ذلك). عموما تأكدنا أكثر مما خلصنا له مسبقا: أن الواقع الكبير وأشغاله أكبر وأوسع بما لا يقاس من الواقع الذي تعكسه الوسائط وتفاعلاتها.
——–
للتاريخ (3)
منذ العام 2013 وحتى الآن عملت في مشاريع وجهات لها روابط متعددة بمراكز البحوث في افريقيا (أي المراكز البحثية والاستشارية التابعة للدولة كليا أو جزئيا)؛ بدءا بتنزانيا، ثم مرورا على كينيا، ثم 13 دولة افريقية أخرى، وبين ذلك قادني عملي إلى تصدّر بحث عن منظمات البحوث والتكنولوجيا RTOs (أي: بحث عن مراكز البحوث) ساعدني في الاطلاع القريب على منجزات مراكز بحوث ماليزية بالإضافة للتنزانية والكينية. تنوّع عملي من البحثي، إلى التطبيقي، إلى الاستشاري، في عوالم هذه المراكز وعلاقاتها بالقطاعات الصناعية وبالأكاديميا وبالدولة وبالمنظمات الدولية.
في تلك الأثناء، شهدت مباشرة الكثير من الظواهر المتوفّرة هنالك كما قرأت عنها، ومنها:
– التعيين في الوظائف الإدارية لتلك المراكز يتنوّع نسبيا في طريقته، حول العالم كله. في الكثير من الاحيان، وفي عدة دول حول العالم (ومنها دول في الشمال الكوكبي)، يتم التعيين عبر خيار حكومي، حسب القانون. يعني ذلك أن هنالك ترشيحات وتوصيات واستشارات داخلية في الوزارة مثلا، أو مجلس الوزراء، يتم وفقها تعيين أشخاص لإدارة تلك المراكز، وتلك الترشيحات والتوصيات تكون غالبا عن طريق مقارنة عدة خيارات ذات سير مهنية ملائمة للوظيفة. أيضا، أحيانا، قد تُرفع توصيات وفق آلية انتخاب داخلي (بين الإداريين) في المؤسسة البحثية. وحين يرسو الاختيار على شخص ما، يتم إبلاغ ذلك الشخص بالعرض (job offer) بحيث إما قبله أو اعتذر عنه (وأحيانا يكون أو تكون على علم بترشيحه أو ترشيحها للوظيفة، وربما يكون هنالك تبادل غير رسمي حول الرؤية الاستراتيجية لذلك الشخص إذا كُلّف بالمهمة). الشاهد في الحالتين ان الإعلان العام للمنافسة على الوظيفة عن طريق تقديم الطلبات ليس معمولا به في وظائف كهذه، في بلدان كثيرة جدا (منها بلدان ذات نظم ديمقراطية قديمة؛ مثل أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية). بعض قصص هذه التعيينات شهدت عليها بنفسي في السنوات الماضية. (مثلا، كنّا نشتغل في مشروع مع أستاذ من جامعة دار السلام، وفي إحدى سفراتنا بلغه خبر أنه قد تم ترشيحه كمدير لهيئة عامة من هيئات النقل والمواصلات في تنزانيا. لم يكن هو يعرف بذلك الأمر من قبل، كما أن خطه السياسي لا علاقة له بخط الحكومة عموما ولم تكن هنالك شائبة تعيين سياسي، لكنه صاحب خبرة مشهودة في المجال المذكور.)
– أيضا أحيانا كثيرة يكون باب المنافسة لوظائف عامة كثيرة مفتوحا داخليا فحسب، أي لملء الوظيفة من داخل قائمة الموظفين الحاليين في المصلحة أو الوزارة أو القطاع العام (فبعض هؤلاء يريد تغيير وظيفته، مثلا، بخلاف مسار الترقية العام)، ثم إذا لم يتم ملء الوظيفة من داخل تلك القائمة الداخلية بعد فترة، يتم فتح الوظيفة للمنافسة العامة من خارج المصلحة. هذه ترتيبات وتفاصيل تتعلّق بالظروف التي تمر بها الجهة المعنية وتمر بها البلاد عموما.
– في البلدان المستقرة سياسيا، في افريقيا وغيرها، نادرا ما تكون المواقف السياسية تجاه الحكومة شرطا للتعيين. (إلا إذا كان الشخص المعني نشط سياسيا عبر حزب معارض مثالا ومرشّح في الانتخابات القادمة، أو شيء من هذا القبيل). لكن في الغالب فإن إحدى شروط التعيين تتعلق “بالمواقف السياساتية ” (policy positions)، أي تلك المواقف التي تتعلق برؤية الشخص المعني وسيرته المهنية في المجال الذي يعمل فيه مركز البحوث. مثلا: لن يكون من الحصيف لوزير ما أن يوصي بتعيين شخص لإدارة مركز بحوث يعمل مع الوزارة وذلك الشخص معروفٌ عنه أنه يؤيد تمكين الشركات الأجنبية من القطاعات الصناعية الأساسية في البلد، في حين الوزير وحكومته يدعمون علنيّاً خط دعم وتطوير الصناعات المحلية. سيكون ذلك تناقض في الاختيار قليل الحصافة. لكن، إذا لم يكن الشخص المرشح للوظيفة يتفق سياسيا مع الحكومة، وينتقدها كمواطن، لكنه في مجاله مؤهل ولا يختلف مع خط الحكومة السياساتي في مجاله، فتعيينه ممكن وطبيعي، إذ أن الوظيفة ليست وظيفة ذات قرارات سياسية في الدولة وإنما ذات صلاحيات إدارية محدودة في مجال فني واستشاري محدود. وبالتالي، فما يقوله ذلك الشخص المرشح للوظيفة عن الحكومة خارج ساعات العمل، ونشاطه في المجال العام خارج مكان العمل، ليس من شان الحكومة…. إلا مثلا إذا تورط في قضايا أخلاقية لا يصح لموظف قطاع عام أن يتورط فيها، أو شيء من هذا القبيل.
– في العالم المعاصر، الكثير من المهنيين الأصغر سنا وأقل خبرة أثبتوا قدراتهم على إحداث نقلات جيدة في الأوضاع القائمة، في قطاعات شتى (عامة وخاصة، أكاديمية ومدنية، إلخ). أحيانا يكون المنظور الجديد للأشياء مظنة قدرة على التغيير أكثر من الخبرة وفق منظور قديم. وليس ذلك استهانة بالخبرة ولكن اعتبارا لشرط الحد الأدنى منها، أما ما يزيد على ذلك فليس بالضرورة هو المعيار الفاصل. احترام الخبرة مهم، وإفساح المجال للطاقات الجديدة كذلك مفيد ويستحق التجريب، خاصة في ظروف تكلّس أو تصدّع القديم.
——–
جرى مؤخرا الحديث العام عن واقع أن بعض الذين اشتغلوا في مؤسسات الدولة السودانية، في الفترة الانتقالية، كانوا يتلقّون مرتبات بالدولار، وبمبالغ تتجاوز كثيرا الحدود العليا للمرتبات الرسمية في القطاع العام السوداني. غالب الذي ورد بخصوص هؤلاء أنهم لم يكونوا أصحاب مناصب دستورية (أي لم يكونوا وزراء أو أعضاء مجلس سيادة أو كبار الهيئة القضائية، أو من أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي الذي ظل فكرة ولم يتشكّل) ثم ورد كذلك ان هؤلاء كانت تدفع رواتبهم جهات غير الدولة السودانية ومن خارج ميزانية الدولة السودانية (ورد أن أحد تلك الجهات هي البنك الدولي)، وأن هؤلاء تم الدفع لهم باعتبارهم كفاءات استثنائية وباعتبار أن هنالك حاجة لهم في القطاع العام وينبغي توفير رواتب محفّزة لهم حتى يبقوا (لأن فرص عملهم خارج قطاع الدولة، وخارج السودان، أكبر، وبعضهم جاء من خارج السودان فعلا). هذا موضوع يستحق إلقاء الضوء للمراجعة العامة.
أبدأ القول إني كذلك سمعت ببعض تلك الحالات، أثناء فترة عملي بمركز البحوث والاستشارات الصناعية، ولكن ليس في المركز أو حتى في مراكز أخرى، أو حتى في مؤسسات كثيرة، إنما سمعت أن معظم تلك التعيينات كانت لبعض العاملين في مجلس الوزراء ولبعض المستشارين لبعض الوزراء (ولا أعرف طريقة اختيار هؤلاء المستشارين، لأن بعض مستشاري الوزراء أيضا كانت رواتبهم محلية وبعضهم لم يتلقوا رواتب لفترات طويلة). أقول سمعت لأني لا أملك وثائق أو أرقام وأسماء معيّنة لكن لم أسمعها كإشاعات عابرة. قيل إن الكثير من هؤلاء لم يتجاوز مرتبهم 3000 دولار شهريا (وهو مبلغ يساوي عشرات أضعاف مرتبات وظائف قيادية في الخدمة المدنية، كمديري الوحدات، كما أنه بالتأكيد أضعاف مرتبات الوزراء)، ولكن ورد مؤخرا أن هنالك حالات معيّنة تسلّمت مرتبات أضعاف تلك الدولارات.
ما يجدر ذكره أن أصحاب المناصب الدستورية، من ناحية قانونية، لا يجوز لهم أخذ مرتبات من خارج ميزانية الدولة، بينما مدير هيئة أو وحدة، أو مكتب، تابع للقطاع العام أو مجلس الوزراء أو بعض الوزارات، أو استشاريين وخبراء، ربما يتم الاتفاق على أن تدفع له جهة أخرى كمساهمة منها في رفع القدرات المحلية. ذلك يعني فعليا أن بعض الموظفين يمكن أن تكون مرتباتهم أعلى من وزراء ووكلاء ومديرين، بل أعلى من المرتب الرسمي لرئيس الوزراء ولأعضاء مجلس السيادة (أتحدث فقط عن المرتب الرسمي من الدولة). ذلك يعني أيضا أن بعض زملاء هؤلاء الموظفين كانوا في رتبة وظيفية متساوية أو موازية لكن مرتباتهم لم تكن كذلك أبدا.
جدير بالذكر أيضا أن هذه القصة ليست خاصة بالسودان وحده، إنما هنالك بعض حالات دول أخرى حصلت وتحصل فيها “ترتيبات” مشابهة، وبحجج مشابهة كذلك.
كيف نفهم سياسة كهذه، في وضع السودان، في فترته الانتقالية التي أتت إثر حراك ثوري شعبي، كانت العدالة الاجتماعية وما زالت إحدى محركاته الكبرى؟ الإجابة على سؤال كهذا ينبغي أن تكون قضية رأي عام.
سأقص القصة الوحيدة التي يمكن أن أتحدث عنها بمسؤولية سرد مباشرة. منذ وصولي لتسلّم الأعمال في المركز وحتى يوم إنهاء مهامي فيه، احتفظت بمدوّنة إلكترونية أوثّق فيها الأحداث والأنشطة الأساسية التي تحصل كل يوم. في 18 أكتوبر 2020، كانت أول زيارة لمندوبين من البنك الدولي (ومعهم مرافقين من وزارة المالية) إلى مركز البحوث والاستشارات الصناعية، وكانت زيارة غير رسمية بغرض التعرف على المركز وقدراته وخططه وأي فرص تعامل مستقبلي لدعم أنشطته ومشاريعه (أو مشاركة المركز في أنشطة ومشاريع أخرى متفق عليها بين البنك والحكومة). في تلك الزيارة تحدثت مع مبعوثي البنك الدولي حديثا متنوعا حول المركز وتاريخه وما نحن بصدده الآن والتحديات الماثلة وكيف ننوي التعامل معها، إلخ. سمعت كذلك من مبعوثي البنك عن آفاق أنشطة مشتركة باعتبار أن الحكومة الانتقالية مهتمة بترفيع القطاع الصناعي وأن المركز سيكون صاحب دور محوري في هذا الأمر. لم يخرج الحديث عن العموميات والتعارف (حيث تعرّفوا هم كذلك على طاقم إدارة المركز وبعض وحداته) ولم تكن فيه أي وعود أو التزامات من الطرفين، على الأقل باعتبار تلك مجرد زيارة أولى. لكن من ضمن ما ذكروه ما أكّد عندي أخبار أن هنالك بعض الموظفين الموزعين في أجهزة الدولة (خاصة مجلس الوزراء) تُدفع رواتبهم بالدولارات، كما جاء الذكر آنفا. أخبروني كذلك أنهم يريدون تعميم هذه المسألة أكثر على عدة وظائف كبيرة وذات فنية عالية في جهاز الدولة، وحجّتهم في ذلك تحفيز الكفاءات وأصحاب “الخبرات الاستثنائية” (أغلبهم من الدياسبورا السودانية وبعضهم من داخل السودان) لكي لا يتركوا وظائف القطاع العام بسبب ضعف الرواتب، كما أن هنالك مقاربة أخرى وهي تثبيت خبراء ومستشارين في وحدات الدولة يتسلمون رواتبهم مباشرة من البنك الدولي ومنظمات خارجية ولا يعتبرون موظفين للدولة إنما أصحاب مهام ومواقع معيّنة (مُستعارين؟) بالاتفاق مع الحكومة.
في ذلك الاجتماع ذكرت لهم أن هذا اتجاه خطير، لأنكم هكذا تحلّون مشكلة مادية لأفراد معدودين وتخلقون مشاكل أكبر على مستوى الدولة والمجتمع؛ منها إحداث هوة اجتماعقتصادية غير مبررة وغير صحية بين زملاء العمل في القطاع العام ما يولد تمايزات حادة لا يمكن أن تقود إلى عواقب إيجابية في إصلاح الإنتاجية والمؤسسية في القطاع العام ككل؛ ومنها التساؤل المشروع حول الحكمة في صرف تلك “المساعدات” بهذه الطريقة بينما يمكن استثمارها لتحسين أوضاع المؤسسات ككل عن طريق تمويل المشاريع أو تحديث بيئة العمل (مثل تحديث معامل وورش مراكز البحوث) أو صيانة المباني، إلخ؛ ومنها طبعا خطورة وجود مصدر مختلف للرواتب داخل القطاع العام بحيث تكون هنالك أسئلة مشروعة عن الولاء، وعن السيادة المحلية، وعن مستوى الاضطرابات السياسية التي يمكن توقعها بسهولة إذا تم قبول ممارسات كهذه على نطاق واسع.
لم يستمر النقاش، بطبيعة الحال، إلى حسم شيء، فقط كان مجرد تبادل معلومات ومناظير، وأنا متأكد أن رأي شخص مثلي ما كان ليشكّل سببا لهم لإعادة النظر في الموضوع، ولا أدري ما جرى بعد ذلك إذ لم أسمع بخصوص هذا الأمر بعدها…. فقط قصة أثبتها هنا للذاكرة العامة، فهي ذات قضية عامة.
——–
للتاريخ (6)
في الوظيفة، كان الجانب الفنّي (الدرسي والتنظيمي والابتكاري والتدريبي) من نمط الأنشطة التي أنفق فيها اليوم كله، بنهاره وليله، حرفيّا، بدون ملل أو كلل، فهو أراضي مألوفة(familiar grounds)، كما أن مردوده ملموس رغم صعوبته وجدّيّته ومداه الزمني الطويل، وأشعر أن فيه ما يثري الحياة ويساهم في نفع الناس.
أما الجانب المرهق حقا، الحارق للطاقة، والذي أتعلّم فيه كل يوم المزيد من دروس الانضباط، والتفهّم والصبر، ومراجعة النفس وتوسعة الخيال الاجتماعي، ودواعي الحكمة، وتعقيدات العمل الجماعي الكبير، والتشبيك المهني، فهو الجانب الإداري.. خاصة إدارة شؤون الزملاء الموظفين، وتنسيق جهودهم ومتابعة مصالحهم ومباصرة توقّعاتهم، ما أمكن لذلك من سبيل وقدرة. ذلك امتحانٌ لا يجتازه أحدٌ بالدرجة الكاملة، والمحظوظ من يجتازه بـ”مقبول”.
——–
للتاريخ (7)
ويستمر التوثيق….
قصي همرور