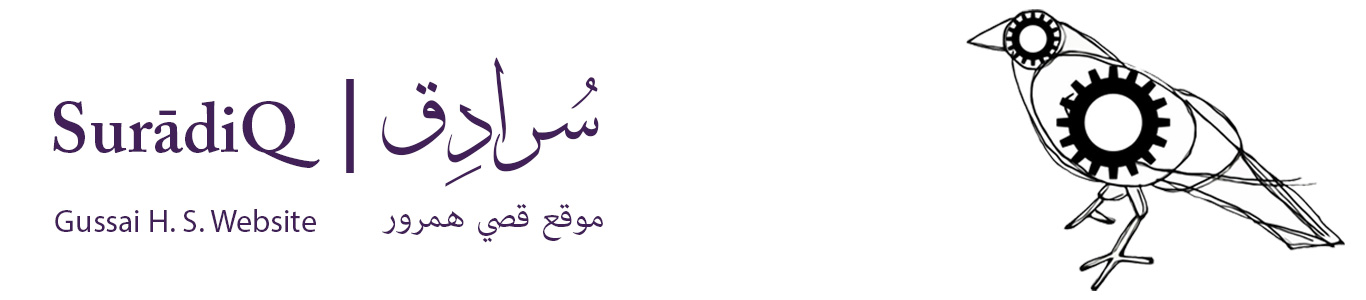[كتابات في شأن الحراك الثوري والأحداث المتوالية والمتصلة به في السودان، 2019 – 2024]
أشجار السودان
[منشور بتاريخ 11 أبريل 2024]
مما قاله الشاعر الفيلسوف طاغور: “المرء الذي يزرع الأشجار، ويتعهّدها، وهو يعرف أنه لن يلحق أيام الجلوس في ظلها، يكون قد بدأ رويدا يفهم معنى الحياة.”
هي عبارة من جوامع الكلم في معنى التشاؤل النبيل، أو الذي يسعى في مقاصد نبيلة؛ وهي عبارة تذكّرنا دوما بالسودان وافريقيا، في هذه المرحلة التاريخية. وفي هذه الأيام تذكرّنا بالسودان أكثر من أي قصة أخرى. فهذه الأيام صار الشعب السوداني الأول بين شعوب العالم كله في النزوح (الداخلي والخارجي)، حيث خُمس السودانيين حاليا نازحون في بقاع شتى. دمّرت الحرب الأخيرة الكثير، فتوّجت مسيرة سنوات بل عقود من التدهور نحو الحُطام في ما يخص معالم المجتمع العصري والدولة العصرية. ثم الأسوأ والأهم أنها قتّلت الكثير من البشر، وتهدد حيوات من هم أكثر منهم بأشكال شتى من مهددات الحياة (المباشرة وغير المباشرة)، وتسببت في أجواء جعلت الانتهاك والمهانة لللمستضعَفين أمرا يصعب رصده من كثرته، وتوّجت بذلك مسيرة عقود من امتهان الناس والشعوب في السودان. ثم إن تتويجها لهذه المآسي لا يعني أنها خلاصة المصائب ونهايتها، بل هي توضّح لنا كل يوم أن التراكمات التي أدّت لها حبلى بالمزيد من المآسي لنا، في المستقبل المنظور، ما لم تتدارك الشعوب أمرها بحكمة وبقوة وما لم تُعِد تعريف واقعها ورؤيتها لمشروع مجتمع جديد–وهو الذي يبدو كمعجزة الآن، وفق ما نراه من مستويات من يتسيّدون الميادين السياسية والعسكرية والمشاهد الفكرية والثقافية.
صورة حالكة، لا يكاد يرى دواعي التفاؤل فيها إلا مُخدَّرين و/أو جاهلين، أو أناس ينظرون إلى المدى البعيد جدا، فيرون بين طيّات الدمار فرص البناء الجديد (‘العطايا في طي البلايا، والمنن في طي المحن’). لكن ذلك التفاؤل مصحوب دوما بألم معايشة التكلفة العالية التي دُفِعت، وتخيّل التكلفة الباهظة التي ستُدفَع جُملةَ، من أجل تلك الفرصة النادرة، التي لا يجود التاريخ بها إلا لمما (ففي أوقات انهيار الأنماط القديمة واحتضارها تبرز ترشيحات بدائل أكرم وأجدر لميلاد جديد في مجرى التاريخ – أو كما قال شاعرنا ‘هذه العذراء حُبلى، باشتداد الطلق تُبلى’)؛ كما أن ذلك التفاؤل مصحوب بخلاصة شبه مؤكدة، أن الكثيرين منّا لن يعيشوا ليشهدوا أيام الفرص المتفائلة تلك (بعضنا فقط سيعيش ليشهدها). ولذلك التشاؤل.
كذلك فرؤية تلك الفرصة البعيدة أمامنا، وخضم الدمار القريب بيننا، لا يعطينا عذرا بخصوص العمل، بل إن تلك الفرصة البعيدة تتطلب العمل لها منذ اليوم، والاستثمار فيها، في أسوأ ظروف وأقل حوافز، إذ بدون العمل في هذه الأيام لا تأتي تلك الأيام؛ مثل شجرة طاغور أعلاه. ولذلك التشاؤل مرة أخرى–تشاؤم المعطيات وتفاؤل العمل.
وبين ذلك التشاؤم وذلك التفاؤل، نتذبذب في هذه الأيام، بين اليوم واليوم، بل بين اللحظة واللحظة. تارة يطالعنا الأمل في وجوه وجهود الشباب الذين واللائي يتفوقون في كل شيء على المتسيّدين للميادين والمشاهد اليوم، فتتحرك فينا دواعي الانبساط، وتارة يلطمنا الواقع بالآلام الآنية والمتوقعة قريبا، فتنقبض دواخلنا ولا ترى سوى ‘حياة لا حياة بها ولكن بقية جذوة وحُطام عمُرِ’، كما قال شاعرنا الآخر. وفي شتى أحوال الموجة هذه، بين قمّتها وقاعها، نواصل العمل، وفق ما يتوفّر لنا من الرؤية ومن الأدوات والموارد (مهما كانت شحيحة)…. نظل نفعل ذلك إلى ما شاء الله.
وفوق كذلك، تمضي حركة الحياة، وتتحرك قوافلها وتروسها، لا تتوقف من أجل أحد، في سيرورة أكبر منّا جميعا، ومما نفهمه أو نتصوّره.
جاء في إهداء كتاب حوكمة التنمية: ‘إلى من يستثمرون من الممكن في الواقع، من الفهم والعمل والصبر، لإبقاء عمليات نماء الوعي ونماء الحياة مستمرة، متصاعدة، رغم ما تجده أمامها من معوّقات شتى ومخاطر تترى. إلى من يخدمون قضايا سامية وهم في الغالب لن يروا ثمار جهدهم، بل يحرثون ويزرعون لمن يأتي بعدهم؛ وفي ذلك نبلٌ لا يعرفه إلا ذوو النبل….’
حول تناقضات وتداخلات الدولة والجيش والمجتمع: أو إلى أين يذهب النازحون
[منشور بتاريخ 14 أبريل 2024]
[نصيحة استباقية: بالنسبة للذين لا يحسنون التعامل مع الأوضاع السياسية الراهنة، المعقدة والخطيرة، في السودان، إلا وفق التصنيفات الاختزالية الكسولة الجاهزة إلى معسكرين ذوي مواقف مبسّطة وصماء يعبّرون عنها بكلمتين أو بصفتين وخلاص نملأ المنصات والوسائط بالتهم والتهييج، ، من الخير لكم ولنا أن تتجاوزوا هذا المكتوب ولا تعيروه اهتماما، فلن نجني من ذلك شيئا ولا أحد يريد الحرث في أرض جرداء…. هذه فقط نصيحة وليست وصاية
يقول البعض إن واقع أن المواطنين السودانيين ينزحون هذه الأيام إلى مناطق سيطرة القوات المسلحة السودانية (الجيش)، من مناطق سيطرة قوات الدعم السريع (الجنجويد)، مؤشر إلى أن الجيش حامي المواطنين بينما الجنجويد مستهدفينهم، في هذه الحرب التي بدأت في 15 أبريل 2023. وهؤلاء البعض، الذين يقولون مثل هذا القول، يمارسون حجاجا باهتا ومغيّبا، لأن الجيش حتى اليوم ليس حاميا للمواطنين إنما بقي أداة قهر للمواطنين عبر سنوات السودان الحديث ومنصاعا لقيادات عسكرية وسياسية قليلة المراعاة لكرامة المواطن وحياته. لكن بنفس قدر ضعف هذا الحجاج، هنالك أناس أذكياء وعلى درجة عالية من الفهم يتعاملون مع هذا الحجاج باعتباره الوحيد الذي يقدّمه من يستعينون بهذه الحقيقة المعاشة–حقيقة أن المواطنين ظلوا ينزحون من مناطق سيطرة الجنجويد نحو مناطق سيطرة الجيش.
في حين أنه من الواضح أن هنالك أناس يستعينون بهذه الحقيقة المعاشة في حجاج مختلف تماما، وهو أن المواطنين يذهبون لمناطق الجيش لأن الفوضى العنيفة التي يصنعها الجنجويد في أماكن سيطرتهم أسوأ بكثير من مناطق سيطرة الجيش حيث ما زالت هنالك بعض معالم لضمانات حركة الحياة وتوقعياتها في العصر الحديث.
[وهنا أنا من الذين يميّزون بين وجود ‘الدولة’ في الحد الأدنى، وبين وجود ما يمكن تسميته ‘توقعيات المجتمع العصري’ (وما نعنيه بالعصري هنا هو مواكبة شروط السياق المعاصر) – أي حصول بعض الإجراءات والترتيبات والممكنات المعروفة لجملة البشر في كوكب الأرض في هذا العصر (الحديث؟)، ويكاد لا يخلو مجتمع عصري منها حتى إذا لم تكن فيه دولة كفؤة، وهي إجراءات وترتيبات وممكنات نسبية متعلقة بجانب كبير من حياة الناس وحركتهم واستمرارهم في طلب شروط الوجود وفي الفعل العام من أجل احتمالات مستقبلية أفضل. أقول هذا لأني من الذين ظلوا يقولون منذ الفترة الانتقالية إننا لم نستوف بعد صفة “الدولة العصرية” في الحد الأدنى، لكن هناك جهود لبناء تلك الدولة ولتوطيد مستقبلها، بينما هناك جهود عكسية لها في الاتجاه ويمكن وصفها بجهود ‘تسييل الدولة’. التمييز هنا مهم، لأننا رغم التأكيد المبكر أن الدولة في السودان منهارة وغائبة عمليا منذ سنوات إلا أننا لا نعني أن ‘كله جايز’ الآن، فهناك مستويات من توقعيات المجتمع العصري موجودة لا يمكن إنكارها ولا مصلحة في إنكارها—وهي نفس مستويات التوقعيات التي جعلت بعض جيراننا وأهلنا الارتريين والاثيوبيين ينزحون في فترات متفاوتة إلى السودان رغم سوء أوضاعهم في السودان كذلك إجمالا كما نعلم وسوء أوضاع السودانيين أنفسهم في السودان، وهي نفس مستويات التوقعيات التي جعلت جموعا من أهلنا في جنوب في السودان ينزحون لشمال الدولة السودانية بينما كانت سلطات الدولة تقتلهم وتهمشّهم من قواعد الشمال والعاصمة، كما هي نفس مستويات التوقعيات التي جعلت معارضي نظام الكيزان الوحشي يستمرون في التحرك والتعلم والعمل والحياة في السودان مع مقاومة النظام رغم وحشيته ورغم أنه جعل الحياة في السودان مضطربة وخطرة جدا على غير مواليه. وهي حالات ليست خاصة بالسودان بل بجملة العالم في العصر الحديث وشروطه العجيبة، ففي كولمبيا التسعينات (من القرن الماضي) مثلا كان المواطنون يحاولون الهرب من مناطق سيطرة عصابات المخدرات إذا استطاعوا لذلك سبيلا، ليس لأنهم سيجدون الديمقراطية والكرامة جاهزة بانتظارهم في الضفة الأخرى ولكن لأن هناك توقعيات حياة أفضل نسبيا، وكذلك كان أهل الصومال الشقيق في التسعينات يتركون بلادهم أفواجا ولا يعرفون متى سيرجعوا لها ولو لزيارة، ليس لأن صومال ما قبل الحرب الأهلية كان جنة وإنما لأنه كان فيه مستويات توقعيات عصرية كافية لأن يبقوا وتكون هناك جهود مستمرة لبناء دولة فيها كرامة للمواطنين مثلما هناك جهود مستمرة في مناقضة تلك الجهود.]
الموضوع يمكن النظر له هكذا: حتى عندما يكون لديك عدوّان، ليس أحدهما بأفضل من الثاني في السوء الإجمالي، أنت ما زلت بحاجة لاستراتيجيات مختلفة مع كل واحد فيهما حسب نوعية العدو وحسب أدواته وحسب أهدافه معك…. كون الاثنين سيئين موش معناه انك تتعامل معاهم زي بعض تماما، موش لأنه ده فيه ظلم ليهم هم (الاثنين يطيروا) إنما لأنه ده موش في مصلحتك أنت ومصلحة ناسك. لا يصح أن نهدم البيت على الجميع، بمن فيه نحن أنفسنا، عشان حردانين وصبرنا نفد. (وطبعا ليس الجميع الذين يرون غير ما نرى حردانين، لكن الكثير منهم يجسدون درجات متفاوتة من الحردان ونفاد الحيلة).
الجنجويد في الصورة الكبيرة رصيدهم ليس أكثر إجراما في حق شعوب السودان من رصيد الجيش (إذا حسبنا رصيد الجيش منذ بدايات الحكم الوطني وانت جاي وليس في الحرب هذه فحسب)، ولا يمكن لعاقل أن ينسى أو يتناسى أن إنشاء المليشيات الموازية للعب الأدوار القذرة من عادة هذا الجيش وشارك فيها مرارا، حتى لو لم يكن دوما المقرر بشأنها؛ بيد أن الجنجويد خطر استراتيجي أكبر حاليا لأنهم يجرّدوننا من أدوات الفعل السياسي العام وضرورات الحياة للاستمرار في الفعل السياسي–بجرّدوننا من مقوّمات وتوقعيات المجتمع العصري/المعاصر ومن أي فرصة لمستقبل دولة كفؤة نحاول بناءها (ونريدها دولة تنموية ديمقراطية، محرّكها العدالة)، ويجرّدوننا تجريدا مباشرا وجائحا من الأمن المجتمعي النسبي (مع التركيز على ‘النسبي’) ومن الحد الأدنى من الضمانات على النفس والعرض والممتلكات في مناطق سيطرتهم، بحيث أنه بينما نحاول استعادة تلك الضمانات في المناطق المهمشة لسنوات (مثل دارفور وجبال النوبة، وجنوب السودان قبل الانفصال) أًصبحنا نفقدها في كل السودان، أي ننتكس انتكاسات مستمرة حتى نصل مرحلة ‘كل البلد دارفور’ ليس بالمعنى الثوري المطلوب، والذي هتفت به حناجر الثوار، وإنما بالمعنى الفظ الذي يشتت أي أمل قريب لكل السودانيين في شتى بقاع الأرض ويبدّد كل قيمة للتضحيات والدموع والدماء والعرق التي بذلها السابقون. السعي الثوري هو أن نصبح جميعا سواسية في الكرامة لا سواسية في البؤس (equal in misery)—وليس ذلك تملصا من مسؤوليتنا الجماعية تجاه ما حصل لأهلنا في المناطق المهمشة، بيد الكيزان وأنظمة الحكم المتعاقبة، إنما هو تأكيد لتلك المسؤولية التي ستظل تتبعنا حتى نقدم في حقها الكثير الكثير من شروط العدالة التاريخية والتنموية والقانونية والثقافية، كما أن ذلك ليس إنكارا بل هو اعتراف مؤكد بما ظل راجحو العقل والضمير يقولونه لعقود وهو أن المظالم والظلامات التي تصيب أطراف البلاد ولا نتحرك لمعالجتها بصدق سوف تصل للوسط وتنتشر في كل البلاد بعد حين؛ لكن ليست هذه نهاية القصة. طبيعة منشأ وهيكل الإقطاعية المسماة بالدعم السريع، وطبيعة علاقاتها الخارجية والداخلية وأنشطتها الاستخراجية، تجعل من غير الممكن التحرك قدما نحو تلك العدالة ونحو عملية بناء دولة كفؤة وكريمة للسودانيين مع وجود تلك الإقطاعية؛ أي أن هناك تناقض جوهري بين بقاء واستظهار الجنجويد وبين تحقيق مصالح الشعب السوداني ومستقبل الدولة السودانية المطلوبة.
(أما محاولات تشبيه الجنجويد بحركات المقاومة المسلحة ذات القضايا السياسية والجذور التأسيسية المشروعة، مثل الحركة الشعبية لتحرير السودان، أو محاولات تصوير الجنجويد كجزء من الجيش الرسمي انفصل عنه، فهي محاولات يائسة ضد المنطق وضد التاريخ الموثق، وتم تناولها في كتابات سابقة. لو كانت هذه الحرب تخوضها حركة مقاومة مسلحة أو مجموعات مقاومة/ثورية متباينة ضد قوات السلطة المركزية، أو كانت تخوضها قوة عسكرية من داخل الجيش على قيادة الجيش، لكانت طبيعتها مختلفة اختلافا أساسيا من طبيعتها الحالية).
ذلك بينما الجيش، في هيئته الحالية، عدو قديم لنا ومعروف، بل إن دماء شهداء الثورة لم تجف بعد من أيديه، فهو بالتأكيد خطر علينا وعلى مساعينا التحررية. الجيش عدو استراتيجي لنا على المدى الأبعد، وذلك ليس لاختلاف جوهري بين قيادات الجيش وقيادات الجنجويد (فالمشكلة هنا أعمق وأكبر من مشكلة من يقود الجهتين، رغم أن تلك القيادات بالتأكيد جزء كبير من المشكلة). لكن الجيش نفسه محتاج لمقومات الدولة من أجل أن يبرر وجوده ومن أجل أن يرفد هياكله بالموارد المادية والبشرية، وهذه حاجات نحن أيضا – نحن الشعوب – نحتاجها حاليا لكن لهدف مختلف من هدف قيادات الجيش، إذ هدفنا هو استعادة السلطة إلى يد الشعب من جميع المتسلطين والطغاة في أي صورة كانوا وأيضا إحداث تغييرات تعريفية وهيكلية لأي مؤسسة سلطوية في الدولة بحيث لا تنتج لنا جيوش طاغية أخرى مستقبلا.
ذلك لأننا، بينما نفهم أن مؤسسة الدولة العصرية ليست بريئة هيكليا من محركات الاستغلال – استغلال طبقات ممتازة لطبقات كادحة داخل المجتمع، واستغلال قوى امبريالية/نيوكولونيالية لوكلائها المحليين في دولة ما بعد الاستعمار – إلا أن ذلك الفهم لصفة من صفات الدولة العصرية لا يُعتبر فتحا في حد ذاته، ما لم يساعد على تطوير أدوات نقدية، دايلكتيكية، للتعامل مع الدولة العصرية، أي الأدوات التي تموضعنا في السياق التاريخي لنستعمل معطياته من أجل خلق ظروف مستقبل أفضل–أي نستعمل الدولة العصرية كأحد تراكمات الحداثة والتحديث حتى نطوّر قدرات إدارية/تنظيمية وتكنولوجية/صناعية أفضل للشعوب يمكنها عبرها أن تعيش حياة أكرم كما يمكنها مستقبلا تجاوز نموذج الدولة العصرية نفسه، يوما ما. بدون تلك الأدوات النقدية (والدايلكتيكية) يمكننا أن نخلط بين فهم الظاهرة (الدولة العصرية) وبين مجرد الشكوى والتذمر منها (ذلك التذمّر الذي يفقدنا الحكمة الثورية في استعمال معطيات الواقع من أجل تغيير الواقع). كتبنا كثيرا عن أهمية منظومة الدولة العصرية بالنسبة للشعوب التي تعيش في السياق التاريخي الحالي، فالدولة العصرية هي الإطار الأنجع، حتى الآن، الذي تستطيع الشعوب عبره أن تسعى للحيازة على أكبر قدر ممكن من فوائد عصر الحداثة – فوائده “التحديثية” التكنولوجية والاقتصادية والمعرفية والإنسانية – كما تسعى عبره لاستخدام أدوات التنظيم الشعبي لمقاومة تمددات الاستغلال والسلطة التي هي أيضا من أعراض عصر الحداثة (فعصر الحداثة، كسابقيه، عصر متناقض وديلكتيكي). تعرضنا لهذا الأمر كثيرا في كتابات سابقة، لكن يمكن أن نشير إلى مقالة ‘الدولة العصرية والسودان: لا بريدك ولا بحمل بلاك’ التي نشرناها في منتصف مايو 2023، كنموذج موجز.)
القصة أقرب لأنك تفضّل الحياة في ظل حكومة شمولية قاهرة من أنك تفضّل الحياة في مناطق سيطرة عصابة مافيا وانسحاب الحكومة. الحكومة الشمولية القاهرة عدو لك لكن أدوات مقاومتك لها متوفرة في الحد الأدنى وأنت بإمكانك أن تستعملها من أجل أن تواصل النضال وتسقطها ثوريا وتستعيد دولتك ومكتسباتك عبرها، بينما في مناطق سيطرة المافيا أنت لا تملك أي أدوات مقاومة بخلاف المخاطرات الفوضوية التي خلقت شروطها المافيا نفسها. المفاضلة إذن مفاضلة استراتيجية.
هذا نفس السبب الذي جعل حركات التحرر الوطني، في افريقيا وآسيا، أيام الحرب العالمية الثانية تنتبه لخطر الفاشية-النازية الأكبر رغم انها لا تحتاج لمن يذكّرها بأن الحلفاء (أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية) أعداء استعماريين واضحين، فالعدو الاستعماري لم تنته معركتنا معه لكن العدو النازي-الفاشي كان ينبغي التخلص منه أولا لتفادي أي سيناريو يصبح فيه الفاشيون هم السلطة العالمية-الاستعمارية الجديدة، فهم أسوأ لأنهم انتكاسة زائدة وتجسيد أكبر للقوى الرجعية في النظم الرأسمالية.. وهذه خلاصة وصلت لها حركات التحرر الوطني وصولا مستقلا، بأدوات تحليلها هي للواقع ومعطياته، أي لم يحصل بتأثير خارجي مزعوم.
يمكن أن نسهب في هذا الأمر أكثر، لمن يريد. والتر رودني، في كتابه ‘كيف قوّضت أوروبا نماء افريقيا’، تحدث عن التعليم الاستعماري الذي استهدف خلق “أفندية” محليين – فنيّيين وإداريين – يعينون السلطة الاستعمارية على إدارة شؤون البلاد ومرافقها بما يخدم ويمدد المصالح الاستعمارية، لكن تلك المجموعة من ‘أبناء البلد’ الذين اصطفاهم الاستعمار خرج منها عدد كبير من قيادات حركات التحرر الوطني ومناهضة الاستعمار. يقول رودني إن بروز هؤلاء حدث ‘رغم الاستعمار’ وليس وفق رغبته وتخطيطه. أضاف أملكار كابرال لذلك بتوضيح أن الفئة من الأفندية المحليين (أو البرجوازية الصغيرة) رغم مشاكلها المتعددة إلا أن جملة المرشحين لقيادة عملية تصفية الاستعمار وبناء دولة ما بعد استعمارية مستقلة يأتون من هذه الفئة، لأنهم وفق السياق التاريخي تلقوا تدريبا واستيعابا أكثر من مواطنيهم في ماهية الدولة العصرية وكيفية إدارة دفتها وملفاتها. ذكرنا كذلك، في كتاب السلطة الخامسة، أن العنصرين الأساسيين اللذين ميّزا الاستعمار الأوروبي عن مجمل أشكال الاحتلال والصراع السابق في التاريخ، هما: آلية الدولة العصرية (كأحد أعقد النظم الاجتماعية التي اخترعها البشر حتى اليوم) والتكنولوجيا الحديثة (كتراكم معرفة وخبرات بشرية انفجر انفجارة كبيرة في أوروبا في ما سُمّي بالثورة الصناعية، وما تلاها)، ثم أظهرنا الموقف الذي يقول إن كلا هذين العنصرين مكسب إنساني مشروع للجميع، أي أن عناصر الفائدة فيه للناس والمجتمعات ليست حكرا للأوروبيين، بل هي تراكمات إنسانية يستحقها كل من يضع يده عليها (ثم قد يعيد تشكيلها على شاكلته حيثما يرى ذلك ممكنا ومشروعا). باختصار، هذه غنائم حرب. وبالتالي فرغم تلاقي بعض جهود المستعمِر مع جهود المناهضين للاستعمار، وتشاركهم في بعض الأدوات الحديثة للإدارة الجماعية، في ما يبدو وكأنه تداخل مصالح ، إلا أن من الواضح أن الفئتين مختلفتان بصورة أساسية في الأهداف وفي طريقة استعمال تلك الأدوات الحديثة.
هذه مسائل تحتاج لدقة في التناول. ليس بالضرورة أن الجميع سيتفقون حولها، لكن تسطيح القضايا واختزالها بالتأكيد لن يقودنا إلى بروز تحليلات ذات جودة وعمق يمكنها أن تسند مواقف اجتماعسياسية قوية وغير متخبطة. ونحن في هذا البلد ظللنا نعاني، أكثر ما نعاني، من المواقف الضعيفة والمتخبطة، وغلبة المصالح الضيقة عليها وتحريكها لها. ذلك لأن المصالح واضحة مع نفسها وفي تفسير تحركاتها، أما المواقف الاجتماعسياسية الضعيفة والمتخبطة فهي تفسح المجال للمصالح الضيقة كيما تتسيّد الأوضاع بينما تغلق المجال أمام المواقف القوية لكي يتداولها الناس بإنصاف.
……..
زاوية فنية/درامية: في الفيلم الثاني من سلسلة أفلام “بلايْد” (Blade II) – وهي إحدى شخصيات عالم مارفل للقصص المرسومة، وقام بتمثيل الشخصية ويسلي سنايبس – وبينما تحوم القصة الأساسية حول العداوة الكبرى بين بلايد وبين مصاصي الدماء (حيث هو يصطادهم وحيث هم أصحاب نفوذ وانتشار في المجتمع رغم أن مجمل البشر الأحياء غير واعين بوجودهم)، ظهر تطوّر جديد في الفيلم الثاني (2002) ولّد تقلبات وتناقضات لا يمكن فهمها إلا عبر فهم تفاصيل متراكمة لذلك العالم الخيالي. فبينما كان مصاصو الدماء يحاولون الوصول لنسل جديد من مصاصي الدماء يستطيعون الحركة في وضح النهار ويستطيعون القيام بأشياء أخرى غير مسبوقة، تورّطوا في خلق نسل جديد فعلا، له بعض تلك القدرات لكن هذا النسل الجديد عالي الشهية للدماء كما أنه يتغذى على البشر ومصاصي الدماء معا، وعضته معدية بفعالية وسرعة، فصار ذلك النسل الجديد يتضخم عدده بمتوالية هندسية مقلقة، وهو كذلك يؤدي لتحورات أخرى في التركيب الجسماني والنفسي لمصاصي الدماء (الذين يصابون بفيروسه) بحيث يتراجعون في قدراتهم الإدراكية وتسيطر عليهم الحالة الحيوانية بصورة أكبر، الأمر الذي سيقضي على نظرتهم لأنفسهم – أي مصاصي الدماء – وعلى التراث الخاص بهم والذي بنوه عبر أعمار طويلة. باختصار،خرج هذا النسل الجديد عن سيطرة مصاصي الدماء وأصبح مهددا لهم مثلما هو مهدد كبير وجديد للبشر—فقادت الأقدار بلايد وأعداءه اللدودين إلى أن يتحالفوا من أجل التخلص من هذا النسل الجديد وبأسرع ما يمكن. وبطبيعة الحال فبينما مصاصو الدماء يريدون التخلص من هذا المسخ الجديد لمصلحتهم فإن بلايد يريد التخلص منه لمصلحة البشر، لأنهم خطر جديد على البشرية ومتسارع التضخم بحيث لا بد من حسمه سريعا. من الواضح في الفيلم أن ذلك التحالف الاضطراري المؤقت بين بلايد ومصاصي الدماء كان تحالفا متوترا جدا، لكنه ضروري، كما أن كل طرف فيه يريده لهدف مختلف تماما من هدف الآخر، لأن العداوة بينهما مؤسسة وواضحة. وفعلا، نعود للفيلم الثالث من السلسلة لنواصل الحرب القوية بين البشرية ومصاصي الدماء، بعد أن تم تفادي الخطر الاكبر والذي لم يكن ليعطي أي طرف غير أسوأ سيناريو ممكن له. تذكرت ذلك الفيلم كأحد النماذج الافتراضية (لكن تعالج أزمة لها أشباه في الواقع) مع بدايات حرب 15 أبريل في السودان…. وللحديث شجون.
ما نرجوه من أصحاب العقول الراجحة والمعلومات الوافية
[منشور بتاريخ 20 مارس 2024]
على أصحاب العقول الراجحة والمعلومات الوافية، والحريصين على مصلحة الشعوب، والمنتبهين للتضارب الأخلاقي بين مصالحهم الضيقة وبين المصالح العليا (والتي هي مصلحتهم أيضا، في الصورة الكبيرة)، والواعين لخضم الاختزالات السطحية للواقع المعقد ولدور الأبواق الإعلامية الموجّهة في كل ذلك….
عليهم أن يحافظوا على رصيدهم المكتسب من المواقف المبنية على الفكر المنهجي، والمبادئ الاخلاقية الصعبة، وأن لا ينزلقوا من فرط ابتذالات الاخرين وتسطيحهم الى مجاراتهم في الابتذال والتسطيح…. لأنهم سيحتاجون ذلك الرصيد في المرحلة التي تلي هذه الحرب المباشِرة، وهي مرحلة كناشئة الليل، ‘أشد وطئا وأقوم قيلا’. الحرب الحالية نتيجة لسلسلة من الأخطاء والسخائم الفادحة، شاركت فيها جملة القوى الفاعلة سياسيا في تاريخ السودان ما بعد الاستعمار، لكن هذه الحرب – على أهميتها – لن تتخلص لنا من تلك التركة الكبيرة من الأخطاء والسخائم، بل ربما تتوالد لدينا حروب أخرى متعاقبة بسبب تلك التركة؛ إلا لو اتعظنا وتحسّن أداؤنا السياسي، فكريا وتنظيميا، في المدى العريض، فأصبحت لدينا قوى سياسية (ليست بالضرورة واحدة) تتعامل مع الأزمة في مستواها، وتتقدم فكريا وتنظيميا بصورة لا تشبه العبث الجاري الآن والذي جرى لسنوات، بل لعقود.
ومرحلة ما بعد الحرب فرصة نادرة وباهظة جدا، لا يوفرها التاريخ كثيرا، وحين تأتي فهي تأتي بفاتورة لا يريد أحد تكرارها، كما نرى اليوم. لذلك فالتفكير الجاد في ما بعد الحرب منذ اليوم، وبتدقيق وبُعد نظر، وبذل تصوّرات يمكن الالتفاف القوي حولها، جزء من إنهاء هذه الحرب لصالح السودانيين والسودان.
……..
‘حاضر المجتمع البشري، في أي لحظة من لحظات تطوره، إنما يصنعه تفاعل وتلاقح بين قوى المستقبل وقوى الماضي.. هذه القوى التي تجيء من المستقبل، هي التي تعين على تطوير الماضي، وتحفّز وتوجّه خطوات التغيير فيه.’
–محمود محمد طه
عودة لدور القوى المدنية
(منشور بتاريخ 3 سبتمبر 2023)
بناء على ما ذكرنا مسبقا، من فهمنا للقوى السياسية المدنية المطلوبة على أنها “قوى مدنية ذات رؤية واضحة لإعادة بناء الدولة واتخاذ مسار الدولة التنموية الديمقراطية، وذات سلطة قادمة من قاعدة شعبية ثورية متجذرة في الأرض وممتدة في شتى جهات السودان (أي أن قواعدها متوفرة ومتوزعة في الحركات الاجتماعية والسياسية المحلية، قوامهم عمّال ومهنيّين وتعاونيين وكميونات محلية وأجسام مطلبية ولجان مقاومة، إلخ)”، نقول إن أولويات عمل القوى المدنية هذه، في ظروف الحرب الحالية، تتشكل عبر سؤالين: مدى تأثيرها العملي أثناء الحرب ومدى استثمارها الاستراتيجي للاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب.
بالنسبة لتأثيرها العملي فإن القوى المدنية السياسية المعروفة، المتحركة في الساحة حاليا، وبسبب تنازلات متتالية وضيقة النظر منذ مفاوضات بداية الفترة الانتقالية وأثناء الفترة الانتقالية، أصبحت فاقدة لأي قوة ضغط كبيرة على القوات المسلحة أو الدعم السريع. معنى ذلك أن القوى السياسية ذات القواعد المدنية (أو القواعد المفترضة) لم تعد لديها مراكز قوة وضغط تطبقها على حاملي السلاح كيما تحصل تغييرات ملموسة على أرض واقع الحرب. هذا واقع ينبغي عدم المكابرة بخصوصه، فتخبط القوى السياسية السائدة حاليا مردّه أنهم أنفقوا ما لديهم من رأسمال سياسي (أي مقدرات الضغط) مبكرا، بل يمكن أن نقول إنهم لم يقدّروا حجم رأسمالهم السياسي (أي السند الشعبي الثوري) تقديرا صحيحا إلى أن فقدوه.
لذلك فإن إنفاق النصيب الأكبر من الزمن والجهد لمحاولة إسماع حملة السلاح صوت المدنيين، ليس استثمارا حكيما. لا يعني ذلك الانسحاب تماما من العملية السياسية مع حملة السلاح ولكن يعني أن حجم الجهد والزمن في التركيز الأكبر حاليا على العملية السياسية تضييع للزمن والجهد، بل ربما يزيد من تشتت القوى المدنية واعتبارها بعيدة من مناطق قوتها – السند الشعبي – نظرا لانشغالها بمناشدة من لا يستمعون لها (المسلحون) ومخاطبة من لا يقيمون لها وزنا (القوى الخارجية). من أجل أن يكون صوتها مسموعا في المفاوضات على القوى السياسية المدنية أن تعود لتقوية قواعدها الشعبية، وأحيانا فإن العمل في مستوى القواعد الشعبية في فترات الكوارث يمكن أن يفعل فعل السحر في إعادة تقوية الدعم الشعبي للمدنيين وإعادة التئام التنظيمات السياسية بحاضناتها الاجتماعية—ذلك أو على تلك القوى السياسية أن تتهيّأ للإزاحة، عاجلا أم آجلا، بواسطة تنظيمات سياسية جديدة (أو جديدة-قديمة)، نشأت وصعدت من القواعد الشعبية، المذكورة آنفا، وتكتسح التأثير في الساحة السياسية.
لذلك نؤكد، باستمرار، أن الاستثمار الاستراتيجي للاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب (أيّاً كان المنتصر وكيفما وصلت جهود المفاوضات)، وما ينبغي أن يشغلنا الآن، كأولوية، هو (١) موقف السند الإنساني والتضامن العملي مع شعبنا المتضرر من سخائم حملة السلاح، و(٢) الاستمرار في جهود تقوية واستحصاد الثورة الشعبية، فكرا وتنظيما. الانشغال الأول فرضته تراكمات الواقع والتاريخ، والانشغال الثاني هو الخط الثوري الأصيل، الذي تلاطمته أمواج كثيرة في مسيرته، لكنه بقي صابرا، متناميا، متعلّما من الدروس ومتسلحا بالشكيمة.
لـِئلّا تكون هذه الحرب وقودا لأخريات
(منشور بتاريخ 17 سبتمبر 2023)
لا توجد مدينة، في هذا الكوكب، لا يمكن إعادة بناؤها؛
قديمة أو حديثة، قوية البنية التحتية أو ضعيفة، ضخمة أو صغيرة.
عبر التاريخ، القديم والحديث، هُدّمت وحُرِقت مدن، وبُنِيت من جديد – وعُمِّرت – حيثما توفّرت الإرادة والقدرات.
بيد أن الحيوات التي تذهب لا تتكرر، والدروس عالية التكلفة، ربما لا نعيها جيدا فتتكرر.
ما يسمى بالحرب العالمية الأولى، كانت ضخمة ومهولة وغير مسبوقة، بمعايير التاريخ وقتها، فسمّيت ‘عالمية’ (بينما هي إحدى اندلاقات أوروبا على الكوكب). ورغم فظائعها، والخسارات الكبيرة فيها، وبعد الظن أنه قد تم إيقافها على أي حال، اتضح بعد وقت وجيز من عمر المجتمعات أنها كانت ‘بروفة’ وجذوة لحرب أكبر منها وأطول منها – ما سمي بالحرب العالمية الثانية – بخسائر أضعاف في الأرواح وفظائع أوسع وأكثر إيلاما، ومعها فترة طويلة من الانهيارات المتلاحقة والحروب المشتقة، وإعادة التشكلات للخارطة الكوكبية.
بالطبع لا بد لهذه الحرب، القائمة الآن في السودان، أن تتوقف، ويا حبذا لو كان اليوم قبل الغد. وبالطبع فإن أكثر سناريو متوقع هو سمة العصر: أن الحروب ذات الاستقطاب الكبير تقود في معظم الأوقات لطاولة مفاوضات، ولو بعد حين. هذا كله بديهي وراجح؛ كل هذا كقول لا شيء. هنالك تفاصيل أخرى أصعب من تلك البديهيات: مثل كيف نضمن أن إنهاء هذه الحرب – ولو بطريق المفاوضات – لا يكون بطريقة تجعلها مقدمة لحرب أو حروب أخرى أكبر وأخطر منها، بخسائر أوسع وأشرس (ومن يظن أن هذا القول مبالغة فما عليه إلا أن ينظر حوله ويقرأ التاريخ، بل ما عليه إلا أن ينظر إلى السودان نفسه منذ 2019 وحتى الآن)، وكيف نستفيد جل الاستفادة من الدروس الصعبة جدا حتى لا نحتاج لتكرارها–كيف نمضي في تعبيد طريق البناء في مراحل ما بعد الحرب ونحن قد غطّينا كل الفراغات والثغرات “زي وابور الزلط” بحيث لا نحتاج للعودة مرة أخرى لأي مرحلة سابقة لأننا لم نغطّها جيدا. لا بد أن نشخّص الأوضاع تشخيصا صحيحا، وننظر في الحلول التي تعالج لنا جذور الأزمة لا أعراضها فحسب، إذ بخلاف ذلك نكون قد أهدرنا الكثير من الدماء والدموع والوقت والتكلفة في غير طائل، بل ربما نكون ممن اجترّوا من سوء هذه الحرب جذوة لإشعال ما هو أسوأ منها بكثير في المستقبل المنظور.
من يظنون أن هذه أسئلة ليس هذا وقتها، هم قريبون من الذين كانوا يقولون لنا في يوليو 2019 إن الآن ليس وقت الحديث عن استمرار الثورة في أهدافها وإن الأهم الآن إيقاف المأساة والقبول بما هو ممكن وسنعتبر ذلك نصرا، فقال بعضنا ومن الذي لا يريد إيقاف المأساة، ومن الذين لا يريدون المضي قُدما نحو خطوة للأمام حتى لو كانت صعبة؛ فإنما خرج الثوّار عندما خرجوا لإيقاف المأساة ولمحاولة افتتاح مرحلة تاريخية جديدة، لكن المسارات قصيرة النظر يمكنها – بحسن نية أو بغيرها – أن تعود بنا خطوات للوراء، بعد خطوة أو اثنتين للأمام، ويمكنها أن تمدّد في المأساة وتضاعفها بينما تزعم أنها أرادت إنهاء الأيام الصعبة نهاية ناجزة وسريعة.
أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة للتعمق في المسائل، ولوقوف وقفات أشجع أمام النفس وأمام التاريخ، ولاستيعاب حجم أزمتنا وتجذرها، لا كتمرين نظري لديه براح من الوقت بل لأن الوقت أضيق مما نتخيّل أمام اتخاذ المواقف الحكيمة على المدى البعيد…. والله يستر.
تعليقات واستطرادات
(منشور بتاريخ بتاريخ 15 سبتمبر 2023)
أدناه، وعلى أربعة أجزاء صغيرة، أقدم تعليقا عاما، حفّزه أحد المعلّقين، في بوست سابق، عندما ذكر نقطتين، أردفهما في تعليقه على إحدى مقالاتي المتعلقة بأزمة الحرب الحالية:
1- قال إننا يجب أن ننظر لأرض الواقع، وبما أن الواقع عندنا في السودان يقول إنه لا توجد قوات مسلحة وطنية حقيقة فيصبح حديثي مجرد مثاليات معلقة في الهواء وغير واقعية، ثم إن حديثي ذلك للأسف حاز على رضا الكيزان – حسب زعمه – وهذا لوحده يجعل المقالة مشكلة.
2- قال، مع نهاية تعليقه، إننا يجب أن نفكر في نماذج أفضل وأجمل، مثل نموذج كوستاريكا التي لم يعد لديها جيش قومي أصلا. (طبعا بدون أن يذكر ملابسات كوستاريكا وكيف أن لديها تعاقدات حماية مع جيوش دول أكبر، كما أن سياقها التاريخي السياسي وحجمها وشبكات مصالحها الدبلوماسية في منطقتها الجغرافية جعلت هذا الخيار متاحا، في إحدى الحالات النادرة جدا في الكوكب حاليا).
والسبب في إنزال تعليقي عليه في منشور منفصل (ومجزأ) هو أن فيسبوك لديه حدود في عدد الكلمات في الكومنتات.
(1)
بينما يبدأ السيد المعلق تعليقه بالحديث عن الواقع، ينتهي بالحديث عن الخيال والتمني في نفس هذا الواقع المعقد. وبذلك نحتاج لتذكيره بما أبزره لنا من البداية: الالتزام بالواقع وليس بالأماني. فكيف نقارن دولة مثل كوستاريكا، في سياق سياسي وتاريخي مختلف جدا من الواقع المليء بالنزاعات والتغولات على الأرض والشعب في السودان؟ إذا كان الطموح هو التخلص من الحاجة للجيوش فهو طموح مشترك وقديم، لكن عبر العمل لتوفير لمقدماته وليس عبر الشعارات المجردة التي تختزل تعقيدات كوستاريكا وأي دولة حالية في العالم ليس لديها قوات مسلحة (لكن لديها قوات نظامية) وفق العرف الدولي، وهي دول محدودة جدا وحالاتها خاصة جدا.
بطبيعة الحال، من يحدثوننا عن نموذج كوستاريكا – وهذا السيد واحد منهم فقط، إذ هنالك كتّاب آخرون روّجوا لهذا النموذج مؤخرا وباختصار شديد – لا يقولون لنا حجمها الجغرافي الصغير، كما لا يقولون لنا إن لديها تعاقدات حماية مع الولايات المتحدة الامريكية، وإن الولايات المتحدة لديها مصلحة في حماية كوستاريكا نظرا للاستثمارات الاقتصادية الامريكية الكبيرة والمنصة الدبلوماسية لها فيها وبدون أن تحتاج لاحتلالها مباشرة مثلا أو تغيير نظامها السياسي بالقوة (كعادتها في امريكا اللاتينية)، بل إن مجرد كون كوستاريكا تحت هذه الحماية والرعاية الامريكية يجعل أي دولة مجاورة لها لا تفكر في التغوّل عليها (وهي ليست مجاورة لدول كبيرة أو خطرة عسكريا على أي حال). ذلك بالإضافة طبعا إلى أن البوليس الكوستاريكي مسلّح فوق المعتاد (مقارنة بقوات البوليس حول العالم بشكل عام) لأنه يقوم بمهام كانت في الماضي موكلة للجيش، فباختصار كوستاريكا لديها قوات “بوليس مجيّش” ولديها تعاقدات حماية (واستخبارات) مع الولايات المتحدة. فلو ده ياهو النموذج العاوزيننا نقدمه للسودان حاليا، قدموه انتم ودافعوا عنه، إن استطعتم، ولا ترموه على عاتقنا (مثلما طلب مني بعضهم يوما أن أنظر وأتحدث عن نموذج كوستاريكا بما أني أؤيد “التفكير خارج الصندوق”).
ومن الجيّد، كذلك، في هذه السانحة، أن نتذكر أن أهم منظّري السلام وتحقيق السلام في القرن العشرين تحدثوا عن الجيوش وعن المواقف والظروف الاستثنائية التي تقتضي التعامل معها بطريقة مختلفة من المتوقع، خاصة في سياقنا العصري الحالي وليس بالضرورة في مستقبل أيامنا، فغاندي مثلا اشتغل ضمن ترسانة الجيش البريطاني – اشتغل عديل بيدينه – أثناء فترة الحرب العالمية وفي جنوب افريقيا (في الذراع الطبي واللوجستي للعمليات العسكرية، أي لم يحمل السلاح)، رغم كل ما نعرفه عن إجرام الجيش البريطاني العابر للقارات وكونه قوة محتلة للهند ولجنوب افريقيا. ذكر غاندي أسبابه ووضّحها في مذكراته، ومنها أنه لا يعتبر نفسه في هذه الحالة مؤيدا للحرب أو مناصرا للجيش البريطاني وإنما متضامنا مع الشعوب المتأثرة من الحرب التي فُرِضت عليهم فرضا وعليهم التعامل مع تبعاتها، وأن هذا هو الموقف الذي وصل له كشخص يفكّر ويعمل في محيط وظروف ليست من صنعه ولا يستطيع دوما أن يسقط عليها مثالياته إسقاطا. ثم عندما جاء الوقت لمواجهة السلطة المعسكرة داخليا أبلى بلاءه المعروف في المقاومة السلمية كذلك، وقدّم نموذجا واضحا فيها. بينما آخرون مثل الأستاذ محمود محمد طه، كأحد أكبر دعاة الحراك السلمي في منطقتنا، كتبوا عن دور الجيوش ومهامها وأهميتها (المرحلية)، ذلك وهم دعاة سلام كوكبي وليس محلي فقط، قولا وفعلا.
هذه نماذج للتفكير وليس التمني. يقول الاستاذ محمود: “التفكير المعوج بالتمني من صفات الطفولة؛ الأطفال يتمنون ولا يفكرون. والعاطفة أشرف من أن يُنسب لها هذا العمل، لأن العاطفة في الحقيقة هي وقود الفكر. العاطفة تتسامى بالفكر، والفكر يطهّرها وينقّيها ويجعلها إنسانية. نحن كثيرا ما نقول “هذا كلام عاطفي” و”هذا حل عاطفي”…. أحب أن نصحح الوضع بأن نقول إن المسائل أقرب إلى التمني والأحلام منها إلى التفكير والدراسة.”
(2)
أما الحديث عن أن الكيزان احتفلوا بمقالي، وبالتالي فإن هذا الأمر يقدح في جدوى المقال لأن أثر المقال هو المم، فهو مزايدة لا معنى لها بالإضافة لكونها مجرد ذر للرماد في العيون والتفاف على القضية. كون أن هنالك مجموعات معادية لنا – ونحن نعرف أننا نعاديهم وهم يعرفون أننا نعاديهم والجميع يعرف أننا نعاديهم من زمان – قرروا تفسير شيء كتبته على أنه يخدمهم لا يعني ذلك أن قيمة المكتوب هي ذلك، فقد احتفى بنفس المكتوب كثيرون من الشباب والمفكرين، بشتى انتماءاتهم الحركية ومواقفهم السياسية، الذين رفعوا شعار السلمية في وجه السلاح العاتي؛ فإن كان هؤلاء الذين قدّموا نماذج محسوسة في المقاومة السلمية وفي الصدق لم يجدوا في مقالي مجافاة لخط الثورة وخط التحول الديمقراطي وخط المقاومة السلمية عند المدنيين، بل رأوا فيه سندا فكريا لهذا الخط، ما الذي يجعلني ألتفت لأن بعض الكيزان أعجبهم مقالي وأتناسى أن الذين أعجبهم المقال متباينون وأغراضهم متباينة–إلا إذا كان الغرض من الإشارة لهذه المسألة هو فقط تجاوز المقال نفسه وسهولة إدانته بدون تعب ذهني؟
ثم نحن ذكرنا كثيرا أننا لا ينبغي أن نعيش في عقول الآخرين، خاصة في ما يتعلق بمسائل مصيرية. ربما تكون مشكلة خفيفة أن نفكّر وفق نظرة الناس لنا عندما يتعلق الأمر بما نلبس أو بما نؤثث به بيوتنا أو نقيم به طقوسنا الأسرية، مثلا، لكنها مصيبة عندما نفكر وفق نظرة الناس لنا عندما يتعلق الأمر بمصير شعب ومصير دولة وعندما يتعلق الأمر بالمسؤولية الفكرية والأخلاقية في التزام الخلاصات الصحيحة (في نظرنا). كما تحدثنا عن مشكلة التأثر بالكيزان والنظر للعالم بمنظار الكيزان، بالطريقة التي تجعل الكيزان مبادرين بالموقف والفعل دوما، ونحن توابع لهم في فكرنا وعملنا، فكل ما ينبغي منّا هو أن نرى ما يقوله ويفعله الكيزان ثم نقف عكسه، بدون تقييم مستقل، وهكذا نكون عمليا مقودين للكيزان. هذا لا يلزمنا، ولا يلحق بأهل المسؤولية الفكرية، وخنادقنا معروفة، ولا مجال للمزايدة.
من موقعي، كشخص مسؤول عمّا يقول ويفعل، ومنخرط في العمل العام، قدّمت كتابة هي في نظري متسقة مع كتابات قديمة ومستمرة، ومسنودة على بحث واستخلاص جاد، ولم أدّخر جهدا في توضيح أننا بحاجة للتمييز بين مستويات الباطل في هذه الحرب، وانها حرب لم تظهر فجأة بسبب خلافات حديثة وضيّقة وانما هي نتيجة لتراكمات مشؤومة منذ يوليو ٢٠١٩ وما قبلها كما لاحظ المدققون منذ ذلك الوقت. كما أن الخلاصة الأساسية لمقالاتي كانت أن “تأييد الجيش” خطأ استراتيجي بالنسبة للمدنيين (خصوصا بالمعنى الشائع والمباشر لتأييد الجيش) – أما ‘تأييد الدعم السريع’ فلا أعرف ماذا أسميه، من فرط التوائه – وفسّرت لماذا ذلك، وأننا عندما ننطلق من موقف مصدره الأساسي هو مصلحة الشعب والدولة فإن كون جهات أخرى تبدو مواقفها الحالية أقرب لتلك المصلحة لا يعني أننا “نؤيدها” هي بهذا الاختزال الفاحش، وإنما يعني أننا نقف مع ما وقفنا معه من زمان، وما قادته له خلاصاتنا، مع غض النظر عن تقلبات مواقف الآخرين والمتأثرة بمصالحهم وأولوياتهم هم، لا مصالحنا وأولوياتنا نحن.
ثم فسّرت كذلك كيف أن مؤسسة الدعم السريع، بكل جذورها وبكل الأخطاء التي أدّت لظهورها وتوسع جبروتها، هي خطر وجودي حقيقي على الشعب وعلى الدولة (وليس على “الجيش” فحسب)، ولذلك فمن أجل خطرها ذلك ينبغي أن تزول، ووضّحت ما تعنيه تلك الإزالة (فهي إزالة للمؤسسة وللظاهرة وليس للناس بالضرورة)، كما وضّحت في مقالاتي المتتابعة سيناريوهات تلك الإزالة وقلنا إن أفضلها كان ولا زال عبر عملية سياسية قوية (وغير متسيّبة، فمن خطل القول والموقف أن تعطي الدعم السريع صلاحيات المشاركة في صفقة سياسية على مستوى الدولة ثم تتوقع منه أن يستخدم هذا الامتياز الذي وهبته له كيما يحلّ نفسه بأدب واحترام، بدل أن يستعمل ذلك الامتياز لتعزيز وجوده ولتمديد أجندته في مساحات الشعب والدولة بما يتناقض تماما مع مصالح ومستقبل الشعب والدولة). ثم لم نغيّر موقفنا القديم من القوات النظامية وهو أن الدولة العصرية في سياقنا ما زالت بحاجة لقوات مسلحة ولكنها ليست بحاجة لمليشيات موازية وخارجة عن الهيكل الدستوري للدولة. وبالتالي فإن السناريوهات المتاحة أمامنا تقول إن التخلص من الجنجويد هو خطوة أولى سليمة ومهمة، وبينما قدمنا السناريوهات الأفضل تحسّبنا كذلك للسناريوهات الأقل تفضيلا ولكنها أفضل من السناريوهات الأسوأ. هذا اسمه تمييز لمستويات الباطل – فالباطل مستويات، مثل الحق، وليس الواقع تصنيفات ثنائية سهلة – وهذا عمل يتطلب فكرا وبحثا ومسؤولية.
وكذلك قدّمت نماذج واضحة، من تاريخ الحروب الحديثة، على أن التصنيفات السطحية، التي تقول إنك إذا نبّهت لخطر انتصار الجنجويد فإنك مع الجيش بالتأكيد، أو إذا انتقدت الجيش فحسب فإنك ترجح كفة الجنجويد فقط (وفي الحالتين أنت لست ضد الحرب) بينما هنالك طرف آخر نبيل ونظيف وهو الذي يقول ببساطة إن الحرب يجب أن تتوقف (على بداهة العبارة التي لا يمكن أن يظن عاقل أننا نرفضها). هذه التصنيفات السطحية لا نقبلها، ولن نقبل أن يتم حشرنا فيها لمجرد أن بعض الناس لا يتسع أفقهم الفكري ولا معرفتهم التاريخية لغير هذه التصنيفات حاليا. إن أرادوا حشرنا في هذه التصنيفات عن طريق مجرد الكلام فليس لنا في ذلك يد ولكننا بطبيعة الحال لن نجاريهم ولن نوظف من الطاقة في ملاحقتهم ما هو غير مستحق ولن نشتغل وفقه، بل سنستمر في العمل والقول وفق ما نراه سليما ووفق ما نعتقد أنه الدور المناسب لنا في هذه الظروف المعقدة التي لا نملك جميع مفاتيحها.
[أما التصنيف السطحي الأكبر الذي يختزل المسألة كلها في بعبع الكيزان وما يخططون له، فهذا رددنا عليه أعلاه، بالإضافة لردّنا على بعض المزاعم المتكررة، وبدون دلائل واضحة ومتسقة، التي تعطي الكيزان أكبر من حجمهم بكثير. صحيح أنهم “يفوقون سوء الظن العريض” لكنهم ليسوا قوة فضائية خارقة تعرف ما لا نعرف وتسيطر على كل شيء، وقد رأيناهم ولمسنا نتائج شغلهم وقاماتهم عقودا من الزمن؛ في الحقيقة أتعاطف مع الذين احتل الكيزان عقولهم وخواطرهم لهذا الحد.]
(3)
ثم، فوق كل ذلك، ذكرنا بوضوح أن واجب القوى المدنية حاليا، وأولويتها، يكمن في مسارين: السند الإنساني للمتضررين ومواصلة العمل في تقوية الخط الثوري فكرا وتنظيما. قلت ذلك منذ أولى كتاباتي عن الحرب وحتى آخر كتاباتي عنها. قلنا إن هذا ما ينبغي أن يكون أولوية العمل وسط القوى المدنية، وأن نحتفظ باستقلالية وبناء قوة سياسية، خاصة وأننا وسط دوي السلاح وصخب الساسة، الحاصل الآن، لا يوجد من يستمع لنا أو يعيرنا اهتماما حقيقيا إلا القوى المدنية التي هي نحن (أي المدنيين). بعد كل هذا، يأتي من يختزل مواقفنا بسطحية، ويحشرها لتوافق حاجته، ثم يطبّل له من يطبّل، ثم المطلوب منّا أن نقرّ بهذا الاختزال ونأخذه مأخذ الجد. بالطبع لن نفعل ذلك، وسنعتبر المسألة برمّتها واحدة من ضرائب العمل العام، وواحدة من حالات “التكلفة الغارقة” (sunken cost).
(4)
كل هذا، بينما لدينا رصيد واضح وسابق لهذه الحرب، فصّلنا فيه ما نعنيه بانهيار الدولة، وبأهمية مرحلة إعادة بناء الدولة (التي هي هذه المرحلة نفسها، بكل تحدياتها، ومن تلك التحديات أن بعض الناس لا يعترفون بحقيقة أنها مرحلة إعادة بناء وليست مرحلة إبقاء أو إنقاذ للدولة)، كما وضّحنا ما نعنيه بأهمية الهيكلة الجديدة للترسانة الأمنية للدولة (الجيش والشرطة معا وليس الجيش فحسب) وقدمنا نماذج فيها شيء من التفصيل لهذه الهيكلة (أي لم نقدّم شعارات عامة وخاوية المحتوى مثل “إنشاء جيش جديد” ومثل “دمج الجميع في جيش واحد”) ، وكتبنا عن المشاكل التاريخية الأساسية في الجيش وذكّرنا بها في المقالات التي أتت بعد الحرب، كما وضّحنا أكثر من مرة أن قيادات الجيش الحالية (وليس المؤسسة) هي أخطر على السودان وشعبه من أي وقت مضى. كل هذا مكتوب وموثق وفيه جهد بحثي وليس مجرد سرد للخواطر والأماني.
كلٌّ يعملُ على شاكِلته
(منشور بتاريخ 30 أغسطس 2023)
في الوقت الذي كنا نقول فيه إن الدولة في السودان قد انهارت فعليا وليست فقط آيلة للانهيار، وأن ما نراه من مظاهر وإجراءات باقية إنما هي آثار للدولة التي كانت وليس دليلا على بقاء الدولة، وأن ما ينبغي أن يشغلنا حاليا هو عملية إعادة بناء الدولة، وقلنا إن ذلك أصعب من بناء الدولة، لأن البناء يقتضي البداية من الصفر أما إعادة البناء فتقتضي البداية من وراء الصفر (أو هدم الأطلال القديمة ثم بناء الجديد، ابتداءً بالأسس)، قالت لنا أصوات إن هذا الحديث غير معقول فالدولة ما زالت باقية بوضوح وينبغي علينا إدراكها وإصلاحها…. ثم عندما حلّت هذه الحرب (والتي كانت متوقعة قبل وقوعها بفترة مقدّرة) قالت نفس الأصوات إن هذه الحرب هدمت الدولة، بينما قلنا إن الحرب نفسها نتيجة لانهيار الدولة المسبق وليست سببا له، فالحروب الكبيرة كهذه لا تشتعل بين يوم وليلة وإنما تأتي وفق تسلسل يبدأ قبلها بكثير.
وعندما كنا نقول ونكتب، منذ 2018 وعبر الفترة الانتقالية وبعد الانقلاب، إن الترسانة الأمنية للدولة بكاملها (الجيش والشرطة معا) بحاجة لإعادة هيكلة، وفق أسس ومفاهيم جديدة (وضربنا أمثلة لذلك من محيطنا الافريقي وسياقنا التاريخي ما بعد الاستعماري، وقدمنا معالم أطروحات، مثل ما جاء في حلقة “هيكلة الترسانة الأمنية (الجيش والشرطة)” ضمن سلسلة “كيف يُحكَم السودان؟” التي أصدرتها شبكة عاين في منتصف العام الماضي)، وقلنا إن ذلك هو مستوى التغيير الضروري الذي يضمن خروجنا من دائرة تكرار الأخطاء القاتلة وتبادل اللوم (فليست هنالك جهة تريد أن تتحمل مسؤولية نقدية)، كانت أصوات مشابهة للأصوات السابقة (وأحيانا نفس الأصوات) تقول لنا إن هذا حديث مثير للمشاكل وغير ذي جدوى فالمؤسسة العسكرية ما زالت مؤسسة قوية ووطنية وينبغي فقط تخليصها من أدران نظام الكيزان وبعض الأشخاص الذين يسيئون لسمعة الأغلبية الشرفاء، كما ينبغي فقط العمل على الدمج التدريجي لبقية الجهات المسلحة حتى نحصل على جيش قومي ومهني و”شاطر وبسمع الكلام”…. ثم عندما جاءت الحرب (والتي لم تهبط علينا فجأة، كما ذكرنا) صارت أصوات مماثلة (وأحيانا نفس الأصوات السابقة) تقول إن هذا الجيش مسموم منذ بداياته ولا سبيل إلا لتكوين جيش جديد (هكذا)، أما إذا سألتهم، لمصلحة الجدل، ووفق اكتشافهم الكبير الحديث هذا: كيف يتكوّن هذا الجيش الجديد؟ لما سمعتَ منهم أي شيء علمي أو موضوعي، سوى أنهم يظنون أن “تكوين جيش جديد” يشبه قفل كرّاسة وفتح كراسة جديدة ثم بدء الكتابة بها من جديد،(وهذه المرة نملأ الكراسة بأسامي متعددة تكاد تشمل كل من يحمل سلاحا الآن وبدون معايير)، ذلك بينما نفس مستويات المعرفة والفهم التي كتبت في الكراسة القديمة ستكتب هذه الجديدة، ثم تتصوّر أنها ستكتب شيئا جديدا.
والآن تقوم نفس تلك الأصوات – المتأخرة دوما عن رؤية الإشارات والمستعجلة دوما لتصدّر الموجات – بتصويرنا ومن على شاكلتنا (أو من يتصوّرون أنهم على شاكلتنا) أننا نحن المتأخرين والمتعسكرين في معسكرات قديمة أثبتت فشلها، بينما إذا نظرنا إلى الرصيد المتوفر لمواقف وآراء الجميع عبر السنوات الماضية، ثم عرضناها على معايير الاتساق في الفكر وفي العمل، فذلك سيكون منحى أكثر إنصافا وأكثر وضوحا.
فنحن اليوم نتحدث عن مشروعية المرافعة عن مؤسسات الدولة، رغم أننا أشرنا في الماضي إلى أنها قد انهارت مسبقا، وإذ نرافع اليوم عن مشروعيتها مثلما قلنا سابقا بانهيارها فإنما لأننا ما زلنا نتحدث من موقع تقديرنا لأهمية إطار الدولة العصرية (المنشودة) لشعوبنا في هذا السياق التاريخي، أي من باب حرصنا على قيام دولة كفؤة في السودان، فكما قلنا بالأمس ونقول اليوم: “فالدولة العصرية هي الإطار الأنجع، حتى الآن، الذي تستطيع الشعوب عبره أن تسعى للحيازة على أكبر قدر ممكن من فوائد عصر الحداثة – فوائده التكنولوجية والاقتصادية والمعرفية والإنسانية – كما تسعى عبره لاستخدام أدوات التنظيم الشعبي لمقاومة تمددات الاستغلال والسلطة التي هي أيضا من أعراض عصر الحداثة (فعصر الحداثة، كسابقيه، عصر متناقض وديلكتيكي). تعرضنا لهذا الأمر كثيرا في كتابات سابقة، لكن يمكن أن نشير إلى مقالة “الدولة العصرية والسودان: لا بريدك ولا بحمل بلاك” التي نشرناها في منتصف مايو من هذا العام، كنموذج موجز [وقبلها في كتب “السلطة الخامسة” و”سعاة افريقيا” و”حوكمة التنمية” – الصادرة بين 2015 و2021 – أولينا مؤسسات الدولة قدرا كبيرا من تناولنا].”
أما بالنسبة للقوات النظامية، ففي رأينا المتواضع، المدوّن والموثق من قبل هذه الحرب بكثير، فإن المشكلة الأصلية تكمن في الهيكلة، لأننا لو “أنشانا جيشا جديدا” بهيكلة معتادة، فالمتوقع أن ستظهر فيه لاحقا نفس الأمراض التي في بنية جيوش العالم الثالث ودول ما بعد الاستعمار، ونفس أمراض الجهات التي تم تكوين ذلك الجيش بدمجها معا، بينما الهيكلة المختلفة هي التي تعني حصولنا على نمط مختلف (وجديد فعلا) من القوات النظامية. أما الحديث عن تكوين جيش جديد (وهي فقط عبارة هلامية مقصود بها وضع قائمة جديدة للعساكر تتضمن منسوبي القوات المسلحة ومنسوبي مليشيا الدعم السريع ومنسوبي جهات متعددة تحمل السلاح الآن) فهو حديث مجوّف لا يعي أن أي “جيش جديد” ينشأ بهذه الطريقة غير العلمية وغير الاستراتيجية وغير المتطورة إداريا لن يختلف في السوء عن تصورات “إصلاح المؤسسة العسكرية” التي كانوا يتحدثون عنها في الفترة الانتقالية، إن لم يكن أسوأ.
ثم يبلغ مستوى تطفيف الأمور، وغياب الموازين، لدى بعض ساستنا وبعض أصحاب الأقلام بيننا، أن يعاملوا مليشيا حديثة العمر ووحشية الطبيعة – ليس في رصيدها أي شيء غير أنها إقطاعية (fiefdom) تتاجر في كل شيء، تضخمت وتمددت عسكريا واقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا في غفلة من الزمان، من رحم الكيزان وبدعم ضباط ملوّثين وساسة ضعفاء، ولديها مطامح سلطوية وتوسعية تتعارض تماما مع مطامح الشعب السوداني في إعادة بناء دولة مواطنة وعدالة ومؤسسات فعالة – يعاملون تلك الإقطاعية باعتبارها قوة نظامية مساوية في كل شيء (حتى هيكليا وقانونيا) للقوات النظامية السودانية (بسجمها ورمادها الحالي، لكن بذرة التغيير الهيكلي الممكن متوفرة في قيمتها كمؤسسات دولة وليست متوفرة في المليشيا/الإقطاعية)، وباعتبار أن “الجيش الجديد” الذي يتحدثون عنه سيُنجَب من تزاوج متخيّل (وموحى به) بين قوات تلك الإقطاعية وما عندنا من القوات النظامية الحالية (بل ربما يذهب الظن ببعضهم أن قوات الإقطاعية ستكون نواة لذلك الجيش الجديد). بل تجد بعضهم يقرن بين هذه الأطروحة العجيبة، بتاعة الجيش الجديد، وبين موقف معارضة الحرب (لا للحرب) فيشوّه الموقف النبيل الرافض للحرب بأجندة مفادها أن نعطي المليشيا/الإقطاعية ما تريده (أي تنتصر) وهكذا نحل المشكلة (أي نبيع فرصة الشعب السوداني في قيام دولة مواطنة وعدالة مستقبلا؛ فباسم إيقاف الحرب الآن نجعل مستقبل السودان كله حرب متزايدة على الشعب)، فتأمل! يحار المرء حقا، ليس من مستوى التفكير فحسب، بل مستوى التعلّم من الدروس والخبرة المكتسبة المفترضة، الذي يفصح عنه بعض “أصحاب الأعلام والأقلام” في هذا البلد المنكوب؛ نفس البلد الذي تتوفر في فئاته وأجياله طاقات وأفهام عالية وجسورة ولكنها مُبعدَة أو مغمورة، بصورة كبيرة، حتى الآن (لكنها تكبر وتتوسع، بقدراتها الذاتية وبتراكم تجاربها الصعبة وهمّتها العالية، وبالاستثمار الحكيم فيها).
رغم كل ذلك، نحاول الالتزام بمبدأ ((قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ….))،
(“وما غُربة الإنسانِ في بُعد دارهِ * ولكنّها في قُرب من لا يُشاكلُ”)
ونبذل ما نراه للرأي العام بما ينبغي من تواضع، وبما ينبغي من الأمل في بقاء الذين ما زالوا يحسنون التمييز، وفي مستقبل أوسع وأجدى لشعوب السودان وشعوب المنطقة.
مشروعية المرافعة عن مؤسسات الدولة (2):
إشكالية الدعم السريع
(منشور بتاريخ 29 أغسطس 2023)
في هذه المقالة، نحاول استجلاء تساؤلات عامة تساعد في فهم الموقف المطلوب تجاه إشكالية ما يسمى بقوات الدعم السريع، وما يعنيه وجودها واستمراريتها بالنسبة للسودان كشعب وكدولة. ذلك لأنه قد تبدى أن بعض المعلومات والتوصيف قد يساعدان في استيعاب إشكالية هذا الوجود والبُعد عن تخفيفه (أو جعله يبدو كحالة غير استثنائية جدا) وتخفيف عواقب ذلك الوجود واستمراره.
ما هو الدعم السريع؟
في كتابه “قوات الدعم السريع: النشأة والتمدد والطريق إلى حرب 2023″، الذي صدر في يونيو من هذا العام، عن مركز أبحاث السودان، يسرد الدكتور سلمان أحمد سلمان قصة ظهور الدعم السريع، منذ أصوله كجنجويد محاربين مستأجرين ومسلحين من قبل “حكومة الحركة الإسلامية” [الكيزان] للقيام بمهام مقارعة حركات المقاومة المسلحة في دارفور ومهام أخرى تطلبت الكثير من العنف ومن إطلاق اليد في دارفور. في سرده يوضح سلمان مستويات الإنفاق الحكومي على تلك القوات (وعلى حساب القوات النظامية الرسمية) ومستويات منحها البراح الاقتصادي والاجتماعي لفعل أي شيء تراه كفيلا بتأدية مهامها والحصول على النتائج التي تريدها الحكومة. تدريجيا، صارت هنالك حاجة لتأطيرها قانونيا، وهو ليس تأطيرا بمعنى وضع شروط وضوابط قانونية على تشكيل تلك القوات وممارساتها أكثر من كونه تأطيرا بمعنى إعطائها صفة قانونية لتستمر في أنشطتها وتتوسع فيها، بل وتجد لها مصادر دخل أخرى أقرب لتصرفها الاحتكاري (وهي مصادر تُعد من موارد الدولة والشعب). يسرد أيضا، بوضوح، كيف قام الكيزان “بإرساء قواعد قوات الدعم السريع وتقويتها، وتزويدها بالمال والعتاد والتدريب وكل فرص التمدد والتوسع، بالإضافة إلى الحصانة والحماية من أية إجراءات قانونية على أفرادها وممتلكاتها” (صفحة 24). ثم يتطور الأمر حتى يبلغ حصول قائد قوات الدعم السريع على صفات قانونية ومناصب دستورية وامتيازات وسلطات متصاعدة لم يحصل أن اجتمعت لأي شخصية سودانية في العصر الحديث من قبل وبهذه السرعة. من أطرف تلك السلطات والامتيازات أنه في التأطير القانوني لقوات الدعم السريع لا يوجد أي ذكر لكيفية اختيار ذلك القائد بخلاف تعيين رئيس الجمهورية له – إذ ينبغي قانونا توفير معايير لتنصيبه وفترته، باعتباره منصبا في الدولة، وبالتالي يمكن استبدال صاحبه عندما يقضي فترته أو حسب سير الأمور، وهذا أمر بديهي ينطبق حتى على منصب رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومنصب القائد العام للقوات المسلحة، فما بالك بغير ذلك – كما لا توجد أي ضوابط ملموسة لديه بخصوص التصرف في قيادة قواته وتنظيمها؛ فقط كانت معظم المسائل القانونية تتعلق بمن يرفع قائد الدعم السريع تقاريره إليه وكيف، وفق ذلك، يمكن تضمين الدعم السريع ضمن منظومة الدولة ولو شكليّا. (كانت هنالك فقط مواد تتعلق بحالات الحرب الواسعة وانضواء الدعم السريع تحت قيادة القوات المسلحة، لكن تلك المواد تقلصت مع النسخ اللاحقة للقانون). ورغم كل هذا البراح القانوني فقد اتخذ قائد الدعم السريع براحا عمليا أكثر، إذ بينما القانون يقول بتعيين مجلس لقوات الدعم السريع إلا أن هذا المجلس لم يتشكل أبدا وبقيت جميع السلطات والصلاحيات محتكرة لدى قائد القوات فحسب. أما الحماية والحصانة لأفراد الدعم السريع من الملاحقة القانونية بسبب أي جرائم يرتكبونها فهي من أكثر الأشياء وضوحا في تلك القوانين.
هذا وتفاصيل أخرى مذكورة في كتاب سلمان سابق الذكر. ولبعض الفائدة، وللتحفيز على القراءة، نورد مقتبسات تلخيصية من خاتمة الكتاب (الصفحات 76-78):
“ما وُلد كميلشيا صغيرة العدد، لا تتعدى الخمسمائة فرد، في عام 2003، يحمل أفرادها البنادق على أكتافهم، وصل به الأمر إلى أن يفوق عدد قواته في أبريل عام 2023 المائة وعشرة ألف مقاتل. وهذا العدد يوشك أن يكون مساويا لعدد القوات المسلحة السودانية. وتمتد المساواة أيضا إلى العدة والعتاد. كان ذلك التمدد خلال العشرين عاما الماضية أفقيا ورأسيا، وعسكريا واقتصاديا وسياسيا، موّلته في البداية حكومة الحركة الإسلامية من عائدات النفط الكبيرة التي تم صرفها بدون رقيب أو حسيب على قوات الدعم السريع. وعندما ذهب النفط مع أصحابه في عام 2011، كان البديل ذهب دارفور الذي أصبحت بعض جباله ملكا خاصة لقوات الدعم السريع. ومع الثروة توسعت السلطة، ومع السلطة تنامت الثروة. قويت واستطالت شوكة قائد قوات الدعم السريع فوصل في زمن وجيز إلى رتبة فريق أول – نفس رتبة البرهان (مع الفارق فقط أن البرهان فريق أول ركن) رغم عدم حصوله على أي تعليم رسمي أو عسكري، ورغم أنه لم يصل الخمسين عاما من العمر. وبالتوازي فقد تسلق قائد قوات الدعم السريع الهرم الدستوري بسرعة غير مسبوقة ليحتل مركز الرجل الثاني في الدولة، وليمتد نفوذه عبر مشاركته في عدد من الحروب والمهام الإقليمية [كحرب اليمن وعملية الخرطوم]…. وسافر هذا القائد ليمثّل السودان في عدة محافل إقليمية ودولية، بما في ذلك روسيا، حيث تمّت مقابلته بالبساط الأحمر، والتعامل معه كرئيس دولة. وتمدد القائد حميدتي وبسط سلطاته محليا وخلق تحالفات مع بعض قيادات الإدارة الأهلية والطرق الصوفية وحتى مع بعض النقابات. وامتدت صلاحيات حميدتي الدستورية كنائب لرئيس مجلس السيادة لتشمل نواحي سياسية مثل رئاسة الوفد الحكومي لمفاوضات جوبا، ونواحي فنية وإدارية مثل رئاسة اللجنة الاقتصادية في حكومة حمدوك، والتي شملت عضويتها رئيس الوزراء ووزراء القطاع الاقتصادي ومحافظ بنك السودان.
لقد شمل سردنا في الفصول السابقة نقاش الإطار والخارطة السياسية والقانونية لقوات الدعم السريع منذ بداية حرب دارفور عام 2003، مرورا بهيكلة هذه القوات عام 2013، ثم تقنين وجودها عام 2017، وتحصينها من الدمج عام 2019، ثم التوافق على دمج مشروط، وتوسعها وتمددها حتى اندلاع حرب أبريل 2023. وقد سردنا ببعض التفاصيل دور حكومة الحركة الإسلامية والفريق البرهان في قيام وتقنين [وتدريب] وتوسع وتمدد هذه القوات خلال هذه السنوات. وكما أوضحنا وذكرنا مرارا، فإن قوات الدعم السريع قد خرجت من رحم الحركة الإسلامية، ورضعت من ثديها، ونمت وترعرعت في حضنها، وقويت واستطالت في كنفها. ثم جاء البرهان ليواصل ويكمّل ما بدأه إخوة الدرب والدين.
أكدت هذه الفصول أيضا أن محاولات الإبقاء على جيشين يكادان يكونان متساويين في العدد والعدة والعتاد، في أي بلد، هي فرضية عبثية، وتعكس الكثير من الاستهتار واللامسؤولية من جانب حكومة الحركة الإسلامية، ثم من جانب البرهان المدعوم بالحركة الإسلامية. وقد برزت عبثية إمكانية الإبقاء على جيشين متساويين ومستقلين بوضوح في المحاولات الساذجة لخلق علاقة توازن بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، والتي ناقشناها بالكثير من التفاصيل في الفصول السابقة من الكتاب. ويمكن وصف تلك المحاولات بإنها كانت تهدف إلى دمج قوات الدعم السريع وبقائها مستقلة في نفس الوقت. كانت تلك المحاولات العبثية شبيهة، كما يقول أهل الغرب، بمحاولات أكل الكيكة والاحتفاظ بها. فلم يحدث في التاريخ الحديث للعالم وجود جيشين في بلد واحد…. لقد أطلّت نذر الكارثة التي يمر بها السودان اليوم بوجهها عام 2013 عندما قررت الحركة الإسلامية إعادة هيكلة ميليشيات الجنجويد ومدّها بالمال والعتاد بلا حدود، والتعامل معها كقوة عسكرية “لحماية” النظام من أي انقلاب أو ثورة….” [انتهى الاقتباس]
من مجمل هذا التاريخ الموجز، حول النشأة والتمدد، يمكننا تقديم تعريف مختصر لقوات الدعم السريع كما هي حاليا. ما يسمى بالدعم السريع (كإشارة عامة) منظومة كبيرة مملوكة لعائلة، وهذه المنظومة تتصرّف بصفة خارجة عن سلطة الدولة بينما تعتمد على الشرعية التي توفرها لها قوانين وموارد الدولة، وهذه المنظومة لها قوة عسكرية كبيرة (تُستعمَل لتقديم خدمات مدفوعة الأجر لجهات خارجية ولتوطيد سلطاتها داخليا)، ولديها تكتل أعمال تجارية واستخراجية وبزنس مدعوم بحصانة قانونية، كما لهذه المنظومة شبكات علاقات خارجية بمستويات سياسية واقتصادية عالية، وتغلغلات في المجتمع المدني والأهلي—كل هذا بينما السلطة هنا تعود لعائلة معيّنة. وهذه المنظومة – الدعم السريع – تتخذ من السودان قاعدة لها (بينما لا تنحصر أنشطتها على الحدود الجغرافية للسودان ولا تنحصر مواردها البشرية على المواطنين السودانيين) وتمارس في دولته ومجتمعه ممارسات وأنشطة بوضع اليد بينما لا يطالها القانون ولا قوة الدولة.
وفق كل هذا فلعل الوصف الصحيح لماهية الدعم السريع هو أنه “إقطاعية” اقتصادية وعسكرية وسياسية–إقطاعية لأنه مملوك لعائلة، ولأنه يتصرف باستقلالية عن الدولة الرسمية وبموازاة لمؤسساتها. ولو كنّا في عصر غير هذا العصر، أي لو رجعنا بعصرنا هذا 150 أو 200 سنة للوراء، في منطقتنا هذه، لربما كان وجود إقطاعية كهذه غير مستغرب. لكن في القرن الحادي والعشرين، ووفق تسلسل تاريخ شعوب السودان وافريقيا حتى هذا العصر، ووفق المناخ الكوكبي في صيغ الحكم وتعريف الدولة العصرية، فوجود هذه الإقطاعية شاذ جدا، وله عواقب لا يمكن استسهالها على طبيعة الدولة والمجتمع.
وإذا استنفرنا خيالنا ومعلوماتنا أكثر، وأردنا أن نستخرج نماذج شبيهة بـ”إقطاعية دقلو” في هذا العصر (حسب معلوماتنا، والتي لا نزعم أنها شاملة)، فربما نقول إنها خليط من ثلاثة نماذج: مجموعة فاغنر الروسية، والتْشايبول الكورية، والمافيا. بالنسبة لمجموعة فاغنر فالشبه موجود في طريقة التكوين الأولى وفي الصلاحيات العسكرية الموازية للجيش، بالإضافة للانضواء تحت قيادة شخص واحد اصطفاه رئيس جمهورية بسلطات شمولية. كذلك يوجد الشبه في أن الطريقة التي ظهرت بها القوات الموازية لم تكن من أجل قضية عادلة أو عقيدة جديدة أو عبر التصعيد من قاعدة اجتماعية مشروعة، بل عن طريق تعاقد مع سلطة الدولة لأداء مهام حربية مقابل مكافآت مالية وامتيازات (الأمر الذي يطرح كذلك أسئلة صعبة حول مدى استمرارية ولاء تلك القوات للعائلة الحاكمة، وما يمكن أن تنفرج عنه السيناريوهات إذا انفرط عقد ذلك الولاء مع بقاء السلاح بأيدي جماعات وأفراد مشتتين ومتوجسين؛ كما لا ننسى أن العائلة نفسها تعتمد في دائرتها القريبة منها على ولاءات عشائرية كذلك، وهذه تختلف عن مجرد التعاقد الوظيفي مع الدعم السريع). لا نعرف في اللغة العربية مسمى آخر لهذه الممارسة، حتى الآن، غير الارتزاق. وفوق ذلك فهذه الإقطاعية لا تشبه فاغنر لأنها – أي الإقطاعية – تشتغل شغلها العسكري داخل وخارج السودان، بينما تشتغل فاغنر عسكريا خارج حدود روسيا فحسب وتكتفي بأعمال البزنس داخل حدود روسيا. ثم هنالك الشبه مع حالة التْشايبول، والتشايبول كلمة كورية تتألف من مقطعين (تْشاي–الثروة أو الممتلكات + بول–فصيل أو عشيرة) وهي ائتلافات تجارية وصناعية متمددة محليا ودوليا تنضوي عادة تحت عائلة من العوائل الكبيرة ولديها علاقات قوية وتسهيلات ممتازة مع سلطة الدولة في نظام رأسمالي لا يمانع الاحتكارية الشركاتية الكبرى، وقد اشتهر هذا النموذج في كوريا الجنوبية. تتشابه الإقطاعية هذه مع التشايبول على مستوى البزنس ومستوى اعتمادها على غطاء الدولة وتسهيلاتها القانونية والإجرائية لتمدد هذا البزنس. أما وجه الاختلاف فهو أن التشايبول لا تملك قوة عسكرية خاصة بها تناهض قوات الدولة بل تعتمد في بقائها وازدهارها على علاقتها الجيدة مع سلطة الدولة ومؤسساتها كما تحتاج للالتزام بالقانون كغيرها من الفاعلين داخل الدولة. وأما وجه الشبه مع المافيا فهو أن المافيا تكبر وتتفرع في ظل الدولة – رغم مجمل أنشطتها الإجرامية في حق المواطنين وضد القانون – حتى تصبح لديها مستوى من القوة الموازية للدولة (خاصة إذا ضعفت الدولة هيكليا)، الأمر الذي أدى أحيانا لأن يصف البعض الجريمة المنظمة بأنها إحدى السلطات الأخرى المعروفة في الدولة (بجانب السلطات الثلاث الرئيسية: التشريعية والقضائية والتنفيذية، وبجانب السلطة الرابعة: الإعلام). تحديدا يسميها البعض “السلطة الخامسة” أو “السلطة السادسة” (ولنا طبعا مشكلة مع هذه التسمية، باعتبار أننا نرى أن السلطة الخامسة هي التكنولوجيا، وأن تسميتها كسلطة يعطيها اعترافا قانونيا واجتماعيا). أما أحد وجوه الاختلاف فهو أن المافيا لم تطمح لأن يكون لها قانون مجاز بواسطة برلمان الدولة يبيح وجودها ويبيح جملة أنشطتها.
بقاء الدعم السريع وفناؤه: ماذا يعنيان؟
في الظروف الحالية، وبعد أن آلت الأمور إلى حرب مفتوحة في السودان، أحد طرفيها الدعم السريع، وبعد أن رأينا إمكانيات الدعم السريع على نطاق أوسع، وبعد أن رأينا طريقة ممارسته للحرب وطريقة تعامله مع المدنيين العزّل وممتلكاتهم ومع مرافق الدولة ومع حرمات المجتمع، ورأينا مستوى سقفه الانضباطي والأخلاقي، أصبح من المهم، أكثر من ذي قبل، الحديث عن مستقبل ما يسمى بالدعم السريع، لأن هذا المستقبل مرتبط بشكل أساسي بمستقبل السودان، كشعوب وكدولة.
في الفترة القادمة، يبقى الدعم السريع – أي يحافظ على بقائه – إذا بقي محافظا على التعريف أعلاه، كإقطاعية نادرة وخطيرة، أي إذا بقيت هنالك منظومة مملوكة لعائلة وبهذه الأذرع الأخطبوطية التي تجعلها فوق سلطة الدولة وفوق أي تعريف للمواطنة في الدولة العصرية. وهذا البقاء، بهذه الطريقة، يتنافى جذريا مع مسائل أساسية في المجتمع الحديث: مثل مسألة الدستور ومسألة المواطنة، ومسألة احتكار الدولة للقوة العسكرية، ومسألة احتكام جميع من في الدولة للقانون. فالصورة الوحيدة التي يمكن أن يبقى فيها الدعم السريع كما هو، داخل دولة السودان، هو أن يتحول السودان إلى بلد إقطاعيات سلطوية، بحيث أن هنالك بعض الناس فوق صفة المواطنة، وإذا صار بعض الناس فوق صفة المواطنة فإن صفة المواطنة نفسها تنتفي في الدولة العصرية، لأننا سنصبح في دولة تقبل بوجود أمراء إقطاعيين (نبلاء) ورعايا وليس مواطنين، وهؤلاء الرعايا تحت رحمة الإقطاعيين، حسيا ومعنويا. وهذا تغيير في طبيعة الدولة كلها، وهو تغيير أسوأ حتى من عسكرة الدولة وشموليتها (وقد كتبنا عن عسكرة الدولة وخطرها الكبير من قبل، في مقال “عسكرة الدولة، عسكرة الحياة” المنشور في فبراير 2020 والمعاد نشره بتصرّف داخل كتاب “حوكمة التنمية: قضايا وأطروحات”). ومن السيناريوهات التي لا يمكن استبعادها تماما، في حالة بقاء الدعم السريع، أن تتمدد تلك الإقطاعية نفسها لتبتلع الدولة كلها، وربما تتمدد إلى أبعد من ذلك، ما دامت لديها ولاءات عشائرية تعتمد عليها كمخزون سياسي-استراتيجي يتجاوز حدود السودان الغربية.
كما يفنى الدعم السريع بانتفاء التعريف أعلاه، بحيث لا تكون هنالك إقطاعية كهذه، تحكمها عائلة أو عشيرة متوارثة ثم هي متمددة بأذرع عسكرية ومدنية وبزنس وعلاقات خارجية باستقلال عن مؤسسات الدولة وقوانينها وشروط المواطنة. وانتفاء الدعم السريع هذا قد يحصل بالقوة (أي الغلبة الكاملة في الحرب) وقد يحصل بالوسائل السياسية، أو بكليهما. وإذا نظرنا للواقع الماثل فإن تطوّر الأوضاع في السودان حاليا يقول إن فرصة الانتفاء أن يحصل بكليهما، فالحرب بدأت وفق احتقانات جعلت من حدوثها مسألة وقت فحسب (بينما كان من الممكن تفاديها قبل توسع الدعم السريع كجيش موازي وليس بعد ذلك)، لكن ينبغي لهذه الحرب الآن أن تقف في أقرب فرصة ممكنة بسبب التكلفة العالية على الشعب وبسبب إحداثها لانتكاسة كبيرة في مسيرة الثورة. بيد أن المفترض من الحرب أنها ساهمت ولو بقدر مُقدّر في عملية التخلص من الدعم السريع عن طريق إضعافه وعن طريق بذل الدرسين القاسيين: توضيح طبيعته للجميع وتوضيح أنه لا يمكن أن يستمر في السودان ثم تقوم للسودان قائمة كدولة وكشعب متقدمين (وإلا فنقول إن دماء وحرمات الناس التي انتُهكِت كلها ذهبت في غير طائل وأن الأسوأ ما زال في انتظارنا مستقبلا). يمكن إكمال مسيرة التخلص من الدعم السريع بالوسائل السياسية، عن طريق أن تكون هناك قوة سياسية وشعبية كافية تجعل الوسائل السياسية ممكنة. حاليا، هناك حرب قائمة، ومن أجل أن يدخل الدعم السريع في مفاوضاتها من موقع ضعف نرجو أن لا ينتصر أو تكون عنده شبهة نصر، وهذه مرحلة (والدور الأكبر فيها بالطبع للقوات المسلحة السودانية، رغم ما لدينا من تحفظات كثيرة عليها لكنها الآن، وفي حالة نادرة في تاريخها، تقوم بإحدى مهامها الحقيقية ضمن مؤسسات الدولة العصرية، رغم اختلاف دوافع كبار الضباط الذين كانوا مطية للكيزان ثم لآل دقلو حتى وقت قريب). بعد ذلك تأتي مرحلة وجود قوة سياسية عاقلة وكافية في السودان لا تسمح لمؤسسة الدعم السريع أن تبقى بأي صفة من صفاتها المذكورة عاليه في الدولة أو المجتمع المدني أو السوق، وذلك يعني أن أنشطة الدعم السريع الحالية، الموازية للدولة وللقانون، ينبغي إنهاؤها بتفعيل الدولة وتفعيل القانون، ثم التصرف بصورة منضبطة واستراتيجية في الموارد المادية والبشرية التي احتكرها الدعم السريع، ثم الحد من تمدد سطوة العائلة الإقطاعية حتى يصبحون مواطنين، يعامَلون بموجب استيفاء شروط وحقوق المواطنة، لا أكثر ولا أقل.
إلى أين نحن ذاهبون؟
كما جاء، فلا مجال لمقارنة وضع منظومة الدعم السريع (أو إقطاعية دقلو) بوضع أي جهة أخرى صاحبة شأن وقاعدة سياسية واقتصادية في السودان اليوم (وقد ذكرنا سابقا استحالة تشبيهها بحركات المقاومة المسلحة، لأن قصة تشكيلها وصعودها وتضخمها في كنف الدولة والقانون نقيض لقصص ظهور حركات المقاومة المسلحة، ونقيض كذلك للأهداف السياسية والقواعد الاجتماعية التي تبني قوام الحركات المسلحة)، كما يصعب مقارنتها بنموذج آخر متوفر في العالم حاليا حسب علمنا (إلا ربما عن طريق دمج عدة نماذج صعبة، مثلما فعلنا في التعريف عاليه).
لا جدوى إذن من مقارنة هذه الحالة العجيبة بأي حالات معيّنة معاصرة ومستقرة في عالمنا اليوم. ولذلك فمجرد محاولة التعامل مع هذه الحالة بشيء من القبول – كأمر واقع أو كأمر لا بأس به – يجعلنا نخرج من شروط التاريخ المعاصر، ولن نخرج ناحية المستقبل.
[لكن، وللمفارقة، يمكن مقارنة هذا النموذج بنماذج تاريخية ما قبل وصول الدولة العصرية للسودان، وبالتحديد نموذج صعود الزبير باشا رحمة للسلطة في دارفور. وهي مقارنة عامة، ذكرناها مسبقا، تتعلق بتشابهات الظهور في الميدان العام عن طريق مزيج القدرات التجارية والحربية المبرزة، ثم التطور من المهام الحربية والتجارية المتفرقة إلى طموحات التملك الإقطاعي وممارسة سلطة الحكم في رقعة جغرافية، ثم تمدد تلك السلطة وتلك الرقعة عبر المزيد من توسع القوة العسكرية والاقتصادية على حساب آخرين، ثم التحالف مع سلطات خارجية كبيرة والاستقواء بها على المنافسين المحليين والحصول منها على اعتراف أوسع جغرافيا ودبلوماسيا…. ولا ندري إلى أي مدى ستمتد صور المقارنة، فالمستقبل غير معروف لدينا بعد.]
بطبيعة الحال، وبما أن فناء الدعم السريع (بالطريقة التي وصفناها عاليه) سيجرّد آل دقلو بالذات من إقطاعيتهم التي بنوها عبر العقدين الماضيين – عن طريق الكيزان وعن طريق موارد الدولة وعن طريق تواطؤ قيادات الجيش، ثم ببعض شطارة التجار الذين يتاجرون في كل شيء بدون سقوف – ففي الغالب فإن هذه العائلة ومن حولها من المؤازرين والمنتفعين لن يتنازلوا عن إقطاع كهذا بيسر وتفهّم. إذا انتصروا انتصارا واضحا، أو برزوا في التفاوض كمتقدمين في ميدان الحرب أو أصحاب أسهم أعلى، سيحاولوا أن يجعلوا لوضعهم هذا مزيدا من التقنين، وهذا لن يتأتى إلا بتغيير طبيعة الدولة نفسها لتصبح دولة إقطاعيات واحتلاب للموارد بواسطة تحالفات محلية وإقليمية (فما دامت الدولة تسمح لعائلة واحدة أن تكون إقطاعية كهذه فهذا يجعل الدولة كلها مختلفة عن الدولة العصرية وقابلة لنموذج الإقطاعيات بصورة عامة، الأمر الذي يستبدل المواطنين بــ”نبلاء ورعايا” في نهاية الأمر، ويستبدل صيغة الحكم المطلوبة عن الحكم الدستوري، ناهيك عن استمراء واستمرار الممارسات الوحشية والتغولية التي عُرِف بها الدعم السريع وصارت جزءا من هويته). وإذا لم ينتصروا إنتصارا واضحا، أو لم يبرزوا في موقع قوة أعلى في التفاوض، فعلى الأقل سيحاولون المحافظة على معظم الميزات عن طريق التنازل عن بعضها لضمان البقية. وفي مجمل الأحوال فإن الدعم السريع لا يدخل الميدان السياسي ويتحرك فيه من أجل مصلحة كبرى للدولة أو للشعب في السودان، حتى لو تظاهر إعلاميا بذلك أحيانا وحسب ما تقتضيه التحركات والمماطلات (مثل أن تحاول الإقطاعية أن تعيد تقديم نفسها كحركة سياسية ذات قضية، عن طريق تقديم برنامج سياسي عام جدا، مكتوب على ورق ومدفوع ببعض موظفيها، ببساطة).
أو، ربما يتمدد الشبه التاريخي مع حالة الزبير باشا، ليكمل القصة كما جرت بقية قصة الزبير، وهي الخروج من السودان، بالطريقة التي تمت للزبير (وهذا السيناريو أشرنا له إشارات بسيطة في كتابات سابقة أثناء الفترة الانتقالية)، حيث لم يقم من هم داخل السودان أنفسهم بنفيه إنما أصبح يشكّل مصدر إزعاج وبعض التهديد لنفس الجهات الخارجية الكبيرة التي استقوى بها داخليا، فقررت التخلص منه بصورة ناعمة ولم تكلف الكثير، ومع غيابه من المشهد المحلي ذابت إقطاعية الزبير باشا بصورة تدريجية لكن أكيدة. ولعله من أجل أن يحصل هذا السيناريو ستكون هنالك حاجة لتصاعد الضغط السياسي والإعلامي، عبر مجهودات شعبية وتضامنية منظمة، ليس للتأثير على الدعم السريع فحسب وإنما للتأثير كذلك على من يشكّلون درعا وظهيرا دبلوماسيا وإعلاميا، وماليا ولوجستيا، للدعم السريع خارج السودان، حتى يصبح أولئك في وضع تصير معه التكلفة السياسية عليهم إذا استمروا في “دعم الدعم” أعلى من تكلفة “رفع الدعم” عنه.
فهل آفاق وطموحات إقطاعية، ارتقت مرتقيات سريعة في سياق تاريخي وسياسي مليء بالتناقضات والمواريث السيئة التي سهّلت لها فلتة من فلتات الزمان، أهم من آفاق وطموحات وآفاق الشعب كله، صاحب الأرض وصاحب التاريخ وصاحب السلطة الشرعية؟ هذا تساؤل يُطرَح للرأي العام السوداني ككل، وللفاعلين السياسيين والعسكريين/المسلّحين السودانيين، ذوي الضمير، وللرأي العام العالمي الإنساني كذلك، في هذه الأيام العجيبة.
مشروعية المرافعة عن مؤسسات الدولة، ومشروعية مساءلتها معا:
هذه الحرب نموذجا
(منشور بتاريخ 27 أغسطس 2023)
للأمانة، فقد قدّم عدد من كتّابنا ومثقفينا، وروّاد الرأي والفكر السياسي الوطني بيننا، مرافعات جيدة في الفترة الماضية في نقد من يمارسون مساواة غير معقولة بين الخطايا الكبيرة التي سببتها مؤسسة القوات المسلحة للدولة السودانية، وبين “الخطيّة” الأكبر التي هي وجود مليشيا فاسدة ومفسدة بصورة متمددة في الدولة والحياة العامة. وكلما طالت مدة الحرب وتراكمت الأدلة على الطبيعة الوحشية، المنافية للدولة العصرية ولتنظيم المجتمع الحديث، لقوات الدعم السريع (الجنجويد)، كلما صارت المرافعة أقوى وأوضح. هذا التمييز المهم عبّرنا عنه سابقا بأنه من المعروف أنه ليست هنالك دولة عصرية بدون قوات مسلحة، بينما من المؤكد أيضا أنه ليست هنالك دولة عصرية كفؤة تقبل بوجود جيش موازي للقوات المسلحة بصورة رسمية ولا يخضع لسلطة الدولة في أرضها، (بله أن يكون ذلك الجيش عبارة عن مليشيا تابعة لأسرة ولديها أنشطة ارتزاقية وعلاقات بزنس وشبكات سياسية خارج إطار الدولة وبتصرف في موارد الشعب والدولة). مثل هذا الوضع غير المنطقي أشبه بأن تعترف الدولة بكبرى عصابات الجريمة المنظمة فيها وتعطي بعض المناصب الدستورية المضمونة للأسرة المسيطرة عليها وتسمح لها بالاستمرار في الأنشطة التي هي جزء من هويتها الأساسية كعصابة (وهي أنشطة في مجملها خارجة عن القانون ومنتهكة للمدنيين).
ينبغي أن نفهم إذن، ونوافق، أن مشكلة الجيش (القوات المسلحة) مشكلة هيكلية، بينما مشكلة مليشيا الجنجويد (الدعم السريع) مشكلة وجودية. الجيش بحاجة لإعادة هيكلة (تحدثنا عنها منذ ما قبل انتصار الثورة) بينما الدعم السريع بحاجة لأن يزول من الوجود (بحيث لا يصبح هناك شيء اسمه الدعم السريع، أو مسميات ومنظمات وارثة للدعم السريع أو مشابهة له، لا في مؤسسات الدولة ولا في قوى المجتمع المدني أو البزنس). هذه النقطة يعرفها الثوار منذ صدحوا:
“السلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات، والجنجويد ينحل”
أي أنهم يعرفونها قبل الجيش–وليس قبل قيادات الجيش فحسب، بل حتى قبل العساكر الذين كانوا وما زالوا يطيعون قيادات الجيش في قهر ومعاقبة المدنيين المخالفين، رغم تذكير المدنيين لهم بأن مصالحهم كعساكر أقرب لمصالح وطموحات الشعب إذ هم من الشعب أولا قبل أن يكونوا من الجيش ثانيا. (وهذه إحدى المناطق التي تحتاج لإعادة هيكلة في مؤسسة القوات المسلحة، فالهيكلة المفاهيمية المبنية على قاعدة الطاعة العمياء في هرمية الجيش – بدل أن يكون هنالك عهد شرف جندي في الولاء للشعب وللدولة وليس للقيادة الهرمية إذا تناقضت أوامر تلك القيادة وتصرفاتها مع ذلك الولاء – جرثومة ضارة ومزمنة في جسد القوات المسلحة عموما، وهذه مسألة تناولناها في كتابات وأحاديث مسبقة، منها حلقة “هيكلة الترسانة الأمنية (الجيش والشرطة)” ضمن سلسلة “كيف يُحكَم السودان؟” التي أصدرتها شبكة عاين في منتصف العام الماضي).
لا ينبغي أن نختلف على أن أدنى مهمة مطلوبة من القوات المسلحة حاليا أن تتخلص من هذا المسخ – الدعم السريع – الذي وُلِد وترعرع تحت كنفها وعلى مرأى ومسمع منها (وصحيح أن هذه خطيّة الكيزان وقيادات القوات المسلحة، بالدرجة الأولى، لكنها مؤشر لضعف مؤسسة القوات المسلحة التي تسمح بأن تكون أداة طيّعة لأفراد كيما يهدموا هيكلها وهيكل دولتها). هذا الموقف الذي يبدو أنه “يؤيد انتصار الجيش على الجنجويد” في هذه المعركة لا ينبغي أن يُترجَم مباشرة إلى “تأييد الجيش” وفق ثنائية مستعجلة في قراءة الواقع (ووصفنا لهذه الثنائية بالمستعجلة لا يعني أننا فقط نركز على الحلول بعيدة الأمد، فحتى الحلول العاجلة تحتاج لنظرة عميقة واستراتيجية تربط جيدا بين الحلول العاجلة والحلول بعيدة الأمد، بحيث لا يكون اختيارنا للحلول العاجلة يشتغل ضد إمكانية تحقيق الحلول الآجلة أو النهائية.)
كتبنا كثيرا عن أهمية مؤسسة الدولة العصرية بالنسبة للشعوب التي تعيش في السياق التاريخي الحالي، فالدولة العصرية هي الإطار الأنجع، حتى الآن، الذي تستطيع الشعوب عبره أن تسعى للحيازة على أكبر قدر ممكن من فوائد عصر الحداثة – فوائده التكنولوجية والاقتصادية والمعرفية والإنسانية – كما تسعى عبره لاستخدام أدوات التنظيم الشعبي لمقاومة تمددات الاستغلال والسلطة التي هي أيضا من أعراض عصر الحداثة (فعصر الحداثة، كسابقيه، عصر متناقض وديلكتيكي). تعرضنا لهذا الأمر كثيرا في كتابات سابقة، لكن يمكن أن نشير إلى مقالة “الدولة العصرية والسودان: لا بريدك ولا بحمل بلاك” التي نشرناها في منتصف مايو من هذا العام، كنموذج موجز.
من أجل ذلك، ينبغي للقوى المجتمعية والسياسية غير حاملة السلاح، والتي هي صاحبة المصلحة الأعلى في إنقاذ أمل الدولة من براثن الجنجويد، أن تنظر إلى مواقفها ذات الحكمة العملية بشكل عاجل وبدون ان تتناقض تلك المواقف مع إمكانيات الحلول النهائية. هنا لا نرى حكمة عملية من تقديم دعم إعلامي وأخلاقي غير مشروط للجهة الأقل شرا (القوات المسلحة)، لأن دعمنا هذا، وبهذه الطريقة، لا يقدّم ولا يؤخر في مجريات الأمور، سوى أنه يأخذ من رصيدنا الأخلاقي والسياسي الذي نحن بحاجة له في المرحلة القادمة من المعركة–-مرحلة المحاولة الخامسة للقوات المسلحة السودانية لبسط سيطرتها على السياسة والدولة وعلى الشعب، بعد انتصارها المكلّف جدا (والذي دفع ثمنه الشعب) على خطيّتها الكبرى: الدعم السريع (وهو السيناريو الذي نريده، أي انتصار القوات المسلحة، ليس لسبب سوى أنه السيناريو الأخف ضررا على الشعب والدولة)–وياله من حال لا يسر أي صديق، حال الشعب السوداني، حيث أضحت أفضل السيناريوهات الواقعية المتاحة أمامه حاليا أن تنتصر القوات المسلحة ثم نتهيأ لفترة جديدة من الشمولية العسكرية بتحدياتها ومآسيها.
لكن ما لا يستطيع أن ينكره حتى “المؤيدون” للقوات المسلحة، أن حرمة المدنيين غير متوفرة حاليا لدى أي جهة من الجهتين المعتركتين بالسلاح. فرغم أن الجنجويد أسوأ وأكثر لؤما بصورة واضحة، إلا أن القوات المسلحة في تكتيكها الحربي لم تتورّع عن التضحية بأعداد غفيرة من المدنيين العزّل كخسائر حرب؛ وهذا الواقع اعترف به حتى بعض كبار المحسوبين على “تأييد الجيش”. حاليا لا العساكر ولا الجنجويد عندهم احترام للمدنيين أو لرأي القوى السياسية غير حاملة السلاح، بل نجد أن قيادات الطرفين مستعدين لأن يسمعوا الأصوت الخارجية أكثر من استعدادهم لأن يسمعوا لأصوات من داخل الشعب.
ليس موقفا ثوريا أن يصطف أحدنا وراء إحدى مؤسسات الدولة الشرعية بدون قيد أو شرط، فالقيد والشرط الأساسي بيننا وبين مؤسسة الدولة هو أن ترعى هذه الدولة مصالحنا وأمننا وتعمل وفق طموحنا لتحقيق مستويات حياة أفضل وأوسع (والدولة ليست هي الوطن، فالدولة إطار ومؤسسات ذات استقرار نسبي لكن يمكن تغييرها، أما الوطن فهو انتماء مادي ومعنوي وهو الفضاء الذي تجري فيه ديناميات الاستقرار والتغيّر هذه كلها؛ فالانتماء للوطن مع مقاومة الدولة ممكن). والثوريون والثوار، حين يثورون، فهم يثورون في الأصل على سلطات الدولة القائمة كلها من اجل تغييرها تغييرا أساسيا يعيدها لمسار طموحاتهم، فإذا كان الثوريون يثورون على سلطات الدولة كلها، هل فجأة سيصطفون وراء إحدى مؤسساته فحسب – القوات المسلحة – بدون قيد أو شرط؟ وكذلك فالذاكرة الانتقائية ليست ذاكرة ثورية، لأن تحليلها للواقع ناقص بسبب انتقائيتها. لا يمكن أن ننسى، بين ليلة وضحاها، أن معظم عساكر القوات المسلحة أطاعوا قيادتها حين أمروهم بالتنكيل بالثوار حين قالوا “الجنجويد ينحل”، كما أطاعوهم عندما أمروهم بأن يفعلوا في قرى ومدن السودان في المناطق المهمشة قريبا مما فعل الجنجويد في الخرطوم مؤخرا (الأمر الذي جعل هنالك مشروعية واضحة في قيام حركات مسلحة ذات قضية ضد سلطة الدولة وضد قواتها؛ وهنا من الواضح أن شتان بين الحركات المسلحة صاحبة القضية وبين مليشيا الدعم السريع، إذ من خطل الرأي الذي يدور مؤخرا مقارنة الدعم السريع بالحركات المسلحة، بينما الدعم السريع مليشيا أسستها سلطة الدولة للتنكيل بمجموعات المواطنين التي ظلمتها الدولة ابتداء ثم نقمت عليها لاحتضانها لحركات مقاومة مسلحة تقاوم ذلك الظلم، وبينما قوات الدعم السريع قاموا تحت رعاية الدولة وتغافل منها على جرائمهم وبينما لم تكن لديهم يوما قضية عادلة أو عقيدة وطنية إنما كانوا وما زالوا نكالا لأهل القضايا العادلة والحس الوطني المعقول). الموقف الثوري الذي قام مطالبا بتغيير شامل في طريقة عمل مؤسسات الدولة وتشكيل سلطتها، بالضرورة سيحمل موقفا يتطلب تغييرا شاملا في مؤسسات الدولة المستعملة لقمع الشعب بدل أن تُستعمل لحمايته ولتنفيذ إرادته، ألا وهي القوات النظامية (بشتى فروعها). كذلك، فالموقف الثوري في هذه الظروف مدرك لأن الطرف الغالب في الحرب (حتى لو غلبة نسبية) لن يكون لطيفا مع الذين لم “يقفوا معه” وقوفا غير مشروط في الحرب. بينما نطالب ونطمح من الجيش أن يقوم بقيادة مهمة التخلص من مليشيا الجنجويد المعتدية على الشعب والدولة (وهي مهمة من صميم مهامه الحقيقية كجيش) لا نتوقع أنه سيكون لطيفا مع الذين لم يقدموا له الولاء غير المشروط أثناء الحرب (بيد أن هنالك احتمالات قد تخفف من غلوائه)، لكن ليس في هذا جديد لدى أهل الموقف الثوري، فالجيش إجمالا لم يكن يوما لطيفا معهم، وهذا التوقّع المستقبلي لا ينبغي أن يؤثر على المواقف الحالية (بل ربما يلتفت قادة الجيش لاحقا، وبصورة انتقامية، لإحدى أكبر التجسيدات الإيجابية للثورة في السنوات الماضية، وهي لجان المقاومة؛ ولنا في تجربة لجان الأحياء في هايتي، في التسعينات، عبرة)، فالموقف الثوري إذن يقول وسيظل يقول بأنه لا بد من إحداث تغييرات هيكلية في القوات المسلحة (والقوات النظامية إجمالا)، طال الزمن أم قصُر.
[ولنلاحظ هنا ملاحظة مهمة، وليست عابرة، أن القوات المسلحة ما زالت حتى الآن تحت إمرة الضابط الذي ربما لعب الدور الأكبر بعد عمر البشير (أو ربما أكثر منه) في تقوية وتعزيز وتمدد قوات الدعم السريع، وهذا تناقض سافر لا يمكن استسهاله، فوجود هذا الضابط في هرم قيادة القوات المسلحة حتى الآن خطر على القوات المسلحة نفسها، دعك من الشعب، لكن المشكل الهيكلي المتجذر في القوات المسلحة يجعلها تقبل بهذا الوضع بكل ما فيه من تهديد وإهانة لها].
ما الذي يحصل من تقديم تأييد غير مشروط للقوات المسلحة، في الظروف الحالية، بينما أنت طرف غير مسلح وغير متحالف مباشرة مع أي من الطرفين بحيث يقدّرون قيمتك كحليف (بل متى أثبتوا أنهم يعيرون أهمية حقيقية لأي قوى مدنية وطنية تعاملت معهم باعتراف وقبول)؟ الذي يحصل هو أنك تضع نفسك في مكان أن تصبح بوقا إعلاميا غير مدفوع الأجر في ترسانة الجيش بينما لن تستطيع أن توازن بين هذا الدور وبين أدوار أخرى، بينما أنت أولى بتلك الأدوار الأخرى وهي أولى بك، في هذه الظروف الكالحة–تلك الأدوار هي الاستمرار في الاستثمار في تقوية القوة الشعبية، تنظيما وفكرا، وإبراز صوتها ومنطقها، وهي صاحبة الحق الأصيل في السلطة وصاحبة المظلمة الأكبر من هذه الحرب.
[ومن ناحية أخرى، فربما يجد المرء بعض العذر، مؤخرا، لمقدمي المرافعات الكبيرة في صالح القوات المسلحة، ذلك إذ أن الحراك السياسي في السودان، ومنعطفاته، أخرج لنا في الأشهر الأخيرة شخصيات وفئات سياسية عجيبة جدا، فهؤلاء تماهوا في مواقفهم وخطابهم مع مصلحة الدعم السريع بصورة مثيرة للعجب، وبصورة تجعل المرء يشك في حيازتهم على الحد الأدنى من شروط الذكاء والثبات السياسي كيما يتصدروا الشأن العام. مع ظهور هؤلاء، يصعب على المرء أحيانا أن لا يعذر مقدمي خطاب التأييد الشامل للجيش. كما يجد لهم بعض العذر أيضا – وليس كله – أمام تكاثر الخطاب الذي يبني جميع مواقفه ورؤاه حول ما هو نقيض للكيزان في تصوره، فكأنما لا يفكر هذا الخطاب باستقلالية وإنما ينتظر أن يعرف أين يتجه الكيزان كيما يتجه في الاتجاه الآخر، فهذا خطاب يقوده الكيزان فعليا لأنهم أهل المبادرة فيه. وعموما يالها من محنة أخرى من محن الشعب السوداني، حيث أن معظم “الأعلام والأقلام اليوم عند غير أهلها”، كما قيل في تاريخنا الحديث].
أحيانا، وفي المنعطفات الصعبة جدا من تاريخ الشعوب، قد تكون هنالك خيارات توصف بأنها “مثالية جدا” أو “غير عملية” بينما هي في الواقع عملية جدا، ونموذجية، وذات استثمار ثمين في أن لا تجعل تضحيات الشعوب ودمائها تهراق في غير طائل. مثلا: في خضم الثورة في 2019، عندما جنح البعض لمفاوضة المجلس العسكري ومشاركتهم السلطة، بحجة حقن الدماء وتقليل تكلفة الثورة على الشعب، كان وسطنا من قال إن هذا الخيار انحراف للثورة وأنه سيؤدي لزيادة التكلفة وإهراق الدماء وليس العكس، ووقتها كان من يقول هذا القول يوصف بأنه غير عملي وأنه مثالي جدا، ثم بعد أربع سنوات من ذلك التاريخ شاهدنا ونشاهد بأعيننا حجم التكلفة التي خفناها من انحراف الثورة (وقد يحاجج البعض هنا بأن المفاوضة مع المجلس العسكري نفسها لم تكن هي سبب الحرب ولا سبب الانتهاكات التي جرت في الفترة الانتقالية وفترة الانقلاب عليها، ولهؤلاء نقول إن تراكمات آثار تلك المفاوضات، والتي شرعنت لتحرك وتمدد عناصر المجلس العسكري في الحياة العامة وفي مفاصل الدولة، ذات علاقة واضحة بما يحصل الآن، ومن مؤشرات ذلك أن الدعم السريع تضخم عسكريا واقتصاديا وسياسيا في الفترة الانتقالية بأكثر من تضخمه أثناء حكم الكيزان). أيضا، وفي بدايات حرب أبريل هذه، كان بعض الناس يقولون إن الجيش بإمكانه أن يحسم هذه الحرب في فترة وجيزة ونتخلص من كابوس الدعم السريع إلى الأبد، بينما كان بعضنا يقول إن هذا احتمال ضعيف الورود وأن الاحتمال الأرجح أن الحرب ستستمر لفترة غير قصيرة وسيدفع المدنيون والثوار ثمنها عاليا، وقد كان. هل نحن بحاجة لتجارب إضافية لنستبين مدى خطورة تطفيف الحلول بعيدة الأمد توقا لما نحسبه حلا عاجلا؟
الحل العاجل، أو الذي يبدو عاجلا، قد يكون أحيانا مغريا، لأنه مباشر وواضح، بينما نحن أمام مشكلة كثيرة التعقيد، عالية الأهمية، ومتمددة في التاريخ والجغرافيا بصورة تتورع معها العقول الحكيمة عن تقديم وصفات تدّعي أنها جاهزة وناجزة. ومن مغريات الحل العاجل أنه يرافع عن نفسه بأنه هو المطلوب الآن بينما يمكن النظر لاحقا في الحلول الآجلة. لكن أي حل عاجل إن لم يكن من جنس الحل الآجل فهو خصم على الآجل، وتكلفته تفقد تبريرها مع الزمن، وهذا هو سبب تورع المتورعين. نعم، هنالك حلول عاجلة وحلول آجلة، لكن ينبغي أن يكونوا متجانسين، وفق رؤية لا بد أن تكون بعيدة الأمد وإلا فهي قاصرة. ثم بعد أن تكون لدينا قائمة معقولة من الحلول العاجلة والآجلة، تتوزّع الأدوار (الفكرية والتنظيمية والاجتماعية والسياسية) بين من يشتغل على العاجل وبين من يعمل على أن لا ننحرف عن مسار الآجل.
بقي أن نقول إن المشوار ما زال طويلا أمام الشعب السوداني، للأسف. هذا الشعب الذي بذل الكثير، وما زال يبذل، في سبيل تحقيق اختراق إنساني (اجتماعي-سياسي-اقتصادي، ثقافي، وأخلاقي) هو بحاجة له بالأصالة، وكل المنطقة بحاجة له بالحوالة (إذ أن السودان لو وفّر نموذجا لهذا الاختراق فذلك سيحرّك بقية المنطقة). هذه الحرب ليست آخر المشوار، للأسف. سيعقب الحرب الكثير أيضا، لدرجة أن السيناريو الأخف وطأة – وهو سيناريو التخلص من الدعم السريع للأبد عبر هذه الحرب – حتى لو تحقق فسيتبقى منه طريق مرهق ومؤلم ومليء بالاحتقانات والشكوك الداخلية، سواء استعددنا له جيدا أم لم نستعد؛ والأفضل أن نستعد. ويبقى هنالك أمل، ضعيف، كسير، في الزاوية هنالك، أن تدركنا معجزة لا نعرف وجهها اليوم….
لا يجمعها قولٌ ولا يعزّيها أمل:
أكان بالإمكان تلافي هذه الحرب؟
(منشور بتاريخ 22 يونيو 2023)
رغم اشتهاره كاسم كبير في ما يسمى “دراسات السلام” (وأحيانا يوصف بأنه مؤسس هذا الفرع من الدراسات الاجتماعية)، إلا أن ليوهان غالتونق (Johan Galtung) كتابات أخرى، قديمة، مهمة ومؤثرة في مجالات التنمية. من أهم كتاباته – والتي تعرفت عليه عبرها – دراسة نشرها في 1979 من دار نشر الأمم المتحدة، جراء تكليف من سكرتارية الأونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية)، بعنوان “التنمية والبيئة والتكنولوجيا: نحو تكنولوجيا من أجل الاعتماد الذاتي”. الدراسة ذات بُعد فلسفي واستراتيجي بخصوص دور التكنولوجيا في التنمية (وقد استعانت بها دراسات لاحقة حول نفس الموضوع).
في إحدى الفقرات اللطيفة في دراسته تلك، يتحدث غالتونق عن أحد الفوارق اللافتة للنظر بين مهندسي (وفنّيي) التصميم ومهندسي الصيانة، في علاقتهم مع التكنولوجيا: فمهندسو التصميم لديهم مساحة من ابتكار الحلول الجديدة لمشاكل وتعقيدات ماثلة، أي لديهم فرصة للإضفاء الفكري وإعمال الخيال في عملهم، وهم عندما يقدمون تصميما متميّزا فإنهم ربما يلقون رصيدا من الإشادة بالعمل والعائد الرمزي/المعنوي، إضافة لشيء من التخليد في إهاب التكنولوجيا الجديدة التي ربما تنتشر وهي تحمل بصماتهم. أما مهندسو الصيانة، فرغم أنهم مهمون بنفس القدر لفعالية الهياكل والعمليات الهندسية، إلا أنهم لا تتوفر لهم نفس تلك المساحة الابتكارية المذكورة آنفا، كما أنهم لا يُذكَرون كثيرا إلا في حالات المشاكل أو في حالة أن بعضهم لم يؤد دوره جيدا. كذلك، فعمل الصيانة أكثر رتابة إذا ما قورِن بالتصميم، لكنه في الواقع عمل الأغلبية من المهندسين والفنيّين، ولأسباب مفهومة، فالهياكل والعمليات الهندسية القائمة، في أي مجتمع حديث، أهي إجمالا أكثر من الابتكارات والحلول التكنولوجية الجديدة فيه، في أي فترة زمنية. لذلك ففي أي أوضاع عامة، مستقرة نوعا ما، سنجد أن أغلبية المحترفين هؤلاء لهم علاقة رتيبة ومتوقعة عموما مع التكنولوجيا في المجتمع. هذا ليس أمرا إيجابيا أو سلبيا بالضرورة، إنما يعتمد على السياق.
ثم تأتي تفاصيل أكثر، يسمح بها النقاش، منها مثلا أن مهندس التصميم يمكنه أن يقلل من مشاكل الصيانة لاحقا، عبر تصميم أفضل وأكثر إحكاما واعتبارا للمشاكل المتوقعة مستقبلا. كما أن مهندس الصيانة يمكنه أن يكتشف مشاكل ذات اعتبار في تصميم التكنولوجيا نفسه عبر التعامل المستمر مع مشاكل تلك التكنولوجيا (أكثر من تعامل مهندس التصميم معها)، بما يستدعي ويحفّز التفكير في حلول تكنولوجية جديدة. لذلك فلا بد أن يكون هنالك خط تواصل باتجاهين بين أهل التصميم وأهل الصيانة، يحيث يغذي كلاهما عمل الآخر–خاصة وأنه بالإمكان أن يتحوّل أحدهما إلى منطقة الآخر، في أي وقت وأي ظرف.
——–
المقدمة أعلاه كانت مهمة، لنقول إن وضع السودان، في مستهل الحراك الثوري الموسوم بديسمبر 2018، يشبه حصول ظرف استثنائي، تتداخل فيه الدوائر بين التصميم والصيانة. الدولة السودانية، والترتيبات السياسية-اقتصادية فيها، بلغت حالة حرجة جدا، رأى الكثير أنها تتطلب مراجعات هيكلية وحلولا جديدة، أي ثورة، بينما كانت هنالك قوى مقتنعة ومتحركة في اتجاه أننا بحاجة إلى مراجعات استراتيجية وبعض الترتيبات السياسية الأفضل، أي إصلاح. لنقل إن الثورة صنو التصميم، والإصلاح صنو الصيانة.
من الواضح أن القوى السياسية، المدنية، التي اختارت طريق الصيانة، استطاعت ركوب موجة الثورة وتقديم نفسها كممثلة لها، ثم ترتيب أجندتها السياسية ومساعيها التفاوضية ناحية الصيانة. اللطيف طبعا أنهم كانوا يقولون ويكررون إن هذا هو مطلب الثورة نفسه. على العموم، حاليا نسمع أصواتا منهم يقولون إنهم كانوا حتى آخر لحظة يحاولون تفادي هذه الحرب، بكل ما أوتوا من أدوات سياسية عقلانية، لأنهم كانوا واثقين من حدوث الحرب إذا لم ينجحوا في العمل السياسي (يقصدون العمل وفق طريقتهم في السياسة).
من ناحيتنا، وعبر كتابات متواصلة، منذ بدايات 2019 وحتى مؤخرا، يمكن أن نقول، باختصار: نعم، كانت هنالك فرصة لتلافي هذه الحرب، لكن ليس بطريقة السياسيين الإصلاحيين. كانت الفرصة متوفّرة في مرحلة القدرة على اختيار المضي في طريق التصميم، أو إعادة بناء الدولة السودانية، وهذا الطريق حانت فرصته الكبيرة مع أولى الانتصارات الكبيرة للحراك الثوري، في أبريل 2019، ثم بدأ باب الفرصة يتزحزح نحو الانغلاق مجددا مع كل خطوة من خطوات المضي في طريق الإصلاح (الصيانة)، حتى أُغلِق مع انقلاب 25 أكتوبر 2021، أما ما كان بعد ذلك التاريخ فلا يعدو أن يكون تحصيل حاصل. ضاعت فرصة تفادي الحرب – أو تحجيمها لدرجة كبيرة أو تغيير قواعدها – عندما ظنت القوى السياسية أن هنالك ثمار مستدامة تُرجى من مشاركة المجلس العسكري الانقلابي في السلطة الانتقالية، وأنه ليست هنالك فرصة أخرى للثورة كيما تتقدم بدون هذه المشاركة؛ أي فسّروا انقطاع نَفَسهم هم بأنه انقطاع لنَفَس الحراك الثوري نفسه، وعلّلوا ضيق أفقهم وخيالهم، وضيق مساحة الابتكار عندهم، بأنه معادل لأفق وخيال الحراك الثوري، بينما لم يكن الأمر كذلك. لم يكن الأفق والخيال الثوري بهذا الضيق، إنما ذلك الضيق متعلق بهم هم – السياسيين – فحسب. جلبوا للجماهير الثائرة نصف ثورة، ثم اجتهدوا كثيرا في بيعها لهم على أنها ثورة ناضجة، كاملة، مكمّلة، وتمضي في طريق الظفر، تحت قيادتهم.
لا ننسى أن نفس القوى السياسية التي تتحدث اليوم عن أنهم كانوا يحاولون تجنب الحرب هذه حتى آخر لحظة، عبر ما سُمّي بالاتفاق الإطاري، كانت تدافع بقوة عن الشراكة العجيبة في السلطة الانتقالية، ووفّرت خدمات إعلامية مجانية للعسكر وللدعم السريع (وللدعم السريع، أو الجنجويد، بالذات، لأن هذا كان الأكثر احتياجا لتلك الخدمات)، بل وفّرت للدعم السريع المساحة السياسية التي تمددت فيها قوتهم ونفوذهم في الفترة الانتقالية (وساهمت معهم في توفير تلك المساحة قيادة القوات المسلحة، بصورة واضحة وبأدوات قانونية وإعلامية واقتصادية، لا يمكن تطفيفها أو نسيانها). اليوم يتحدثون بلسان أنهم كانوا يرون العاصفة قادمة منذ البداية وحاولوا تجنبها، وهذا لا يستقيم. نحن لا نريد ان نذكّر الناس بهذا الأمر لمجرد التذكير، بل لأنه يوضّح إشكالية التفكير والقرار الأساسية لدى القوى السياسية هذه، وهي نفس الإشكالية التي تجعلها حتى الآن عاجزة عن فهم الواقع بما يكفي من الحكمة أو اتخاذ قرارات شجاعة بما يكفي (ومن العجب أنهم يصفون مواقفهم تلك بأنها هي الحكمة وهي الشجاعة).
تم ترويج الشراكة الانتقالية على أنها حقن للدماء، فما لبث أن استمر إرهاق دماء المدنيين، على عدة مراحل وعبر عدة أحداث ومحطات وحشية، في ظل الشراكة الانتقالية، وبعض فضها (بفظاظة) وبواسطة سلطات مشرعنة، واستمر إرهاق دماء المدنيين وانتهاكهم حتى وصلت الأمور لما وصلت له الآن، وفي كل مرحلة كانت تلك القوى السياسية تقدم المزيد من التنازلات تحت مسمى الحكمة والشجاعة، فهل لا ينبغي لنا بعد أن نتساءل حول جدوى ما فعلته تلك القوى من تقديم كل التنازلات غير الثورية، نيابة عن الحراك الثوري، في كل مرحلة من مراحل انحدار الثورة إلى نصف ثورة، ثم إلى انتكاس الأوضاع وانعكاسها تقريبا الآن؟
الحديث هذا عن السياسيين السودانيين، أو القوى السياسية السودانية التقليدية، المدنية، التي هيمنت على المشهد السياسي في السنوات الأخيرة. ليس في هذا الحديث تخوين أو تنابز، إنما إشارة واضحة ومباشرة لقصور القامات السياسية (الفكرية والتنظيمية) لتلك القوى، خاصة قياداتها؛ قصورٌ كلّف الشعب كثيرا (خاصة وأنه شعب يستحق قامات أفضل من هذه بكثير، كما أظهر في حراكه الثوري). هذه القوى السياسية اتضح أنها لا تزيد كثيرا الآن على لافتات وظلال من الماضي، لا يجمعها قولٌ ولا يعزّيها أمل.
مع اتضاح، وانفضاح، خط الإصلاح والصيانة، في فشله المجلجل في الاستعداد للسيناريوهات الكالحة، وفي التصدي لها، رغم ترويجه لنفسه دوما أنه الخيار الوحيد لتفاديها أو الخروج منها، يصبح من الحكمة والشجاعة الآن أن نلجم هذا الخط (وهو ما زال يصر على الاستمرار في ادعاءاته بأن المخرج والملاذ عنده)، ونعود بقناعة أكبر إلى خط الثورة وإعادة بناء الدولة السودانية؛ إعادة تصميمها. على العموم، لا يمكن بحال من الأحوال العودة بعد الآن إلى سودان ما قبل هذه الحرب، لكن هذا لا يعني أننا سنتحرك مباشرة نحو سودان جديد، فكما قال قرامشي: “القديم يحتضر، والجديد لم يولد بعد” ثم أتبع ذلك بقوله أن ما بين الاثنين “عصر الوحوش”. لكي نتحاشى عصر الوحوش، علينا الإسراع في ميلاد الجديد…. وللحديث شجون.
مأساة القوى السياسية المدنية
(منشور بتاريخ 3 أكتوبر 2023)
لا تشغلني البتة محاولات ربط الحرب الأخيرة بمؤامرات شاركت فيها قوى لا تحمل السلاح في السودان. وبالأخص، ما أراه أن أي محاولة لتصوير قوى الحرية والتغيير (قحت) باعتبارها انحازت لطرف من الأطراف المعتركة من قبل بداية الحرب، هي محاولة بائسة.
هذه الحرب ليست في مصلحة قحت، من أي زاوية أتيتها، فمع دوي السلاح تخفت أصوات أي قوى غير حاملة له، وإنما الحرب من مصلحة فاعلين سياسيين آخرين ساعدهم ضعف قحت وتراخيها عن لعب دورها المطلوب منها. لكن الأهم من ذلك أن محركات هذه الحرب أكبر من قدرات قحت ومن استيعابها. قحت ضعيفة لأنها فرّطت في المتطلبات الفكرية والتنظيمية للعمل السياسي المدني الجاد. حتى الآن لم يبرز لنا من بين أدبيات قحت – أو المتوائمين معها – تحليلا للواقع السوداني بمستوى عميق ومتعوب عليه، بلهَ أن يكون صحيحا. قحت ما فتئت تتحدث عن المنعطفات الصعبة التي مرّت بها البلاد منذ حراك ديسمبر 2018 بطريقة أن الأمور كانت دائما تجري على ما يرام قبل أن تحصل مفاجأة ما، مصدرها حدث أو شخص غير محسوب ولولاه لكانت مساعيهم وتخطيطاتهم الذكية والاستراتيجية ماضية بشكل جيد. قحت تحلل محركات السياسة السودانية الكبيرة بالأحداث وبالأشخاص المباغتين للمشهد العام، كما تقول للجماهير إن ما يقال أو يتقرر في اجتماعات غير مسجلة وغير ملزمة رسميا يعتبر خطوات وإنجازات؛ كما يطيب لها نسب تعقيدات المشهد إلى جهات يسهل الإشارة لها وتكرار اسمها بدل الانخراط في فهم وتحليل واقع معقّد ومشتبك وذي جذور تاريخية متراكمة مثل واقع السودان. قحت لا يبدو أنها تدرك أن ليست هنالك حروب كبيرة تُقدَح بين ليلة وضحاها، بسبب كلمتين أو ثلاثة أو خلافات بين نفر لا يتجاوز أصابع اليد (فمجرد أن هؤلاء النفر القليل لديهم القدرة على زعزعة دولة كاملة في فترة زمنية وجيزة يعود لأسباب متراكمة لفترة وتستدعي نظرة فاحصة ومتعمقة للوضع العام). قحت تتعامل مع الإعلام العام وكأنها تدخل في انتخابات غدا ولا تريد أن تعترف بأخطاء سياسية حقيقية أمام الشاشة والناخبين، بينما نحن في أوضاع ثورة وإعادة بناء دولة.
ثم إن قحت، كغيرها من مجمل القوى السياسية المدنية في السودان (إلا من رحم ربي)، وبسبب تنازلات متتالية وضيقة النظر منذ مفاوضات بداية الفترة الانتقالية وأثناء الفترة الانتقالية، أصبحت فاقدة لأي قوة ضغط كبيرة على أصحاب الترسانة المسلحة في مركز الدولة (وهم ليسوا جهة واحدة، للأسف – أي أصحاب السلاح – وهذا الوضع من أكبر تجليات تعقيد الأمور وحاجتها لنظرة فاحصة). معنى ذلك أن قحت – رغم كل ما تدعيه عن نفسها وعن تحريكها للعملية السياسية – لم تعد لديها مراكز قوة وضغط تطبقها على أصحاب الترسانات المسلحة كيما تحصل تغييرات ملموسة على أرض واقع السلطة والقرار في السودان. ثم هي حاولت تغطية عجزها ذلك بالاتكاء على من سمّتهم بالقوى الخارجية التي تستطيع الضغط على المسلحين، في سذاجة متراكمة جعلت تلك القوى الخارجية أقرب لاستعمال قحت لمآربها بدل العكس. ذلك تخبط مردّه أنهم أنفقوا ما لديهم من رأسمال سياسي (أو مقدرات الضغط) مبكرا، بل يمكن أن نقول إنهم لم يقدّروا حجم رأسمالهم السياسي (أي السند الشعبي الثوري) تقديرا صحيحا إلى أن فقدوه. ولا يغرّن أحد تكاثر الاجتماعات، وتضاعف السفرات واللقاءات مع “المسؤولين” في الخارج. هذه ليست معايير ناضجة لمستوى الفعل السياسي والتأثير السياسي في المجال العام وفي الأحداث الكبيرة. لدينا في السودان قوى سياسية مدنية لم تعِ يوما مصدر قوتها، ولذلك فرّطت فيه كذا مرة، حتى عندما أتاها كهديّة من نوادر هدايا التاريخ – مثل حراك ديسمبر 2018 ومثل حراك يونيو 2019 ومثل الهبة الشعبية الضخمة ضد انقلاب 25 اكتوبر، ومثل الموقف الثوري الجماهيري الكبير ضد الشراكة مع المجلس العسكري في ابريل ومايو 2019 – ثم بقيت تلك القوى السياسية المدنية تحوم في المجال العام وهي ضعيفة، منكسرة، تظن أنها بكثرة اللقاءات والتصريحات تخفي ضعفها ذلك، وما هو بخافٍ عن المتربصين لها من الفاعلين السياسيين الآخرين في البلاد (ومن خارجها). لا توجد في الميدان العام اجتماعات “عالية المستوى” تكفي لتغطية الهزال الفكري والتنظيمي…. ومنذ أيام نظام الكيزان كان بعض المتأملين في المشهد يشيرون إلى أن نظام الكيزان ليس قويا فعلا، إذا قسنا درجات القوة تلك مع الأنظمة الشمولية الأخرى التي نعرفها في العصر الحديث، لكن طال عمر الكيزان في الحكم، رغم تخبطهم وتشاكسهم وضعف حوكمتهم، لأن المعارضة السياسية لهم ضعيفة تنظيما وفكرا.
قحت اختارت لنفسها أن تكون مجموعة من الساسة (politicians) فحسب، بدون أن يكون لديها رصيد ملموس من أهل صنعة الدولة (statecraft). [في كتابات سابقة ذكرنا معالم التمييز بين السياسي وبين رجل الدولة]. وكساسة، فهم بالدرجة الأولى مقاولو قوى (power brokers). لكن تخيّلوا مقاول منشآت لا يملك مواردا لتحريك مواد البناء، كما أنه خسر مجمل علاقات العمل التي تجعله مفيدا للربط بين أصحاب المشاريع الإنشائية وأصحاب مواد البناء. مأزق هذا المقاول هو نفسه مأزق قحت الحالي.
لذلك، فالتآمر الاستراتيجي، أو الخداع المخطط للإعلام، ليس من صفات قحت، إذ كما قال الرابر “إمورتال تكنيك” عن كونه لا يرى أن جورج بوش الابن كان له أي دور في أحداث 11 سبتمبر 2001 (حسب بعض نظريات المؤامرة):
And I don’t think Bush did it
Because he isn’t that smart
ولا أعتقد أن بوش فعلها
إذ تعوزه الحنكة الكافية
وهذا يقال مع صرف النظر عن كوننا نبتعد، وسنظل نبتعد ما استطعنا، عن اتهامات سوء الظن في مجمل القيادات السياسية المدنية، أي سوء الظن في نواياها وفي دوافعها الواضحة بالنسبة لها. بجانب أننا لا نرى أدلة على سوء الطوية – بل أحيانا نجد أدلة أكثر على حسن النوايا وحسن القصد – كذلك نرى أن إساءة الظن في تلك القيادات لا يجدي شيئا، للأسباب المذكورة آنفا. قياداتنا السياسية المدنية مشكلتها الأولى أنها “مسكينة”، بصورة عامة، فكرا وتنظيما، وتتحرك وهي فاقدة للرؤية وللمنهج، فاقدة لمشروع حقيقي (ولست أقصد هنا موضة “المشروع الوطني” التي راجت لفترة، بدون معالم أو نكهة)، وتعتقد أن بعض التلاتيق التي لديها من الشعارات والمصطلحات وكلام الاجتماعات يسمى فكرا سياسيا. ثم هي لا تعدم من يزيّن لها فعلها وقولها من أصحاب الأقلام (والذين بدورهم كثيرا ما يكتبون أكثر مما يقرأون). الشعب سعى ويسعى لإنقاذ نفسه بنفسه – وسوف يفعلها، رغم تكالب الخسائر والآلام – أما قحت فتحتاج لمن ينقذها من نفسها.
لذلك فقحت إجمالا بريئة، في نظري، من أي ملابسات مساهمة واعية في سوق البلاد إلى ما آلت إليه. بيد أن هذه البراءة ليست كلها مما يتمناه المرء للقيادات السياسية في بلاده، لأنها براءة زائدة عن الحد–براءة كبراءة أهل القرى الافريقية من المشاركة الواعية في إضرار البيئة الطبيعية وإضرار رئات أطفالهم، بسبب استخدامهم الكثيف لخشب الغابات كوقود للطبخ لأنه أرخص وأقرب ويحل مشاكل اليوم باليوم…. براءة على مستوى النوايا وقصور إدراك الأبعاد؛ براءة تتوفر فيها حسن النية كما تتوفر فيها السذاجة التي لا يليق تمجيدها والجهل الذي لا يُمدَح، وإنما ينبغي التنبيه له وتغييره، خاصة عندما يأتي من متعلمين وممن يفترض أنهم قادة الرأي في البلاد (بخلاف أهل القرى الافريقية، المُبعَدين عن أدوات الفهم ودواعي التأثير العام).
لكن، بوصفنا مدنيين، فنحن ما زال لدينا استثمار في قحت، وما زلنا غير راغبين في أن نخسر علاقاتنا معها – وإن ظنّ بعضهم عكس ذلك – وما زلنا نريد لها أن تنهض مما هي فيه وتواجه مجالها بالجدية المطلوبة، وتعود لاستدراك رأسمالها في القواعد الجماهيرية، لأن كل ذلك في مصلحتنا كمدنيين، على المدى القريب وعلى المدى البعيد. لا يمنعنا إحباطنا من قحت حتى الآن أن نتذكّر أننا نشترك في مصلحة أن يسود المناخ الذي يقوّي من فاعلية وقرار المدنيين في الدولة ويحصّنها من تغوّل ذوي العسكرة في ما لا شأن لهم فيه ولا يحسنونه–وهو بناء الدولة التنموية الديمقراطية.
بيد أننا أيضا نذكّر قحت، ونذكّر أنفسنا، أن ليس بيننا (من المدنيين) من هو غير قابل للاستبدال–أفرادا أو تنظيمات. مسيرة الشعب قادرة ولو بعد حين على استبدال من لا يلعب دوره التاريخي جيدا. إذا لم تعد قحت لتقوية قواعدها الشعبية قبل فوات الأوان – وكما قلنا فأحيانا فإن العمل في مستوى القواعد الشعبية في فترات الكوارث (مثل كارثتنا الحالية) يمكن أن يفعل فعل السحر في إعادة تقوية الدعم الشعبي للسياسيين المدنيين وإعادة التئام التنظيمات السياسية بحاضناتها الاجتماعية – فإن على قحت أن تتهيّأ للإزاحة، عاجلا أم آجلا، بواسطة تنظيمات سياسية جديدة (أو جديدة-قديمة)، نشأت وصعدت من القواعد الشعبية، المذكورة آنفا، وتكتسح التأثير السياسي المدني في الساحة. ما رأيناه في السنتين الأخيرتين من انزعاج قحت وأبواقها من لجان المقاومة، مثلا، جاء من كون الأخيرة أصبحت تشكّل منافسا سياسيا جديدا في الميدان الذي ظلت “تقدل” فيه قحت في السنوات البضع الماضية بدون منافسة كبيرة. نبشّر الجميع بأن التاريخ يقول إن مثل هؤلاء الفاعلين السياسيين الجدد قادرين على الالتحام بقواعد جماهيرية فقدت الثقة في الفاعلين القدامى–وقد رأينا بوادر ذلك عبر تشكّل تحالفات جديدة بين التجمعات العمالية وحركات الحكم المحلي والأجسام المطلبية ولجان المقاومة (وتنظيمات أخرى متباينة الأطياف). ربما لا يحصل اختراق جديد تماما منذ البدايات بالضرورة، لكن فرص التطور والتعلم بسرعة، واختيار الدروب غير المطروقة مسبقا، تكون أكبر مع مثل هذه التجديدات.
ومن المؤكد أن هنالك استثناءات من الوصف أعلاه، بين أهل الأعلام السياسية وبين أهل الأقلام (خاصة من داخل قحت)، وقد رأينا بعض أولئك الاستثناءات وتعاملنا معهم، لكن حتى أولئك الاستثناءات سرعان ما يتبلّدون فكريا وتنظيميا عندما تزيد حركتهم وسط السياسيين وتقل وسط القواعد الجماهيرية النشطة، فمن عاشر قوما [….]. “الأعلام والأقلام، اليوم، عند غير أهلها” عبارة تُنسب للأستاذ محمود محمد طه منذ 1967، وللأسف، ما أشبه “اليوم” بالبارحة، حتى الآن…. وللحديث شجون
دَوِي السلاح وصخب الساسة: الراهن والثورة في السودان
(منشور بتاريخ 22 أبريل 2023، بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل)
(1)
كوامي توري، أحد رموز النضال ضد الامبريالية في افريقيا وضد العنصرية في أمريكا، وأحد رموز الجيل الثاني من الحركة الافروعمومية، قال في بعض كتاباته ومحاضراته، في تسعينات القرن الماضي، إننا أصحاب مواقف ومبادئ، وبالتالي لدينا انحيازات، لكن ذلك لا يعني أن لا نقرأ التاريخ ونستنبط ديناميكاته بموضوعية. مثلا، من المؤكد أن الافروعموميين ضد النازية، قلبا وقالبا، لكن عندما نقرأ التاريخ نفهم أن ظهور هتلر ساهم في إضعاف القوى الاستعمارية الأوروبية عبر الحرب العالمية الثانية، وذلك هيّأ الأوضاع أكثر لحركات التحرر الوطني – في افريقيا وآسيا – كيما تضغط لنيل استقلال بلدانها، بالسياسة أحيانا وبالسلاح أحيانا؛ وبعد الحرب العالمية/الأوروبية الثانية تولّد مناخ عالمي أكثر قدرة على التعامل مع مطالب الاستقلال بانفتاح. وفق ذلك فإن صعود النازية في ألمانيا، وما تلى ذلك من تواصل وتراكم، خدم مآرب لحركات التحرر الوطني ولقضايا استقلال شعوب افريقيا وآسيا، بل وحتى قضايا الأقليات في جهات أخرى في العالم. هذه قراءة موضوعية، ثم من غير المنطقي أن تعني أن علينا أن نشكر هتلر أو ألمانيا النازية، أو نتخندق معها باعتبار “عدو عدوي هو حليفي”، أو نقول إن الجندي الألماني البسيط – الذي لا يُعتَبر مشاركا في مخططات هتلر وبطانته ولكنه ينفذ فحسب – استحق دعمنا المعنوي في حربه ضد فرنسا وبريطانيا لأن هؤلاء استعمرونا وآذونا أذية مباشرة (مع تذكر أن ألمانيا نفسها مارست التسلط والتجبر الاستعماري في مناطق حول العالم، كناميبيا)…. هذا تمييز لا ينبغي أن يفوت على أواسطنا في الوعي السياسي، أو كما قال بعض الكتَاب مؤخرا فإن الحرب بين الأشرار ربما تأتي ببعض النتائج الايجابية (وإن كانت مكلّفة) لغيرهم، لكن ذلك لا يعطي أي طرف في تلك الحرب فضيلةً تجعل أصحاب المبادئ والدوافع المختلفة، اختلافا جذريا، يركنون مواقفهم مؤقتا ويصطفون معه.
(2)
قراءة ما يجري في السودان الآن يحتاج لمقارنات تاريخية واسعة، ويحتاج كذلك للتمييز بين مستويات الباطل، كما جاء في حديث كثيرين، لكن بحذر. عبر النقاش والكتابة، في دوائر محدودة، ساهمنا كغيرنا في تناول المسائل المتعلقة بهذه الأحداث والتراكمات، واسترجعنا كغيرنا كتابات مستمرة منذ سنوات تتناول هذا الوضع وتعقيداته وسيناريوهاته المحتملة (مثل مقالة نشرناها في أواخر أغسطس 2019 تحدثنا فيها عن التناقضات الموروثة في بنية طرفي المجلس العسكري الانتقالي والتي قد تؤدي لانفجار داخلي في المكوّن العسكري نفسه). في تلك القراءة، هنالك عملية مستمرة من النظر الموضوعي للواقع والتاريخ، بأدوات فهم وتحليل وتركيب، تتضافر مع عملية من الاستثمار في أجندتنا في ذلك الواقع والتاريخ، فمن كانت أجندته ضيقة المصالح فذلك قد يظهر (ولو بعد حين) في خلاصاته ومواقفه، ومن كانت أجندته مرتبطة أو تحاول التماهي مع مصالح الشعوب وطموحاتها فذلك قد يظهر كذلك في خلاصاته ومواقفه؛ وبينما لا يكون الواقع الآني حَكَما مميّزا جيدا، فإن التاريخ حَكَمٌ أفضل وأوسع استقصاء.
النظرة الأوسع، والمنظور الديلكتيكي، لمثل هذه التراكمات التاريخية، فيهما متسع لما هو أعمق وأجدى من اختيار أحد خيارين لا ثالث لهما، أو توفير مظلة أخلاقية مفقودة لأي من المعسكرين. وفي تلك النظرة فرصة للاستثمار في ما هو أكثر بقاء واستدامة من نتائج صراعات مصالح ليس في أيهّا خير كبير يرجى قريبا، سوى ربما خير أن يُضعِف كلا الطرفين الآخر بتلك الصراعات، وأن يفتح ذلك الفرصة لاحتمالات أفضل وأعلى مشروعية.
(3)
مع كل قتامة الحاضر، ومرارة تراكمات الماضي، فإن سيناريوهات الخير المستقبلي للشعب تبقى قائمة، وتبقى مُلهِمة للاستمرار في العمل ونبذ اليأس. ما ينبغي أن يشغلنا الآن، كأولوية، هو (١) موقف السند الإنساني والتضامن العملي مع شعبنا المتضرر من سخائم الطرفين المتحاربين، و(٢) الاستمرار في جهود تقوية واستحصاد الثورة الشعبية، فكرا وتنظيما. الانشغال الأول فرضته تراكمات الواقع والتاريخ، والانشغال الثاني هو الخط الثوري الأصيل، الذي تلاطمته أمواج كثيرة في مسيرته، لكنه بقي صابرا، متناميا، متعلّما من الدروس ومتسلحا بالشكيمة.
(4)
في ظل أوضاع كهذه، يتكرر الحديث عن بعض البديهيات وكأنها خلاصات قوية وغائبة عن نظر الآخرين، مثل مقولة إنه كيما تكون لدينا دولة ديمقراطية لا بد أن تكون لدينا دولة في الأساس. هذه المقولة صحيحة بداهة (فما دمنا نتحدث عن ممارسة الديمقراطية في إطار/سياق الدولة العصرية فلا بد أن تكون لدينا دولة عصرية، مثلما أنك بحاجة لـ”زير” كشرط لأن يكون عندك “موية زير”) – مع العلم أن الديمقراطية عموما لا تشترط وجود الدولة حتما، إذ يمكن ممارستها على عدة مستويات وفي عدة سياقات وليس فقط في إطار الدولة – بيد أن هذه المقولة البديهية تُستَعمل كسهم منطقي يشير إلى صحة الحجة التي تقول إن الصراع القائم حاليا إنما هو بين طرفين أحدهما يمثل الدولة والثاني يمثل اللادولة أو الفوضى، وبالتالي فإن “الاصطفاف” وراء الطرف الذي يمثّل الدولة هو الموقف السليم (وبعضهم يقول إنه الموقف الوحيد “الوطني”، كمزايدة فوق ركام المزايدات).
عموما، سواءٌ أكُنّا من المعجبين بنموذج الدولة العصرية أم لا، فهو معطى من معطيات الواقع التاريخي، بمعنى أن أي مجتمع معاصر بحاجة لنظام دولة عصرية كيما يستفيد من ميزات العصر الحالي في الكوكب ويتقيّد بشروطه؛ وكما قلنا من قبل فحتى لو كانت لدينا مشاكل مع نموذج الدولة العصرية ونريد تجاوزه، فإن تجاوزه يمر بدرب استعماله جيدا حتى يستنفد غرضه، فهنالك شروط بنية تحتية وفوقية في المجتمعات الحديثة نحتاج لنموذج الدولة العصرية لتحقيقها، حتى تصبح مجتمعاتنا مؤهلة لمناقشة وتجريب نماذج أخرى (أحدث ربما، أو أفضل) من التنظيم الاجتماعي الحديث. لذلك فالدولة العصرية مهمة، ووضع اللادولة، أو تفكك الدولة، لا يخدم أهداف التنمية والتحرر والاستقرار لشعوبنا.
لكن السودان ليس مهددا بمرحلة تفكك الدولة، إلا ربما مجازا أو إمعانا، لأنه فعليا وصل تلك المرحلة مسبقا، والتحدي القائم الآن هو كيفية إعادة بناء الدولة وليس الحفاظ على الحد الأدنى منها، فنحن أصبحنا دون ذلك الحد الأدنى منذ فترة. في كتاب “ممكنات السودان” (2021، جوبا) تناولنا جانبا من شروط الدولة العصرية وكيف أن السودان حاليا لا يستوفي الحد الأدنى منها، ما يجعلنا نواجه الواقع بأن نقول إننا في مرحلة ما تحت الصفر من حيث مقاييس الدولة الكفؤة. ومن مشاكل إعادة بناء الدولة هو أن هنالك، ما تزال، بقايا مظاهر دولة، تجعل البعض يظن أن هنالك دولة، ومن ثم يتحدث عن “إصلاح” تلك المؤسسة أو تلك القوانين، من إجل إنقاذ الدولة، بينما الواقع يقول إننا تجاوزنا فرصة “الإصلاح” تلك وحاليا علينا التفكير في المراجعات الشاملة، في إعادة الهيكلة، في إعادة التعريف، وذلك يختلف عن مجرد الإصلاح، أو بعض التغييرات على مستويات الشكليات والمناصب القيادية والقواعد الإدارية.
لذلك، فإن ما يسمى بقوات الدعم السريع، أو مليشيا الدعم السريع، ليست تهددنا بأن تكون سببا في تفكك الدولة، إنما هي في الواقع نتيجة لتفكك الدولة، ومؤشر من مؤشرات فشل وغباء السلطات المتعاقبة على السودان، وشتان بين السبب والنتيجة.
(5)
من البراهين الواضحة على أن وجود الدعم السريع إنما هو نتيجة لتفكك الدولة السودانية وفشل سلطاتها، ومن المفارقات المحزنة في واقع الدولة-اللادولة السودانية، أن هذه القوات أو المليشيا، رغم وجودها المؤذي وغير المنطقي في الحاضر السوداني، إلا أنها ذات وجود قانوني وتُعتَبر قانونيا من مؤسسات الدولة ذات الاختصاص. الوصف الأقرب للدقة، بخصوص الدعم السريع، وفق تاريخه ونشأته، هو أنه (Paramilitary group) أو مجموعة موازية للجيش. وهو مجموعة موازية بصورة قانونية، ذلك لأنه تم إنشاؤه بواسطة سلطة دولة وتم تقنينه بموجب قانون دولة (أي قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017)، وتلقى في البداية تدريبا مباشرا من الجيش، ودعما مباشرا من سلطة الدولة، وضوءا أخضر ليحارب نيابة عن الجيش – أو بالأصح كوحدة من وحداته ذات استقلالية – في مواقع مختارة، وجُعِلت موارد تحت إمرة قيادته بموافقة الدولة (أي بموافقة سلطة الدولة) وعدم ممانعة لكي يمارس تعاقدات مع جهات خارجية.
[والجماعات الموازية للجيش تتضمن كذلك الجماعات المرتزقة، ومنها التي تمارس الارتزاق بصورة رسمية (مثل شركة بلاكْووتر الشهيرة)، ومن الجماعات الموازية للجيش كذلك التي تمارس الاقتتال المسلح خارج القوانين الرسمية ولكن وفق قضايا سياسية-اجتماعية مشروعة، كحركات المقاومة المسلحة ضد الأنظمة الغاشمة. لذلك فوصف “الجماعات الموازية للجيش” ليس بالدقة الكافية، لكنه يساعد في فهم حالة الدعم السريع.]
هذا من ناحية، وأما من حيث المجادلة بأنه فاقد المشروعية بسبب تاريخه الدموي ضد المواطنين، فذلك صحيح، لكن المشكلة أنه فيما يتعلق بالتاريخ الدموي وقهر الناس العزّل وتجاوز قواعد الحرب المتفق عليها، فالجيش السوداني له السبق في كل هذا، بل ربما تاريخ الجيش السوداني – كمؤسسة وطنية بالاسم فقط وتحتاج لمراجعة شاملة كيما تستحق هذا الوصف يوما ما – فيه إجمالا من رصيد الولوغ في دماء السودانيين وخرق القواعد الدولية والمحاذير الإنسانية ما هو أكبر من رصيد الدعم السريع. وفي الفترة منذ 2019 وقبل بضعة أيام، تضخم الدعم السريع كمَا ومقدارا، فتضاعف عدد المنتسبين له، وزادت قواعده في شتى أنحاء البلاد، وزادت ترسانته ومبانيه وأعماله وتدخلاته في شتى شؤون البلاد، وكل ذلك تحت مرأى ومسمع قيادة القوات المسلحة والحكومة الانتقالية، بل بمباركة واضحة منهما، (مع سماعنا لبعض التذمر وسط ضباط وجنود الجيش لكن لا نرى له أثرا على الواقع وإنما فقط نرى جبروتهم الموجّه نحو الجماهير عندما يأمرهم قادتهم بذلك)؛ فأين كان الانتباه لخطورة هذا الجسم الغريب ونموّه غير المفهوم طيلة هذه الفترة؟
الإجابة الشافية على هذا السؤال لن نجدها عند قيادة القوات المسلحة، ولن نجدها عند الجهات السياسية التي شاركت في السلطة الانتقالية، وبالتأكيد لن نجدها عند الساسة الذين توددوا للدعم السريع بذريعة البراغماتية السياسية، إنما سنجدها عند عناصر الثورة ذات الأصالة، وهم الذين رفعوا مسبقا شعار ومبدأ “الجنجويد ينحل” (كما رفعوا شعار ومبدأ “العسكر للثكنات”). وجود ما يسمى بالدعم السريع وجود غير منطقي وغير مستدام، ذلك لأنه قوة مسلحة أسِّست على الباطل، وعلى ما هو ضد قوام الدولة العصرية ومرجعية المواطنة. هذه هي المشكلة التي تقضي بأهمية زوال الدعم السريع. لكن لا يغيّر ذلك من حقيقة أن هذه القوة صنعة الدولة-اللادولة السودانية نفسها ونتيجة من نتائج فسادها وتفككها، أي نتيجة أخطاء وغفلة السلطات الغاشمة وضيقة الأفق التي حكمت السودان طيلة السنوات الماضية (ولا ننسى أن تسليح الجماعات الموازية للجيش ومنحها تصريحا لممارسة القتل والحرب داخل الدولة، لم تبدأه حكومة الكيزان الاولى، بل بدأ قبل ذلك، كما وثّق لذلك منصور خالد في كتابه “السودان: أهوال الحرب وطموحات السلام”،2003 ).
(6)
لا ينبغي أن نكون بحاجة للمجادلة بخصوص البديهة التي تقول إن مؤسسة القوات المسلحة جزء من تكوين الدولة العصرية (مع التفاوت في هياكلها وأحجامها ومدى اختصاصاتها، ومع إمكانيات تطويرها وتغيير جوانب فيها)، بينما ليست هنالك دولة كفؤة تحتاج لقوات موازية (خاصة لو حاولت الاستقلال عن سلطة الدولة). وفي حالة السودان، لا نحتاج أن نؤكد أن السودان لا يمكن أن يتقدم باصطحاب ما يسمى بالدعم السريع، وهذا أمرٌ متفق عليه بصورة واسعة وسط المهتمين بدراسة الشأن السوداني واستشراف مستقبل هذه البلاد؛ إنما نحتاج لأن نسأل أسئلة صعبة ومهمة: كيف نثق بالجهات التي شرعنت لوجود الدعم السريع، ولتضخمه، ولممارساته ضد المواطنين السودانيين وضد الأمن الوطني، في شتى أرجاء السودان، وصمتت طيلة هذه الفترة عن التهديد الخطير الذي يمثله، ثم فجأة صارت تقول ما قاله أهل الثورة مبكرا ولقوا جراءه القمع والقهر والإزاحة، وصارت تبدي العداوة تجاه نفس حليفها السابق فقط عندما ظهر تضارب المصالح السلطوية وليس التضارب مع مصلحة الشعب؟
نفس العقلية التي أنجبت الدعم السريع وجعلته يتوسع بهذه الطريقة، كيف لنا أن نظن، ببساطة، أنها ستحل (وتحسم) هذه المشكلة فقط لأن مصالح الجنرالات ومصالح قيادة الجنجويد أصبحت الان مصطدمة تماما، بينما لم تتغيّر أي عوامل أخرى كعقلياتهم وطموحاتهم وضمائرهم؟
مثل هذا السؤال يقودنا للحديث عن قلة الوعي التاريخي، وضعف الحدس الثوري، في محاولات نسيان أو تقليل خطورة أحد طرفي الصراع المسلح الجاري الآن ومحاولة التركيز على شيطنة الآخر فحسب (وكثير من صنّاع الرأي في السودان حاليا متورطين في هذا)، وكأن الفرق بينهما شاسع، بينما هو في الواقع فرق ضئيل جدا، خاصة في مستوى الأثر على حيوات المواطنين، ومستوى استسهال واسترخاص حقوق وحيوات الناس، الأمر الذي لم يظهر في الحرب الدموية التي طرأت مؤخرا فحسب وإنما عبر سنوات من قصف القرى في دارفور وترويع وامتهان الناس فيها وفي مناطق أخرى وعبر أربع سنوات من قتل وجرح المتظاهرين السلميين في مدن السودان بدون أي محاسبة. ومن ضعف الخيال الثوري أن يختار الناس بين اثنين من أهل المصالح المغايرة تماما لمصالحهم، فقط لظنهم أن أحد الطرفين أخف قسوة ودمارا من الآخر، وأن هنالك فرصة ما لأن يعود أحد أولئك الطرفين فجأة إلى رشده ويقدّم مصلحة البلد. ذلك بينما كل الأمواج الجدلية في هذا الشأن تنكسر عند صخرة الواقع الذي يقول، على لسان الكاتب الافروامريكي جيمس بولدون: “لا يمكنني تصديق ما تقوله، لأني أرى ما تفعله.”
I can’t believe what you say, because I see what you do
لا نحتاج في مثل هذه الأوقات للتذكير بأنه، في بعض الحالات التاريخية الاستثنائية، يضطر بعضنا لاختيار أخف الضررين، لغياب أي خيارات أخرى متوفرة. هذه ليست إحدى تلك الحالات الاستثنائية، لأن لدينا في هذا السياق، وهذا الزمان، قوى ثورية محلية كبيرة، تعمل وتستحصد منذ سنوات، وتنمو في وعيها وتنظيمها منذ سنوات، عبر مخاض عسير من الامتحانات الصعبة وإبراز الصمامة النادرة. هذا خيارٌ ثالث متوفر، على الأقل، لا يخيب من ينصره ولا يسعد من يخذله.
(7)
أما بالنسبة لموازين القوى، وما يمكن أن تُنبئنا بخصوص مآلات الحرب الجارية، فكون الجيش أكبر قوة عسكرية من “الدعامة” ربما يعطي سيناريو انتصار الجيش نسبة أعلى من غيرها، لكن لا يفيدنا بالضرورة بأن المعركة ستُحسم تماما لصالح الجيش، أي أن الأوضاع الأمنية والسياسية ستعود إلى سلطة موحدة ومستقرة (حتى لو كانت غير ديمقراطية أو حتى مشروعة). ذلك لأنه في حرب المدن وحرب العصابات، فإن القوة العسكرية الأصغر يمكنها استنزاف القوة الأكبر وتمديد فترة الحرب وزيادة الخسائر العامة، وإحداث الكثير من الزعازع، بدون أن تحصل غلبة مباشرة، الى ان يقود الأمر للمفاوضات أو تغيّرات في خارطة الانحيازات والتدخلات (محليا وعالميا) وأشياء كذلك. هذا سيناريو وارد على أي حال، إلا لو أثبت الجيش أن لديه خبرة كافية تجعله ينهي الحرب قبل حدوث كل ذلك (فهذا الجيش على أي حال لم يستطع حسم حربه مع حركات مسلحة أخرى أقل حجما وعتادا من الدعم السريع، وعلى مدى سنوات، بل إن فشله ذلك كان أحد مبررات إنشاء الدعم السريع؛ ذلك رغم أن تلك الحركات تختلف هيكليا وتاريخيا من الدعم السريع، وهذا شأن آخر). لنتذكر أن التاريخ الحديث يرينا كيف قامت حركات مسلحة أصغر بغلبة جيوش نظامية أكبر وفق قواعد حرب العصابات، كما قامت بالضغط على الجيوش النظامية حتى ساقتها للمفاوضات (مثل ما قامت به الحركة الشعبية في اتفاق السلام الشامل). لكن، ربما يكون هنالك دور لعامل مهم، وهو أن قوات الدعم السريع لا تنافح من أجل قضية سياسية-تاريخية تعطيها دفعا ذاتيا وأسباب نضال متجاوزة للمصالح الضيقة (لكن ذلك لا يدعونا للاستهانة بقدرتها على خلق حالة واسعة من الارتباك والضرر في البلاد، فحتى لو تم التخلص من الجسم المسمى الدعم السريع فإن الكثير من سلاحه ومسلّحيه سيبقون لأمد غير قصير ليحدثوا مشاكل غير قليلة). عموما يمكن كذلك قراءة ما كتبه ماوتسي تونغ وتشي قيفارا حول حرب العصابات (Guerrilla warfare) وهما خبراء فيها، ونجحا قبل ذلك في هزيمة جيوش نظامية، (كما حصل ذلك بجوارنا في إثيوبيا ويوغندا أيضا).
لذلك فسيناريو أن تتمدد آثار هذه الحرب في الزمان والجغرافيا لتحيل معظم أرجاء البلاد إلى مناطق كوارث ورعب – أي إلى الوضع الذي عانت منه بعض جهات السودان لسنوات، بل لعقود، بينما الجهات الأخرى كانت غافلة عن هذا الواقع بحيث لم تستطع شعوبها تخيّله بما يكفي من سعة الخيال – ليس سيناريو مستبعدا، للأسف (رغم أنه ليس حتميا). وحتى لو استطاع الجيش أن يحسم خصمه حسما تاما، فلنا أن نتخيّل ماذا يعني ذلك لقوى الثورة وممثليها في الشعب بعض أن تخلو الأجواء لقيادة القوات المسلحة الذين نعرفهم جيدا وبعد أن ينتشوا بنصرٍ عسكري جبار كهذا…. في مجمل الأحوال، من السذاجة توقّع أن آثار هذه الحرب لن تبقى معنا لعدة سنوات على الأقل.
على المستوى العام، يتمنى المرء أن يقول إنه يثق في القوات المسلحة التي تنتمي لدولته، ويقول إنه يتعاطف مع جميع الجنود الذين يخوضون غمار الحرب باسم حماية بقية الشعب (فهم أيضا، أي الجنود، جزء من الشعب)؛ هذا ما يتمناه المرء. لكن مع تعاقب وتراكم ميراث الشعب السوداني المرير مع المؤسسة العسكرية عبر العصور، فإن هذه للأسف رفاهية لا نملكها حاليا. كثيرا مثلا ما نسمع عن وجود “شرفاء الجيش”، من الضباط وضباط الصف، الذين تتناقل الأخبار عن أنهم غير مسؤولين عن قرارات وأفعال قيادات الجيش من كبار الضباط، وأنهم سينقذوننا يوما ما من قبضة هؤلاء، وبدون أن نجادل في وجود هؤلاء الشرفاء وفي مدى شرفهم فعلى العموم نحن لم نستفد منهم شيئا حتى الآن وعلى مدى سنوات بل عقود من تحكم المتسلطين القساة بالقوات النظامية للدولة، فوجودهم ما زال افتراضيا فحسب، بل كل ما جرّبناه في الواقع هو أن جملة الجنود والضباط ينفذون أوامر قياداتهم ويوجهون بنادقهم نحو صدور الجماهير في شتى أنحاء البلاد ثم نسمع بأن لا حيلة لهم. هذا حديث لا قيمة له، فإن كانوا غير قادرين على البروز فعلا ولجم مؤسستهم عن البطش بالأبرياء، وعلى جعل مؤسستهم وطنية وشريفة بما يكفي، فلا يستحقون من الشعب أي تذكّر أو عذر، بل الأصح أنهم إما تحملوا المسؤولية مع قادتهم أو تبرأوا من الانتساب لتلك المؤسسة. أما إن ظهروا فعلا، وأثبتوا وجودهم وصدقهم بالفعل لا بالقول، فلكل حادث حديث. (وهنالك كتابات سابقة، سودانية وغير سودانية، حول أهمية المراجعة الهيكلية لقواعد الطاعة ومشاركة المسؤولية عن تنفيذ القرارات في القوات المسلحة، فهذه إحدى الجوانب ذات الإشكال العميق في بنيان الجيوش الحديثة).
(8)
مع كل ذلك، نكرر: ما ينبغي أن يشغلنا الآن، كأولوية، هو (١) موقف السند الإنساني والتضامن العملي مع شعبنا المتضرر من سخائم الطرفين المتحاربين، و(٢) الاستمرار في جهود تقوية واستحصاد الثورة الشعبية، فكرا وتنظيما. الانشغال الأول فرضته تراكمات الواقع والتاريخ، والانشغال الثاني هو الخط الثوري الأصيل، الذي تلاطمته أمواج كثيرة في مسيرته، لكنه بقي صابرا، متناميا، متعلّما من الدروس ومتسلحا بالشكيمة.
عملية إعادة بناء الدولة جزء من مشروع استرداد وتغليب كرامة الإنسان في السودان، وهذا المشروع يتضمن أيضا التنمية، والتحرر، والتحول الاجتماعي نحو العدالة ونحو تفجير طاقات الابتكار والحضارة والجمال، والتضامن الإنساني الواسع. هذا مشروع فيه جوانب فكرية، فنية، علمية، كبيرة، وفيه جوانب شعورية عميقة ونبيلة، وفيه حاجة لتخطيط وتنفيذ كبير ودؤوب ومتفاني. مثل هذا المشروع لا يقوم به الذين يتبدلون مع التبدلات السريعة للمصالح والمخاطر، كما لا ينبغي أن يعتمد في مجمله على كوادر ضعيفة الخيال، مستعجلة للنتائج، أو سريعة التخندق والاختزال للأوضاع في حالات الكوارث. هذا مشروع يحتاج لعقول غير متهافتة، ولسواعد مستقلة…. وللحديث شجون.
تعليقات واستطرادات
(منشور بتاريخ 29 أبريل 2023)
الحروب أحيانا تقود لنهضة كبيرة بعدها، وإعادة إعمار تفوق ما كان قبلها. بل إن هنالك مسارات بحوث اقتصادية تتحدث عن الفوائد الاقتصادية طويلة الأمد بالنسبة للبلدان المحتربة، وهنالك عبارة تناولتها بعض كتب التاريخ: “الحرب صحة الدولة”.
War is the health of the state
لكن ذلك ليس في جميع الأحوال. هذه العبارة ناقصة إذا تناولناها بهذه الصورة.
في 19 نوفمبر 2020، نشرنا مقالا بعنوان “الحرب والصناعة، وصحة الدولة: ما التنمية، وما السلام؟” بصحيفة الحداثة (اليومية). في ذلك المقال تحدثنا عن النقطة أعلاه، بأمثلة متعددة، وبتوضيحات اقتصاد-سياسية، ثم قلنا إن “هنالك ما يكفي من القرائن التاريخية لنقول إن خلاصة “الحرب صحة الدولة” خلاصة مسنودة بالأدلة. لكن، ما الذي يجعل الحرب كذلك لبعض الدول ثم هي وبالٌ وشرٌّ على دول أخرى؟”…. وفي بقية المقال تحدثنا عن أن هذه الخلاصة مقرونة دوما بعوامل تاريخية متعددة وليست صحيحة كقاعدة عامة.
ألمانيا واليابان، مثلا، صعدتا تنمويا بصورة ملحوظة ومبهرة بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، رغم أن الاثنتين خسرتا الحرب خسارة داوية. هذه من القصص المشهورة حول نهوض الدول بعد الحروب في العصور الحالية. عبر مثل هذه القصة يتفاءل البعض أحيانا بفترات إعادة الإعمار بعد نهاية الحرب. لكن قصة ألمانيا واليابان لم تبدأ مع الحرب، بل بدأت قبل ذلك. الدولتان بدأتا مرحلة تنمية صناعية قبل الحرب، بوتيرة غير سريعة لكن ملموسة، وزادت تلك الوتيرة أثناء الحرب (عبر التصنيع الحربي ولوجستيات الإمداد العسكري، والتطوير البحثي المتعلق بتكنولوجيا الحرب) ثم استعادتا ذلك الخط بعد أن وضعت الحرب أوزارها وُمنيتا الاثنين بهزيمة قوية جعلت الشعبين يعيدا عملية التقييم الذاتي والإعمار الذاتي بمراجعات داخلية كبيرة، لكن عملية إعادة الإعمار لم تبدأ من الصفر، في حالة ألمانيا واليابان، لأنها استندت على إرث الدولة السابق للحرب، إذ أن ذاكرة المؤسسات والنظم لم تمحها الحرب إنما محت ظاهر البنية التحتية، وحصدت الكثير من البشر لكنها لم تحصد ذاكرة الشعب وتراكم المهارات والمعارف محليا. في التفكير النظمي هذا الشيء مفهوم، فمثلا لو اندلع حريق في مصنع إلكترونيات، بخسائر كبيرة ومقوّضة، فإن ذلك المصنع يمكن إعادة بنائه ليعود كما كان سابقا باعتبار أن خارطته ما زالت محفوظة وتصميمه الفني محفوظ، وهيكله الإداري كذلك، ومع بقاء بعض السواعد القديمة وإضافة بعض الجديدة. بل ربما تكون هذه فرصة لتطوير بناء المصنع ليبدأ من نقطة أفضل من التي انتهى منها. هنالك تكلفة وهنالك زمن، لهذه العملية، لكنها ممكنة، وقد تكون أسرع من عملية البناء الأولى.
الولايات المتحدة كذلك، اغتنت كثيرا من الحرب العالمية، ويعود ذلك لأنها كانت بعيدة بصورة عامة من التهديدات الكبيرة والأضرار الكبيرة التي أصابت حلفاءها وأعداءها الأوروبيين. تمكنت مصانع الولايات المتحدة من الاشتغال لصالح تغذية ماكينة الحرب ولوجستياتها، ومع انضمام الجيش الامريكي للحرب كانت هنالك سلسلة قيمة اقتصادية وسلسلة إمداد كبيرتان غذتا عملية الحرب وأنتجتا نموا اقتصاديا أمريكيا، لدرجة أن الولايات المتحدة خرجت بعد الحرب ثريّة بما فيه الكفاية ليستدين منها الحلفاء وغير الحلفاء استدانات كبيرة، فاستفادت كذلك من عمليات إعادة الإعمار في تلك الدول بسبب الاتصال مع الاقتصاد الأمريكي. بعض الدراسات التاريخية للاقتصاد السياسي تقول إن الحرب العالمية الثانية هي التي عالجت الكساد الكبير بالنسبة للولايات المتحدة. صحيح أن أمريكا وصلتها أضرار حربية كذلك، وأصيبت بعض مناطقها، لكنها ليست أضرارا كبيرة مقارنة بما جرى من دمار في أوروبا وفي اليابان، بل وحتى في الاتحاد السوفيتي. من الكتب التي توضح المكاسب التي اكتسبتها الدولة الأمريكية، واقتصادها الرأسمالي، من الحرب التي شاركت فيها خارج حدودها، كتاب “التاريخ الشعبي للولايات المتحدة” لهوارد زن.
عندما نقرأ القصة كاملة، نفهم أن الحروب الأهلية، العبثية، ليست شبيهة بهذه القصص، كما أن ما يحصل بعد الحروب عادة لا يشكّل قطيعة تاريخية كاملة مع التاريخ المحلي السابق للحرب، فما لم يبدأ قبل الحرب لن يظهر فجأة بعد الحرب، وكذلك فما كان متفشيا قبل الحرب لن يختفي فجأة مع نهايتها. محاولة تصوير ما يحصل في السودان الآن، بعبثيّته هذه، ونوعية الحرب والعلاقات والتشابكات التي قادت لها، وطبيعة القيادات التي قامت هذه الحرب تحت إمرتها، وأوضاع هشاشة الدولة ثم تفككها الذي كان سائدا قبل الحرب، مقابل الخضم الشعبي الثائر الذي كان رافضا لكل تلك الأوضاع (ولكنه بالذات الطرف الذي لا يملك سلاحا في هذه الحرب)، كل هذا لا يسمح لنا بأن نعقد مقارنة سريعة وعامة مع قصص الحروب التي لحقتها تنمية كبيرة من حول العالم.
نحن ما زلنا من المستثمرين في الأمل الكبير في مستقبل السودان الكبير، بسبب طاقات الشعوب الكامنة، وبسبب خواص الحراك الثوري الذي بدأ واستمر في أسوأ الأوضاع وما زال نابضا وناميا. هذا أملٌ مختلف، كما أنه لا يتعامل مع الواقع الماثل بسطحية الخيارات المختزلة، وإنما يضع إيمانه في كفة القوى التاريخية الصحيحة، ذات الرصيد الأِشرف، في الحاضر وفي الماضي. ومع إيماننا هذا، فقد قلنا منذ فبراير 2019، في كتابات منشورة: “قد تمضي الأمور إلى الأسوأ قبل أن تمضي إلى الأحسن”
”Things may have to get worse before they get better”
فهنالك الكثير من العمل ينتظرنا جميعا، رغم كل شيء، وهنالك فاتورة استحقاق للتنمية والتحرر، ظل يدفعها الشعب السوداني منذ سنوات، بل منذ عقود، ولم يدفعها الساسة ولا أصحاب السلطة التاريخية والامتيازات العالية، فالاستحقاق إذن ملك من دفع الفاتورة.
المواقف التي نقفها اليوم، مع تطورات الأحداث وتبدلات مواقف الجهات المتباينة – وتبدل المواقف لا يعني بالضرورة تبدل المصالح – مواقف متصلة بتفكير ومراجعات وانخراطات قديمة، وبذاكرة ترصد وتتابع ولا تتناسى ما لا يحسن نسيانه. وفي كل هذا نتذكر الوعد الجميل لهذا الشعب، والوعيد لمن كادوا له وآذوه مرارا، فــ”لا تحسبُن الكيد لهذه الأمة مأمون العواقب….فلتشهدُن يومـًا تجف لبهتة سؤاله أسلات الألسن؛ يوما يُرجف كل قلب، ويُرعد كل فريصة.” (من منشور للحزب الجمهوري، 1946).
هذه قصة بطلها الشعب، وحده، لا من رفع البنادق في وجهه، واسترخص حياته وكرامته، مرارا، أيّا كان الزي الذي يرتديه.
عن العصيان المدني
(منشور بتاريخ 4 يونيو 2019)
يُعَرّف العصيان المدني عموما بأنه رفض الامتثال لقوانين وسلطة رسمية بناء على أرضية أخلاقية وسياسية تُعتَبر أكبر وأولى من طاعة القانون والسلطة الرسمية، مهما كلّفت النتائج. ولذلك فالعصيان المدني لا يكون عادة نتيجة اختلاف في سياسات ما مع السلطة، في بيئة سياسية معقولة جملةً، إنما نتيجة اختلاف على مستويات أكثر جذرية.
والعصيان المدني الشامل يتضمن الإضرابات العامة، السياسية، واسعة النطاق، ويوجّهها، ضمن ما يوجّه من أنشطة أخرى كثيرة، تتضمن المواكب الاحتجاجية، والاعتصامات، واحتلال الميادين والمرافق العامة، وعموم الأنشطة والترتيبات التي تؤدي إلى عجز السلطات الرسمية على إدارة دولاب الدولة لفقدانها الموارد الشرعية وغياب الاعتراف والامتثال عند الأغلبية الغالبة من المواطنين.
أنشطة العصيان المدني تخلق فراغا في سلطة قانون الدولة ومتنفّذيها، وتستبدله بسلطة أو سلطات أخرى بديلة، ذات شرعية مدنية وأخلاقية وإن لم تكن رسمية؛ وبخلقها لذلك الفراغ من جهة، وخلقها لسلطة بديلة من جهة أخرى، تُحدِث حزمة أنشطة العصيان المدني تغيّرا كبيرا في سير الحياة العامة في الدولة، وتعيد توزيع مراكز القوى، بحيث يظهر عجز السلطات الرسمية التي تجد نفسها متنفّذة بدون منافذ، مثل البندقية بدون ذخيرة أو القطار بدون طاقم تشغيل ووقود.
مثلا، شاهدنا في يومي الإضراب السياسي العام، ٢٨ و٢٩ مايو، كيف أن التوقف النسبي لحركة المصارف، وحركة النقل العام (أرضا وجوّا)، وتلويحات انقطاع الكهرباء عن مناطق حيوية (فما بالك ببقية قائمة الخدمات العامة) أثارت جزع العساكر والجنجويد وممالئيهم، لأنه ذلك يعطّل دولاب الدولة كثيرا فيفقدون معها قسطا كبيرا من قوّتهم المستمدة أصلا من دولاب الدولة ومواردها والغطاء الشرعي الذي بدونه لا يمثّلون شيئا.
وحين يقوم العصيان المدني الشامل، كما ذكرنا، بخلق سلطة مدنية موازية لسلطة الدولة وتأخذ مشروعيتها، كما ذكرنا، بالتفاف الأغلبية حولها، وقدرتها على تسيير الأحداث وتنسيق جهود المواطنين، داخليا وخارجيا، بصورة أكثر فاعلية من السلطات الرسمية، يتضح أكثر، داخليا وخارجيا، أن الشعب هو الذي يعطي السلطة وهو الذي ينزعها في الواقع.
وبهذه الطريقة، يقود العصيان المدني عموما إلى سوق الأوضاع في الدولة للحظة ذروة، أو لحظات ذروة، تتيح لقوى الشعب أن تستغلها لسحب السلطة الرسمية من الأقلية المرفوضة. سيناريوهات لحظات الذروة هذه كثيرة، وإن كنّا لا نستطيع التنبؤ بكل تفاصيلها استباقا إلا أننا نعرف أن العصيان المدني هو الذي يسبقها ويقود لها.
ومن باب الشفافية مع الشعب، فيما بيننا، نقر أن نتائج العصيان المدني ليست معروفة أو مضمونة مسبقا، لكن ما يمكن تأكيده أن العصيان هو المسار الوحيد السليم حاليا في سيرة الثورة الشعبية السودانية. وكما لم نكن متأكدين مسبقا من نتائج اعتصام القيادة العامة إلا أنه كان تكملة التراكم الثوري الذي أدّى لسقوط البشير؛ وكما لم نكن متأكدين من نتائج يومَي الإضراب السياسي إلا أنه أثار جزعا واضحا لدى المجلس الانقلابي وممالئيه.
ما دامت هذه ثورة شعبية سلمية مدنية، فالعصيان المدني الشامل هو معقل ترسانتها الكبرى، وهو كذلك، غالبا، خط دفاعها الأخير.
(منشور بتاريخ 31 ديسمبر 2021)
(منشور بتاريخ 4 نوفمبر 2021)
- ميثاق شرف جندي: مثل قَسَم أبقراط لدى الأطباء، يقسم الجندي حامل السلاح أن لا يُستعمل سلاح في وجه مواطنين عُزّل، حتى لو أمِر بذلك من قبل زعيمه العسكري، والمسؤولية عن هذا القَسَم مسؤولية مباشرة لا وكالة فيها (وبذلك ينكسر التقليد العسكري البائس الذي يفرّق المسؤولية الأخلاقية والقانونية للجريمة على مستويات متنوعة وتفاصيل لا تغني من الواقع شيئا).
- مادة دستورية تمنع تدخل القوات المسلحة في ترجيح كفة أي صراع سياسي مدني؛ فقط حماية المواطنين والمرافق العامة من أي عدوان مباشر نتيجة صراع سياسي أو طوارئ استثنائية (مع تعريف تلك الطوارئ درءًا للثغرات القانونية)، مع عدم الإخلال بالقاعدة 1.
- أي منسوب عسكري للقوات المسلحة (ضابط أو ضابط صف)، إذا حاز على أي منصب دستوري (في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية) يفقد تلقائيا عضويته في القوات المسلحة وصلاحياته عبرها، ولا يمكن استعادة تلك العضوية قبل الخروج من المنصب الدستوري.
- تثبيت الحق الدستوري المنصوص للجماهير في المقاومة المفتوحة لأي سلطة تخالف القواعد 1، 2، 3.
تعليقات واستطرادات
(منشور بتاريخ 20 نوفمبر 2021)
حول تغيير بنية الجنيدية في البلد
(منشور بتاريخ 17 نوفمبر 2019)
لست من دعاة العنف كحل لمشاكل العصر الحديث، لأنه لا يحل، وفي أفضل حالاته قد ينجح في استبدال مشكلة بأخرى، أو يقود الأطراف المتنازعة للاقتناع بضرورة تجاوزه بعد تجريبه.
عن الميثاق الثوري لسلطة الشعب
(منشور بتاريخ 6 أبريل 2022)
عمل محترم، وغطى مسائل لم يغطّها من قبل ميثاق سياسي سوداني واسع التوافق بهذا المستوى. والشيء المتميّز فيه حقا الطريقة التي تمّ عبرها بناؤه ودمجه وتعديله، إذ “تم بناءه بعصف ذهني جماعي قاعدي وحوارات بأذهان مفتوحة لحوالي 15 ولاية، وناقشته بقية الولايات.” احترام كبير.
مناطق التحفظ على نقاط الميثاق محفوظة، وهي مناطق مهمة في نظرنا (خاصة في الجانب الهيكلي والجانب الحوكمي، مثل التقسيم المختلط والمترهّل حقيقة للوزارات والمفوضيات – أسماء كثيرة وتجميعات غير مبررة – ومثل التفريق بين مهام مترابطة في أصلها كالانتخابات وصناعة الدستور، ومثل نسيان مهام أساسية ومحورية كمفوضية التنمية المستدامة، مع وجود مفوضيات لا داعي لها أو مكررة المهام، ومثل غياب بعض النقاط المهمة المتعلقة بمقاربة العدالة الانتقالية وبالتعامل مع ظاهرة دولة الميليشيات، ذلك الغياب الذي يفتح الباب أمام تكهّنات مقلقة أحيانا، إلخ)، فمجمل هذه المناطق عرضة للمزيد من النقاش والتكميل بالتداول والتجربة.. لكن سأتناول هنا بعض الإيجابيات المهمة:
– محاولة وضع تصوّر مفهوم وملموس لعملية تصعيد السلطة في الدولة من القواعد (المحليات والنقابات – أو مكان السكن ومكان العمل) محاولة مقدّرة، لأنه وفق ذلك يمكن الأخذ والرد بخصوصها، وكذلك فيها تحفيز لمن ينتقدون التصوّر أن يقدموا تصوّرهم البديل، فكذلك نكون انتقلنا من مرحلة التجريد لأولى مراحل التجسيد.
– رغم بعض النقد الذي جاء للميثاق بخصوص لغته المتعلقة بطبيعة الدولة السودانية، إلا أني أرى أن لغته متقدمة عموما وفيها تشريح محترم لتلك المسألة، كما أنه لم ينس تسمية العلاقات الرأسمالية العالمية بالاسم (والرأسمالية علاقات سلطة وثروة بطبيعة الحال) كمصدر من مصادر المشكلة الموروثة من الحكم الاستعماري وطريقة هندسته للدولة واستعماله للموانع الهيكلية (“العرق”، الدين، الثقافة والنوع). إذا أردنا أن “نحكّها” مع الميثاق فسنلبث طويلا، لأنه ليس ورقة في دراسات ما بعد الاستعمار أو دراسات النظرية السياسية للاستعمار الحديث، وبالتالي فالميثاق غالبا يكون ناقصا بعض التفاصيل وكثير من التوضيحات في محتواه في هذا المضمار. لكن، بصورة عامة، يمكنني أن أقول إني رأيت أملكار كابرال بين ثنايا الميثاق؛ خاصة حديث كابرال عن دور الثقافة في عملية التحرر الوطني وحديثه عن عملية التحرر الوطني كعملية استعادة للتاريخ المحلي برغم تناقضاته من أجل أن تتفاعل وتتطور تلك التناقضات وفق شروطها المحلية وليس وفق هياكل وشروط مصبوبة صبّا عنيفا – استعماريا – على الواقع المحلي.
– أيضا رأيت والتر رودني بين ثنايا الميثاق، خاصة في حديث الميثاق عن أهمية “استعادة السيادة الوطنية بشكل كامل” كـ”أول خطوة في طريق التحول الديمقراطية والتنمية العادلة”…. في ذلك الصدد “قال هُوِي نيوتن، أحد مؤسسي حزب الفهود السود، في أمريكا الستينات والسبعينات، إن “السلطة هي القدرة على تعريف الظواهر، وجعلها تسير بمقتضى ما يُستحَب.” وهذا التعريف ليس فقط تعريفا ممتازا للسلطة عموما، في أي إطار عام يرتاده الناس، إنما هو أيضا تعريف يساعدنا في استبانة أولئك الذين يفهمون السلطة فهما شائها، ثم هم بسبيل ذلك الفهم الشائه إما مارسوها بصورة ناقصة أو سعوا لها بالسبل الناقصة في إطار الدولة. كذلك، فرغم أن والتر رودني، المؤرخ والمفكّر الافروعمومي من غويانا، كان ماركسيّا قُحّا، إلا أنه ومنذ مقدّمة كتابه “كيف قوّضت أوروبا نماء افريقيا”، وبعد بذله تلخيصا ممتازا لمنهج المادية التاريخية باعتباره منهج الكتاب، قال إن مسألة التنمية في افريقيا تدور حول محور السلطة، لا الاقتصاد في معناه المجرّد. رودني توصّل لهذه الخلاصة لأنه قرأ التاريخ جيدا.” [من كتاب “حوكمة التنمية”، الفصل السابع].
والجانب الإيجابي العام، في مجمل الميثاق، أنه وثيقة جيّدة الاستعمال في “فرز الكيمان” و”تمايز الصفوف”، ففيه نقاط أساسية لا تستحمل تفاسير متعددة حول وجهة العمل الثوري والفترة الانتقالية، وبالتالي فهنالك جهات متعددة، تميل لتذويب المواقف وتمويه اللغة وتوسيع القوالب لتشمل الجميع في قاسم مشترك هلامي يقول الكثير من اللا شيء، ستجد صعوبة في الالتفاف حول الميثاق أو دعمه.. هذه محمدة كبيرة، فالتحرّك للأمام يتطلب تمايز الصفوف والتخفف من رفقة أناس يتحركون في اتجاهات متباينة جدا، كما ذكرنا من قبل مرارا.
الريادة الثورية، بين الهمّة والخمول
(منشور بتاريخ 29 يوليو 2019)
(1)
لدى السادة الصوفية قائمة إرشادات سلوكية عامة، رصينة، خصوصا بالنسبة للسالكين في طريق الحق وبحاجة للإرشاد في بدايات ذلك الطريق الوعر. إحدى تلك الإرشادات ما يتعلّق بتقوية الإرادة والتخلي عنها في نفس الوقت، أو الميزان بين الهمّة والخمول. المقصود بالهمّة أن يجاهد السالك في سُبُل العبادة والسلوك، ليحمل نفسه على التزام العبادات ومجاهدة نوازع النفس؛ وذلك أمر يحتاج لإرادة قويّة وجادة في مضمارها وهدفها. والمقصود بالخمول خمول الذِكر، أي تأخير النفس وتقديم الآخرين، وكف الأذى عن الناس وتحمّل أذاهم، والاقتصاص للآخرين من النفس إذا اقتضى الأمر، ثم محاولة إيصال الخير لهم قدر المستطاع؛ وذلك أمر يحتاج للتخلي عن الإرادة (كإرادة الظهور والتمتّع بالتمجيد وما لذلك من امتيازات وسط الناس). من ناحية، يحتاج السالك لأن يشحذ همّته، ومن ناحية يحتاج للجم طموحاته، سواء أكان يشعر في قرارة نفسه أنها مشروعة أم غير مشروعة. هذه “الرياضة” الروحية من أصعب المسالك على النفوس البشرية.
(2)
إذا استعرنا العبرة أعلاه من أهل الأدب – والتصوّف يُعرَف في التراث بالأدب كذلك – لنستعملها في الميادين الثورية، يمكن القول إن الريادة الثورية تتطلب ميزانا بين الهمة والخمول كذلك. (والريادة الثورية عبارة نظنها أدق، في هذا المقام، من “القيادة الثورية”، لأن القيادة مسألة تتعلق شروطها بمواصفات الناس كما تتعلق بالظروف التي تستدعي ملء فراغ القيادة وهذه لا تعتمد على مواصفات الناس وإنما السياق الموضوعي. بالتالي يمكن أن نقول إن القيادات الثورية ترشحّها الظروف، ومن الجيّد أن يحصل ذلك الترشيح من بين الريادات الثورية وليس من خارجها، لأن القيادات التي ترشّحها الظروف ثم لا تستوفي شروط الريادة الثورية تؤثر في الحراك الثوري سلبيّا). أليس من الجيّد أن يتميّز أهل الريادة الثورية بالهمّة تجاه شروط المجهود الميداني والتنظيمي والفكري، مع الخمول تجاه مغريات الظهور المكثّف في المحافل التمثيلية وفي طقوس توزيع المناصب والأوسمة والألقاب، وما يتبعها من امتيازات؟
(3)
كثير من الثوّار، الثوريين، ومفكري الثورات، تحدّثوا عن أهمية القيم الخاصة التي يحملها الفرد في خضم الثورة. أي القيم التي تترك أثرها في معالم شخصية الثورية والثوري ومواقفهما التأسيسية. يقول جيفارا مثلا إن “الحب” من أهم شروط الثوري الحقيقي، أي حب الخير والجمال الموجود في الناس وفي طموحاتهم المشروعة. يقول كابرال كذلك إن نضال التحرر يشتمل دائما على حربٍ داخلية، لا تُحسَم الحرب الخارجية لصالح الحق بدونها. أفهم ما يعنيه كابرال بهذه الحرب الداخلية على مستويين: التنظيمي الداخلي (والحذر من الانتكاسات والخيانات الداخلية) والأخلاقي الداخلي (وكابرال في ذلك كان واضحا أيضا إذ وصف عملية التحرر الوطني بأنها عملية أخلاقية في المقام الأول)، وفي ذلك المستوى الأخلاقي الداخلي هنالك صدى صوفي كبير (على الأقل بالنسبة لي)–هنالك حربٍ مع نفوسنا ومطامعها، وقدرتها على الانزلاق ناحية تمجيد الذات وتبرئة الذات من كلَ ما يمكن أن نصف به أعداءنا، ثم ناحية تشوّش بوصلة الحق والهدف لدينا، ثم الميل للربط التلقائي بين مكاسب الثورة ومكاسبنا الشخصية (أو العكس)، الرمزية والملموسة…. ويمضي الانزلاق، حتى ننظر يوما للمرآة فنكاد لا نعرف من نحن، أو نكاد لا نعرف من حلفاء الأمس وأصدقاء الأمس، حلفاء القضية…. الذين ربما أحسنوا بنا الظن أكثر مما ينبغي.
وعند أهل الأدب، اختصروا المسألة في عبارات، منها الحديث القدسي “يا عيسى عظ نفسك، فإن اتعظت فعظ الناس، وإلا فاستح منّي”، ومنها مقولة “ما غادر من الجهل شيئا من ترك يقين ما عنده إلى ظن ما عند الناس.”
(4)
مانقاليسو سوبوكْوِي، في بدايات ظهور نجمه في حركة مناهضة الأبارتيد، بأزانيا (جنوب افريقيا) كان يجذب الكثير من المهتمين لخطاباته العامة، ويثير قلق عناصر النظام الحاكم بصورة كبيرة. من الأشياء التي ميّزت سوبوكْوي في ذلك الزمن أنه كان يطالب الجماهير بصورة مستمرة بمراقبة قياداتها بقدر ما تدعمها، ومحاسبتها حسابا عسيرا في حالات الميل عن المبادئ التي فوّضتها الجماهير على أساسها. إحدى عباراته الشهيرة (مترجمة بالمعنى): راقبوا تحركاتنا، حيثما نزعم أننا نمثّلكم ونتقدم مواكبكم، فإذا شاهدتم فينا أي بوادر “تحلي بالمعقولية” أو “سعة الأفق”، من العيار الدبلوماسي، وإذا سمعتمونا نتحدث على منوال “الخبرة العملية ساعدتنا على الاعتدال في رؤانا”، فتبرؤوا منّا في التو واسحبوا منّا الثقة.” سوبوكوي معروف، لمن يقرأ تفاصيل تاريخ النضال ضد الأبارتيد (لا النسخة التجارية)، أنه كان أخطر عدو واجهه نظام الأبارتيد، باعتراف أهل النظام نفسه.
——–
“لَوْلا المَشَقّةُ سَادَ النّاسُ كُلُّهُمُ؛ الجُودُ يُفْقِرُ وَالإقدامُ قَتّالُ
وَإنّمَا يَبْلُغُ الإنْسانُ طَاقَتَهُ، مَا كُلّ ماشِيَةٍ بالرّحْلِ شِمْلالُ
إنّا لَفي زَمَنٍ تَرْكُ القَبيحِ بهِ من أكثرِ النّاسِ إحْسانٌ وَإجْمالُ”
فاللهم امنح قياداتنا، ورياداتنا، الهمّة والخمول…
تعليقات واستطرادات
(منشور بتاريخ 30 يوليو 2023)
{إِنَّ اللَّـهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَومٍ حَتّى يُغَيِّروا ما بِأَنفُسِهِم}
والعبرة في هذه الآية في فهمها، وفي الأفق التي تحفّزنا على النظر نحوه. فهل ينتظر الإله، وناموس كونه، الناس حتى يبادروا ثم يجزيهم بذلك، وبغير ذلك لا يحصل تغيير؟
إذا كان التغيير في أوضاع الناس – ((ما بقومٍ)) – فإن أي تغيير في أوضاعهم يمكن أن نسميه، لمصلحة الخطاب، تغييرا اجتماعيا، وهو يشتمل على الديناميكات الاجتماعية المتفاوتة، من السياسة للاقتصاد للثقافة للسلام للتكنولوجيا، للإدارة، إلخ (حسب تصنيفات عصرنا هذا). القاعدة التاريخية أن التغييرات الاجتماعية تقوم بها المجموعات، ولكنها تقوم بها وفق تجاوبها وردود فعلها مع محفزات عدة، داخلية وخارجية، من صنع بشر أم من معطيات البيئة.
فالناس يتغيّرون، لأن الأحوال تتغير. ليست هنالك مشيئة في جعل الأشياء ثابتة، فهذا لا يكون. لكن هنالك مستوى من القرار في كيفية تجاوبنا وتعلمنا مع تغيرات محيطنا ثم كيف نتجاوز المشاكل التي يقدمها أمامنا الواقع ونبني على النجاحات والاكتشافات التي راكمناها.
في عملية التغيير الاجتماعي، وبالذات بالنسبة للمنخرطين في عملية التغيير الاجتماعي، فإن هنالك إيمان مسبق وقوي بأن الاستمرار في التعلم والعمل يولد حلولا أفضل للمشاكل ومخارج أفضل للأزمات. هي عملية ديلكتلكية، ليست تلقائية أو سهلة التوقع أو تستبعد أهمية القرار البشري والعمل البشري. لكن هنالك إيمان يحرّكنا بأننا مع الاستمرار في بناء الخبرة والاستفادة من الدروس سنجد الحل الذي يناسبنا، يوما ما، أو نستمر في التعلم حتى نحقق ذلك. هذا الإيمان منبعه العمل والاستمرار في العمل، بالنسبة للمنخرطين في عملية التغيير الاجتماعي، كما منبعه قراءة الواقع وسنة التغير الديناميكي المستمر فيه. أما غير المنخرطين في تلك العملية، والذين ينظرون لها كظاهرة مجردة، فلهم أن يختاروا مدى إيمانهم بقدرة البشر على إحداث التغيير المطلوب في المستقبل.
من أجل التقريب، نتنزّل من الحديث النظري العام إلى الحديث عن واقع السودان: بعضنا، من المنخرطين في التغيير الاجتماعي، جدير بهم أن يكون لديهم إيمان بأن هنالك حل لهذه المشكلة، أي أنها ليست مشكلة بدون حل، وما دام لهذه المشكلة حل (أو حلول) فإن تراكمات تجربتنا، وتعلّمنا، كلما زادت كلما ارتفعت كذلك فرصتنا في الوصول للحل. هذا ليس إيمانا من فراغ، بل من تعاطي وتفاعل مع الواقع الموضوعي ومع التجارب التاريخية وخلاصات الذكاء البشري. هذا لا يعني أن النهايات مضمونة (أي أننا لا بد أن نجد الحل في النهاية حتى لو لم نفعل أي شيء) بل هو التصوّر الديلكتيكي الذي يقود عملية التعلم المستمرة وتراكم الخبرات والجهود الايجابية–هذا التصور ملتصق بالإيمان وبالأمل، بطبيعته، ويقول لنا إن الأمور عندما تسوء ففرص تحسّنها تزيد، عند اعتبار العوامل المتداخلة، ليس كحصيلة جاهزة وإنما باعتبار استمرار التعلم واستمرار الجهود في التغيير، وباعتبار أن هنالك مستوى من الذكاء لا يقل فيه السودانيون عن بقية الشعوب التي يبدو أنها مضت خطوات أمامنا حتى الآن.
فعندما نقول، مثلا، “ستمضي الأمور نحو الأسوأ قبل أن تمضي نحو الأفضل”، لا نقدّم نبوءة أو نقول إن الخلاصة القادمة تلقائية وكسولة، بل هي خلاصة ديلكتيكية، تصطحب دوما عامل تراكم الخبرة والفعل البشري الجاد نحو التغيير الاجتماعي.
وهذا التراكم قد لا تُرى نتائجه لبعض الوقت، لكن، مثلما وصفه الأستاذ محمود محمد طه، فإن المياه الذي تتجمع خلف السد قد لا يُرى أثرها من الجهة الأخرى من السد، فيكون الظن بأن الأشياء ثابتة وليس هنالك تغيير–إلى أن يبلغ تجمع تلك المياه حدا او حدودا يظهر أثرها في الناحية الأخرى. العمل والتعلم كان مستمرا ولم يقف، لكن النتائج ظهرت بعد استحصاد وزمن. كذلك فالشعب السوداني يراكم خبرة كبيرة، من كل المشاكل والتحديات التي مرت به، ومن كل الجهود والتجارب التي حصلت وتحصل في تجاوزها. عندما يبلغ تجمع المياه حده الكافي، سنغيّر ما بأنفسنا، وسنرى تغيّرات ملموسة في الآفاق…. وللحديث شجون.